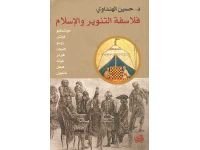فلاسفة التنوير والإسلام
فلاسفة التنوير والإسلام (2014) تأليف حسين هنداوي. نشرته دار المدى للثقافة والنشر، بيروت 2014، في 254 صفحة.
تبقى مسألة العلاقة بين عالم الإسلام والمسيحية قضية مطروحة على النقاش ليس من ناحية الأصول الثيولوجية والنصية ولا من ناحية التاريخ الدموي الذي طبع العلاقة بين العالمين، كما لا ترتبط حصرا بالتجربة العثمانية – التركية في قلب أوروبا، ولكنها أيضا في الجوار الطبيعي. فقد ظلت المسيحية تحمل في عصورها الوسيطة صورا عن الإسلام تعيدها وتكررها كل مرة، صورا تحط من قدر الإسلام ونبيه وكتابه وترى فيه نتاجا لشرق مستبد بدائي صحراوي النزعة لا علاقة له بالحضارة. ولا ريب ان النظرة للإسلام في هذه المنطقة التاريخية المظلمة من تاريخ أوروبا ظلت رهنا برؤية الكهنوت الديني والأكليروس الذي سيطر على كل مفاصل الحياة الاجتماعية في أوروبا القرون الوسيطة. فالمنافسة بين الإسلام والمسيحية ظلت كما هي الآن حربا عن الصور والقوالب الجاهزة التي غرست في الذهنية الغربية وتستحضر هذه اليوم بعد ان أصبح المسلمون جزءا من المجتمعات الغربية مهاجرين ومواطنين على حد سواء. وتلعب الصحافة الشعبية والأوساط اليمينية دورا في تدوير الصور والنمطيات عن الإسلام. ولكن التنوير الأوروبي في تعامله مع الإسلام كان له موقف مختلف. فهو إنْ ظل في معظمه مغروسا في الصورة الدينية التي تحط من قدر المسلمين والمركزية الأوروبية إلا أنه في تحرره العقلي من أسر الكنيسة وإحلاله العقل محل الوحي، ونزعته الكونية والإنسانية وإيمانه بحرية الإنسان وسيطرته على مصيره حاول البحث بطريقته عن الإسلام والخروج من أسر النمطية الشرانية التي وضعت الكنيسة الإسلام في إطارها. وهنا كما يناقش الباحث في الفلسفة الدكتور حسين هنداوي في كتابه «فلاسفة التنوير والإسلام» لم يكن مفكرو التنوير من مونتسيكيو وڤولتير وروسو إلى گوته وهيگل منقطعين عن الإسلام ولا يعرفونه بل كان الإسلام حاضرا في حياتهم وموجودا فعلا، ممثلا في تركيا في قلب جنوب أوروبا وكانت دوله تعيش ضمن إطار الثقافة المتوسطية مهيمنة عليه وصانعة لحضارته لفترة من الزمن.
ويرى هنداوي ان المنظومة الفكرية المتوفرة عن الإسلام والمشوهة ظلت تلعب دورا في تشكيل رؤية فلاسفة ومفكري التنوير عن الإسلام رغم محاولتهم التعرف عليه، وما منعهم إلا قلة منهم إلا غياب المصادر الثرية عن الإسلام، فما توفر بين أيديهم كان ترجمات قام بها قساوسة ورجال دين للقرآن وبعض الكتب التاريخية. وعليه عندما حاولوا التصدي للإسلام لم يجدوا بحوزتهم سوى ثقافتهم البسيطة عن الإسلام والكتب المشوهة التي أعدت لا لتشجيع النقد العلمي والتحاور الديني بل ولمحاولة هدم الإسلام من أساسه. ومن هنا وعندما حاول فيلسوف التنوير التعرف على الإسلام كان رهن هذه الثقافة لكن هذا لا يعني عدم مساءلته هذه الثقافة المشوهة. وكما يظهر تحليل هنداوي لم تكن ثقافة التنوير منفصلة عن ثقافة الإسلام فهي في نزعتها للتحرر من القيود الدينية استندت على كتابات الفلاسفة المسلمين مثل ابن رشد الذي عاش في الذهنية الغربية لقرون مؤثرا ومحلا للنقد، ولم يتوان الثيولوجي توما الأكويني عن التأثر ونقل ما كتبه الفيلسوف الأندلسي، فقد كان هناك اعتراف لدى فلاسفة التنوير بأهمية الحضارة الإسلامية في تشكيل وعيهم، سواء ذلك القادم من الأندلس – اسبانيا اليوم، أو ما حمله العلماء الهاربون من القسطنطينية بعد فتح العثمانيين لها من كتب وترجمات عربية لفلاسفة الإغريق. وهناك ملمح آخر يؤكده الكاتب في تحليله لمواقف التنويريين الأوروبيين من الإسلام وهو متعلق بالضرورة بالنزعة الثورية لتي يتميز بها هؤلاء المفكرون، فمعظمهم نزع في كتاباته عن رؤية بروتستانتية عانت من ظلم الكاثوليك، وهذه النزعة تميزت بالرفض للكنيسة وممثلها الحبر الأعظم. فالكاتب التنويري المتحرر من أسر الفكر الكنسي لم يعد يهمه ما كان يلقن له في المدرسة من ان صعود الإسلام ووصوله إلى قلب أوروبا ما هو إلا عقاب رباني للمسيحيين لابتعادهم عن الدين. فالبعد الإلهي أو الوحي لم يعد على هذه الدرجة من الأهمية لدى مفكري عصر التنوير. والأهم من ذلك فالنظرة المشوهة للإسلام أتاحت لمفكر التنوير الاختفاء وراءها ليقوم بنقد المسيحية كما في حالة فولتير الذي حاول في مسرحيته «محمد أو التعصب» اتخاذ الإسلام مشجبا يعلق عليه كل غضبه على المسيحية. رغم النظرة العامة من الإسلام والمسلمين – «المحمديين» أو «إسلام الترك» إلا ان مفكري التنوير لم يكونوا سواء في تعاملهم مع الإسلام، فهم وإنْ اعترفوا بقدرته ودوره في تشكيل الحضارة الكونية، بل وذهب بعضهم لتفضيله على المسيحية من ناحية قوته الروحية والعقائدية وبنائه الاجتماعي وشخصية نبيه «النبيلة» إلا انهم رفضوا الاعتراف به أو اتباعه نظرا لنزعتهم العقلانية ولأن معظهم ظل يصدر في موقفه من الإسلام عن مصادر شائهة أو لأنه وجد فيه وسيلة سهلة لنقد الدين في مجتمعه. ويقدم هنداوي المراحل التي مر بها تفكير ڤولتير عن الإسلام وكيف ان رؤيته انتقلت من ردة فعل على ممارسات دينية في مجتمعه إلى فهم وقراءة كل ما توفر له عن محمد، بحيث أصبح محمد «رفيقه». وهو بخلاف مونتسيكيو في كتابه «روح القوانين» وإنْ اعترف بالإسلام إلا انه قدمه كدين استبدادي وربط بينه وبين المناخ الذي يؤثر على أتباع كل دين. ولم تتغير نظرة مونتسيكيو للإسلام فهو «رغم نقده للمسيحية كعقيدة روحية وللكنيسة ظل في الجوهر مخلصا أشد الإخلاص لتربيته المسيحية وللأفكار التقليدية التي بلورها وصنعها الغرب المسيحي لنفسه طوال القرون الوسطى والمتمركزة حول الرفض الصريح له». ومن هنا أعاد إنتاج ثقافته حول الدين الذي ولد في الجزيرة العربية وصور حملات الفتح التي قام المسلمون بها بالهمجية، ووصم الدين بالتعصب، وصور النظام السياسي في الإسلام بأنه نظام طغيان مطلق وعبودية كاملة. ويكشف الباحث في تحليله لمواقف مونتسيكيو وغيره من الإسلام انها تصدر أحيانا عن سذاجة في التحليل واعتباطية في سوق الإتهامات. ولم تكن أفكار مونتسيكيو محلا للإجماع فقد لقي كتابه «روح القوانين» ردا حادا من أحد معاصريه وهو انكتيل دو بيرون الذي ألف «التشريع الشرقي» يرد فيه على مونتسيكيو. وكشف هنداوي أيضا عن رؤية انتقائية تنم عن موقفه الأيديولوجي والثقافي، وقام من خلال هذا بتعميمها وتشويه الحقائق حتى يؤكد رؤيته.
موقف مونتسيكيو مخالف في رؤيته وأبعاده لأفكار فولتير الذي اهتم كثيرا بالإسلام واستلهم في أعماله الأدبية الإسلام وتاريخه «محمد أو التعصب»، «صادق» و «الزير» ودون مواقفه من الإسلام في أعماله الأخرى مثل «القاموس الفلسفي». ويرى هنداوي ان فولتير هو «أهم مفكر غربي شهير في العصر الحديث سعى للبحث عن الحقيقة التاريخية لذاتها بشان الإسلام من دون هدف، فلا الإعتبار اللاهوتي ولا الموقف الأيديولوجي أو السياسي كان يهم فولتير من قريب أو بعيد». ويرى ان موقف فولتير من الإسلام تطور وكانت مسرحية «محمد أو التعصب» نقطة فاصلة حيث حاول على ما يبدو تصحيح الأخطاء التي كان قد وقع فيها، خاصة ان المسرحية نالت اهتماما وجدلا باعتبارها نقدا مبطنا للكنيسة ولهذا اندفع بشكل كبير للبحث عن هوية الإسلام الحقيقية. ويعتقد هنداوي ان فولتير رغم ما ارتكبه من أخطاء أطلق مرحلة جديدة لدراسة الإسلام «حيث أجهز بطريقته الخاصة وبشكل مباشر أو غير مباشر على تراث قرون طويلة من التقاليد الفكرية والثقافية التي تسود الغرب بلا منازع والتي تقوم على تشويه الإسلام وتاريخه وحضارته وقادته» وقام فولتير بهذه المهمة بروحية خالصة ومخلصة وأمينة لا حساب وراءها سوى البحث عن الحقيقة. ومن هنا نجد نزعة البحث عن الحقيقة والتأكد من المصادر واضحة في نظرة جان جاك روسو الذي لم يكتب الكثير عن الإسلام. وسبب هذا هو تمنعه من الاعتماد على المصادر الشعبية والرؤية السائدة في الغرب ولاعتقاده ان الأمم تسعى لتشويه صورة الأمم الاخرى المنافسة لها، وهو ما حمله على تجنب إصدار احكام قاطعة توقعه في أخطاء.
كما نرى فقد وجدت الرؤية التقليدية وجدت نهايتها عند التنويريين في كتابات المؤرخ الانكليزي إدوارد جيبون صاحب السفر الشهير «تدهور وسقوط الإمبراطورية الرومانية». ويعتبر جيبون الأب الحقيقي لعلم التاريخ في الغرب، حيث نهج في كتاباته نزعة اعتمدت على المصادر الأصلية والوثائق ومن ثم تقديم تفسير عقلاني لصيرورة التاريخ. ولهذا استخدم كل مصدر توفر له عن الشرق والناظر في حواشي كتابه يرى كيف اعتمد الكاتب على مصادر عربية أصيلة مترجمة للغات الأوروبية، كما استفاد من كتب الرحالة. وفي الفصل الذي خصصه للإسلام عزا فيه نجاح التجربة العربية إلى عوامل تتعلق بالدولتين الرومانية والفارسية وأخرى داخلية منها عبقرية النبي محمد وقوة واخلاق المسلمين وبطولتهم وتماسك الدين الإسلامي روحيا وعقائديا. وفي تحليله لمعالم الحضارة العربية الإسلامية يرى ان العرب قدموا ألمع الحضارات في تاريخ الإنسانية، وهو يؤكد هناك على العامل العربي في هذه الحضارة. ويرى جيبون ان سرعة وتوسع انتشار الإسلام كانا عاملين في تراجع تأثيره العالمي فيما بعد. وفي تقييمه لموقف جيبون من الإسلام يرى هنداوي انه كان أسيرا لمناهج عقلانية تستند على مركزية أوربية رغم تحررها من رهاب الموقف الديني، كما كان ضحية لمصادر مشوهة عن الإسلام.
يشتمل كتاب هنداوي على فصول عن التنوير الألماني وأفكار هيردر والشاعر والفيلسوف گوته صاحب الديوان الغربي-الشرقي المغرم بالإسلام والعربية. ورغم كل هذا الغرم نجد ان كتاب سيرته أغفلوا هذا الجانب الثري، ولعل أجمل ما يلخص موقف غوته من الشرق ما جاء في قصيدته «من يعرف نفسه ويعرف الآخرين، لا بد ان يعترف هنا ان الشرق والغرب لا يمكن ان يفترقا بعد الآن.. ان أمنيتي هي ان تطير نفسي كالهدهد سعيدة بين هذين العالمين».
٭ هنداوي متخصص في مجال الفلسفة الهيغلية وعمل في جامعة بواتيه بفرنسا، عمل في الصحافة ومثل عددا من المنظمات الدولية وتنقل في بلدان عدة من اليمن وهاييتي وله مؤلفات في الفلسفة والفكر السياسي العربي منها «التاريخ والدولة ما بين إبن خلدون وهيغل» و»هيغل والفلسفة الهيغلية» من بين عدة كتب.
المصادر
- إبراهيم درويش (2014-10-25). "«فلاسفة التنوير والإسلام» لحسين هنداوي: قراءة في الجذور والرؤى". صحيفة القدس العربي.