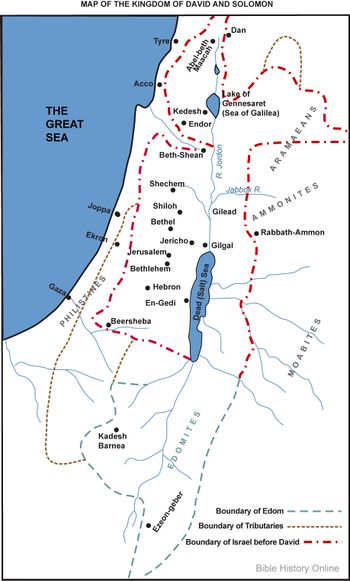تاريخ إسرائيل ويهودا القديمتين
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المنفى
عندما أعيد فتح أورشليم في عهد الإمبراطور يوليان ، هرع اليهود إليها من جميع أنحاء [فلسطين] ومن كل ولاية في الإمبراطورية، وسخر الرجال والنساء والأطفال جهودهم لإقامة البناء، وتبرعوا بحليهم وما ادخروه من أموالهم لتأثيث الهيكل الجديد ، وفي وسعنا أن نتصور سرور القوم الذين ظلوا مائتي عام يدعون ربهم أن يمنّ عليهم بهذا اليوم. ولكن بينما كانوا يحفرون الأرض لوضع الأساس إذ خرج من باطنها لهيب أحرق عدداً من العمال القائمين بالعمل. غير أن الناس عادوا إلى العمل من جديد-فعادت هذه الظاهرة مرة أخرى-ولعل سببها انفجار بعض الغازات الطبيعية - فأوقفت العمل وثبطت همة القائمين بالمشروع. وفرح المسيحيون إذ بدا لهم أن الله غير راض عن إعادة بناء الهيكل، وعجب اليهود من هذا وحزنوا له. ثم مات يوليان فجأة ، فحبست عنهم أموال الدولة ، وسنت من جديد القوانين المقيدة لهم وجعلت أشد صرامة مما كانت من قبل ، وحرم على اليهود مرة أخرى دخول أورشليم ، فعادوا إلى قواهم، وفقرهم، وصلواتهم. وكتب جيروم بعد قليل من ذلك الوقت يقول: إن أهل فلسطين اليهود "لا يزيدون على عُشر ما كانوا عليه من قبل". وفي عام 425 ألغى ثيودوسيوس الثاني الحاخامية الفلسطينية، وحلّت الكنائس المسيحية اليونانية محل المعابد والمدارس اليهودية، وتخلت فلسطين بعد هبة قصيرة في عام 614 ، عن زعامة العالم اليهودي. [1]
فهل يلام اليهود بعد هذا إذا أملوا أن تكون حالهم أحسن من هذه الحال في بلاد لا تسود فيها المسيحية سيادتها في البلاد التي يخضعون لسلطانها. فمنهم من انتقل نحو الشرق إلى أرض النهرين وإلى بلاد الفرس وقووا العنصر اليهودي البابلي الذي لم ينعدم من تلك البلاد منذ الأسر الذي حدث في عام 597 ق. م. وكانت وظائف الدولة محرمة على اليهود في بلاد الفرس أيضاً ؛ ولكن هذه الوظائف كانت محرمة كذلك على جميع الفرس ما عدا طبقة الأشراف ، ولذلك لم يكن هذا القيد ثقيلاً على اليهود أنفسهم. وقد حاقت باليهود في تلك البلاد عدة اضطهادات ، ولكن الضرائب المفروضة عليهم كانت أخف عبئاً منها في غير تلك البلاد، وكانت الحكومة في الأحوال العادية تتعاون معهم، وكان ملوك الفرس يعترفون بالإجزيلارك أي زعيم الطائفة اليهودية ويجلونه. وكانت أرض العراق وقتئذ خصبة تسقيها مياه النهرين ، ولذلك أضحى من فيها من اليهود زُرّاعاً أثرياء وتُجاراً ناشطين ، ومنهم طائفة من بينها عدد من جلة العلماء الذائعي الصيت أثرت من عصر الجعة.
وتضاعف عدد الجالية اليهودية في بلاد الفرس بسرعة كبيرة لأن دين الفرس كان يبيح تعدد الأزواج. وكان اليهود يتبعون هذه العادة لنفس الأسباب التي كانت تبيحها الشريعة الإسلامية. وكان الكوهنان الطيبان رب ونحمان أثناء تجوالهما يعلنان في كل مدينة يحلان بها عن رغبتهما في زوجات مؤقوتات ، لكي يضربا بذلك مثلاً لشبان تلك المدن للحياة الزوجية ويبعداهم على الحياة الإباحية. وفي نحرديا Nehardea، وسورة ، ويمبديثا أنشئت مدارس للتعليم العالي ، أضحى علماؤها، وأضحت قرارات كواهنها الدينية، موضع الإجلال في جميع أنحاء البلاد التي تشتت فيها اليهود. وظل اليهود في أثناء ذلك الوقت ينتشرون في جميع البلاد الواقعة حول البحر المتوسط. فمنهم من ذهب لينضم إلى الجاليات اليهودية في بلاد الشام وآسية الصغرى، ومنهم من ذهب إلى القسطنطينية، رغم عداء أباطرة الروم وبطارقتهم، ومنهم من اتجهوا من فلسطين جنوباً إلى جزيرة العرب وعاشوا في سلام وحرية دينية مع بني جنسهم الساميين، واحتلوا في تلك البلاد أقاليم برمتها مثل خيبر ، وكاد عددهم في يثرب (المدينة) يكون مساوياً لعدد العرب أنفسهم، واستمالوا إلى دينهم عدد من الأهلين، وهيئوا عقول العرب لما جاء به الإسلام من عقائد يتفق بعضها مع العقائد اليهودية. ومنهم من عبروا البحر الأحمر إلى بلاد الحبشة حيث تضاعف عددهم بسرعة حتى قيل إنهم بلغوا في عام 315 نصف سكان تلك البلاد. وكان اليهود يمتلكون نصف سفن الإسكندرية ، وكان ثراؤهم في تلك المدينة السريعة التأثر والاهتياج مما زاد من حدة العداء الديني.
وانتشرت جاليات يهودية في جميع مدائن أفريقيا الشمالية ، و صقلية ، و سردينيا. وكان عددهم كبيراً في إيطاليا ، وكان الأباطرة الوثنيون يحمونهم في العادة من الأذى ، وإن كان الأهلون المسيحيون والإمبراطور ثيودريك ، والبابوات يشددون عليهم النكير في بعض الأحيان. وكان في أسبانيا جاليات يهودية قبل يوليوس قيصر ، ونمت تلك الجاليات دون أن يتعرض لها بأذى تحت حكم الأباطرة الوثنيين، وأثروا في عهد القوط الغربيين الآريين ، ولكنهم تعرضوا للاضطهاد الميئس بعد أن اعتنق الملك ريكارد (568-601) عقائد مؤتمر نيقية. ولسنا نعرف أن اليهود تعرضوا للاضطهاد في غالة قبل أن تصدر قرارات مجلس أورليان الثالث والرابع (في عامي 538 و 541) بعد أن انتصر كلوفس Clovis المسيحي المتمسك بدينه على القوط الغربيين الآريين بجيل من الزمان. وأحرق مسيحيو أورليان كنيساً يهودياً حوالي عام 560، وطلب اليهود إلى جنترام Gunthram ملك الفرنجة أن يعيد بناؤه من أموال الدولة أسوة بما فعله ثيودريك في مثل هذه الحادثة من قبل. ولما رفض جنترام هذا الطلب صاح الأسقف جريجوري التوري Gregory of Tours: "ما أعظمك أيها الملك وما أعجب حكمتك!"(11). وكان اليهود في البلاد التي انتشروا فيها ينتعشون على الدوام بعد هذه الخطوب، فكانوا يعيدون بناء معابدهم في صبر وأناة ، وينظمون شئون حياتهم ويكدحون ، ويتجرون، ويرابون، ويصلون، ويأملون، ويزدادون ويتضاعفون. وكان يطلب إلى كل جالية في بلد أن تقيم على نفقتها مجتمعة ما لا يقل عن مدرسة ابتدائية وأخرى ثانوية يضمهما في العادة الكنيس نفسه وكان يشار على العلماء ألا يعيشوا في بلد يخلو من هاتين المدرستين. وكانت لغة العبادة والتعليم هي اللغة العبرية ، أما لغة التخاطب اليومي العادي فكانت الآرامية في بلاد الشرق، واليونانية في مصر وفي بلاد أوربا الشرقية؛ أما في غير تلك البلاد فكان اليهود يتخاطبون بلغة من يعيشون بينهم من الأهلين. وكان الدين هو الموضوع الذي يدور حول التعليم اليهودي، أما الثقافة غير الدينية فكادت في ذلك الوقت أن تهمل إهمالاً تاماً. ذلك أن اليهود المشتتين لم يكونوا يستطيعون أن يحفظوا كيانهم جسمياً وروحياً إلا عن طريق شريعتهم، وكان الدين عندهم هو دراسة هذه الشريعة والعمل بها. وكان دين آبائهم يزداد قيمة لديهم كلما زاد الهجوم عليه، وكان التلمود والكنيس الدعامتين والملجأين اللذين لا غنى عنهما لشعب حائر تقوم حياته على الرجاء ويقوم رجاؤه على الإيمان بالله.
منشئو التلمود
كان الكهنة ورجال الدين المقيمون في المعابد والمدارس الفلسطينية والبابلية هم الذين ألفوا أسفار الشريعة الضخمة المعروفة بالتلمود الفلسطيني والتلمود البابلي. وكانوا يقولون إن موسى لم يترك فقط لشعبه شريعة مكتوبة تحتويها الأسفار الخمسة، بل ترك له أيضاً شريعة شفوية تلقاها التلاميذ عن المعلمين ووسعوا فيها جيلاً بعد جيل. وكان أهم ما ثار حوله الجدل بين الفريسيين والصدوقيين الفلسطينيين هو: هل هذه الشريعة الشفوية هي الأخرى من عند الله فهي لذلك واجبة الطاعة؟ ولما أن زال الصدوقيون بعد تشتت اليهود عام 70 م وورث رجال الدين تقاليد الفريسيين ورواياتهم قبل جميع اليهود المتمسكين بدينهم الشريعة الشفوية، وأمنوا بأنها أوامر من عند الله وأضافوها إلى أسفار موسى الخمسة، فتكونت من هذه وتلك التوراة أو الشريعة الموسوية التي استمسك بها اليهود وعاشوا بمقتضاها، وكانت حقيقة لا مجازاً هي كيانهم وقواهم وحياتهم. وإن القصة التي تروي تلك العملية الطويلة التي استغرقت ألف عام، والتي تجمعت خلالها الشريعة الشفوية، واتخذت فيها صورتها النهائية المعروفة بالمشنا؛ والقرون الثمانية التي تجمعت فيها ثمار الجدل، والأحكام، والإيضاح فكانت هي الجمارتين ليتألف منهما التلمود الفلسطيني، وإلى أطولهما ليتألف منهما التلمود البابلي-إن القصة التي تروي هذه الأحداث الثلاثة لمن أكثر القصص تعقيداً وأعظمها إثارة للدهشة في تاريخ العقل البشري. وكما كان الكتاب المقدس أدب العبرانيين الأقدمين ودينهم، كانت التوراة حياة العصور الوسطى ودماءهم.
وذلك أن أحكام الشريعة الواردة في الأسفار الخمسة أحكام مسطورة، ولهذا فإنها لم تكن تستطيع الوفاء بجميع حاجات أورشليم بعد أن فقدت حريتها، ولا اليهودية بعد أن فقدت أورشليم، ولا الشعب اليهودي في خارج فلسطين، لم تستطع الوفاء بحاجات هذه أو معالجة الظروف المحيطة بها. ومن ثم كانت مهمة علماء السَّنهدرين قبل التشتت، والأحبار بعده، هي تفسير الشريعة الموسوية تفسيراً يهتدي به الجيل الجديد والبيئة الجديدة ويفيدان منه. وتوارث المعلمون جيلاً بعد جيل تفاسير هؤلاء العلماء ومناقشاتهم وآراء الأقلية والأغلبية في موضوعاتها. على أن هذه لروايات الشفوية لم تدون، ولعل سبب عدم تدوينها أن هؤلاء العلماء أرادوا أن يجعلونها مرنة قابلة للتعديل، أو لعلهم أرادوا بذلك أن يرغموا الأجيال التالية على استظهارها. فكان في وسع الأحبار الذين أخذوا على أنفسهم تفسير الشريعة إذا اضطرتهم الظروف أن يستعينوا بمن قدروا على استظهارها. وكان الأحبار في الستة القرون الأولى بعد ميلاد المسيح يسمون "التنإم Tennaim" أي "معلمي الشريعة" وإذ كانوا هم وحدهم المتضلعين فيها، فقد كانوا هم المعلمين والقضاة بين يهود فلسطين بعد تدمير الهيكل.
وكان أحبار فلسطين وأحبار اليهود "المشتتين أرستقراطية فذة لا مثيل لها في التاريخ. ذلك أن هؤلاء الأحبار لم يكونوا طبقة وراثية أو مغلقة مقصورة على طائفة خاصة من الناس، بل إن الكثيرين منهم قد ارتقوا من أفقر الطبقات، وكان معظمهم يكسبون قوتهم بالعمل في الصناعات المختلفة حتى بعد أن أصبحوا من ذوي الشهرة العالمية، وظلوا إلى ما يقرب من أخريات تلك الفترة التي نتحدث عنها لا يعطون أجوراً على قيامهم بالتدريس أو بأعمال القضاء وكان الأثرياء يجعلونهم في بعض لأحيان شركاء غير عاملين في مشروعاتهم المالية والتجارية، أو يؤوونهم في بيوتهم، أو يزوجونهم من بناتهم، ليوفروا عليهم عناء الكد لكسب قوتهم. ومنهم من عدد قليل أفسدهم ما كان لهم من المنزلة الرفيعة بين أبناء دينهم، ومنهم كانوا كسائر الخلق يغضون، ويغارون، ويحقدون، ويسرفون في النقد، ويتكبرون. ومنهم من كان لا بد لهم أن يذكروا أنفسهم المرة بعد المرة أن العالِم بحق رجل متواضع، لأن الحكيم يرى الجزء في ضوء الكل إن لم يكن لغير ذلك من الأسباب. وكان الناس يحبونهم لفضائلهم ولعيوبهم، ويعجبون بهم لعلمهم وتقواهم، ويروون ألف قصة وقصة تنبئ عن حكمتهم ومعجزاتهم. وقد ظل اليهود إلى يومنا هذا يجلون طلاّب العلم والعلماء كما لا يجلهم شعب آخر في العالم كله. ولما كثرت قرارات الأحبار وتضاعفت أصبحت مهمة استظهارها شاقة غير معقولة. ولذلك حاول هلل وعقيبا Akiba ومإير Meir مراراً عدة أن يصنفوها ويستعينوا على استظهارها ببعض الأساليب والرموز، ولكن هذه التصانيف والرموز والحيل لم يحظ شيء منها بالقبول من جمهرة اليهود. وكانت نتيجة هذا أن أصبح الاضطراب في نقل الشريعة هو القاعدة العامة، ونقص عدد من يحفظون الشريعة كلها عن ظهر قلب نقصاً مروعاً، وكان مما زاد الطين بلة أن تشتت اليهود قد نشر هذه القلة في أقطار نائية. وحوالي عام 189 تابع الحبر يهودا هنسيا Jehuda Hansia في قرية صبورة بفلسطين عمل عقيبا مإير، وعدله، وأعاد ترتيب الشريعة الشفوية بأكملها، ثم دونها، وزاد عليها إضافات من عنده، فكانت هي "مشنا الحبر يهودا" وانتشرت هذه بين اليهود انتشاراً أصبحت معه بعد زمن ما هي المشنا، والصورة المعتمدة لشريعة اليهود الشفوية.
والمشنا (أي التعاليم الشفوية) كما نعرفها اليوم هي الصورة النهائية لطبعات مختلفة كثيرة وحواشي متعددة أدخلت عليها من أيام يهوذا إلى الآن. ولكنها مع هذا خلاصة مدمجة محكمة، وضعت لكي تحفظ عن ظاهرة قلب بكثرة التكرار؛ ولهذا فإن من يقبل على قراءتها يرى أن عباراتها المحكمة الجامعة الغامضة تعذب قارئها بما تبعثه في نفسه من الآمال الخادعة اللهم إلا إذا كان هذا القارئ ملماً بحياة اليهود وتاريخهم. وقد قبلها يهود بابل وأوربا كما قبلها يهود فلسطين، ولكن كل مدرسة فسرت أمثالها وحكمها تفسيراً يخالف ما فسرتها به الأخرى، وجمعت ستة أجيال (220-500 م) من أحبار الأمورائم (الشراح) هاتين الطائفتين الضخمتين من الشروح وهما الجمارا الفلسطينية والبابلية، كما اشتركت من قبل ستة أجيال (10-220 م) من الأحبار التنإم في صياغة المشنا. وبذلك فعل المعلمون الجدد بمشنا يهودا ما فعله التنإم بالعهد القديم: فتناقشوا في النص، وحللوه، وفسروه، وعدلوه، ووضحوه لكي يطبقوه على المشاكل الجديدة، وعلى ظروف الزمان والمكان. ولما قارب القرن الرابع على الانتهاء نسقت مدارس فلسطين شروطها وصياغتها في الصورة المعروفة بالجمارا الفلسطينية. وشرع الكوهن رب آشي رئيس جامعة سورا حوالي ذلك الوقت في تقنين الجمارا البابلية وظل يواصل العمل في ذلك التقنين جيلاً من الزمان. وأتمه ربينا الثاني بار (ابن) شمويل، وهو أيضاً من جامعة سورا بعد مائة عام من ذلك الوقت.
وإذا ذكرنا أن الجمارا البابلية أطول من المشنا إحدى عشر مرة، بدأنا نعرف لم استغرق جمعها مائة عام كاملة. وظل الأحبار السبورائم (الناطقة) مائة وخمسين سنة أخرى (500-650) يراجعون هذه الشروح الضخمة، ويصقلون التلمود البابلي الصقل الأخير. بقي أن نقول أن لفظ التلمود يعني التعليم. ولك يكن الأمورائم يطلقون اللفظ إلا على المشنا. أما في الاستعمال الحديث فهو يشمل المشنا والجمارا.. والمشنا في التلمود البابلي هي بعينها مشنا التلمود الفلسطيني، ولا يختلف التلمودان إلا في الجمارا أو الشروح فهي في التلمود البابلي أربعة أمثالها في التلمود الفلسطيني . ولغة الجمارا البابلية والجمارا الفلسطينية هي الآرامية أما لغة المشنا فهي اللغة العبرية الجديدة تتخللها ألفاظ كثيرة مستعارة من اللغات المجاورة.
وتمتاز المشنا بالإيجاز ، فهي تعبر عن القانون الواحد بقليل من السطور، أما الجماريان فتتبسطان عن قصد وتعمد، وتذكران مختلف آراء كبار الأحبار عن نصوص المشنا وتصفان الظروف التي قد تتطلب تعديل القانون وتضيفان كثيراً من الإيضاحات. ومعظم المشنا نصوص قانونية وقرارات (هَلَكا)، أما الجماريان فبعضهما هلكا-إعادة نص قانون أو بحثه-وبعضها هجدة (قصص). وقد عرفت الهجدة تعريفاً غير دقيق بأنها كل ما ليس هلكا في التلمود. وأكثر ما تسجله الهجدة هو القصص، والأمثلة الإيضاحية. وأجزاء من السير، والتاريخ، والطب، والفلك، والتنجيم، والسحر، والتصوف، والحث على الفضيلة، والعمل بالشريعة، وكثيراً ما تروج الهجدة عن نفس الطلاّب المتعلمين بعد جدل معقد متعب. ومثال ذلك ما يأتي: بينما كان رب أمي ورب أسى يتحدثان مع الكوهن إسحق منجا إذ قال له أحدهما: "احك لنا يا سيدي قصة لطيفة"، وقال الآخر: "لا بل أرجوك أن تفسر لنا بدلاً من هذا نقطة دقيقة من النقاط القانونية".. فلما بدأ القصة أغضب أحدهما، ولما أخذ يشرح النقطة القانونية أغضب الآخر. فلما رأى ذلك ضرب لهما هذا المثل: "إن مثلي معكما كمثل رجل تزوج باثنتين إحداهما شابة والأخرى عجوز، فاقتلعت الزوجة الشابة جميع شعره الأشيب حتى يبدو شاباً، واقتلعت الزوجة العجوز جميع شعره الأسود حتى يبدو عجوزاً، وكانت نتيجة فعلهما هذا أن أصبح الرجل أصلع".
الشريعة
فإذا حاولنا الآن على الرغم من جهلنا بالموضوع عامة أن نصور باختصار ، بعض مناحي هذا التلمود الضخم، الذي تتأثر به كل صغيرة وكبيرة من حياة العبرانيين في العصور الوسطى، إذا حاولنا هذا وجب علينا أن نقر من بداية الأمر أننا إنما نخدش الجيل، وأن معالجتنا إياه من خارجه تعرضنا لا محالة للخطأ.
الناحية الدينية
يقول رجال الدين اليهود إن من واجب الإنسان أن يدرس الشريعة مسطورة وشفوية، ومن حكمتهم المأثورة في هذا المعنى قولهم: "إن دراسة التوراة أجل قدراً من بناء الهيكل". و"إن من واجب الإنسان وهو منهمك في دراسة الشريعة أن يقول لنفسه كل يوم: "كأنا في هذا اليوم قد تلقيناها من طور سيناء" ، وليست الدراسات الأخرى بعد ذلك واجبة؛ فالفلسفة اليونانية والعلوم الدنيوية لا تصح دراستها إلا في تلك الساعة التي ليست ليلاً ولا نهاراً. ويعتقد اليهود أن كلمة من كتابهم المقدس من كلمات الله بالمعنى الحرفي لهذه العبارة، وحتى نشيد الإنشاد نفسه إن هو إلا ترنيمة موحى بها من عند الله-لتصور بصورة مجازية اقتران يهوه بإسرائيل عروسه المختارة . وإذا كان انعدام الشريعة تعقبه حتماً الفوضى الأخلاقية فإن الشريعة وجدت لا محالة قبل أن يخلق العالم "في صدر الله أو عقله" ، وكان إنزالها على موسى لا شيء غيره حادثاً من حوادث الزمان. والتلمود أو بعبارة أدق جزؤه الذي يبحث في الشريعة (الهلكا) هو أيضاً كلمات الله الأزلية، وهو صياغة للقوانين التي أوحاها الله إلى موسى شفوياً ثم علّمها موسى لخلفائه، ولهذا فإن ما فيها من الأوامر والنواهي واجبة الطاعة تستوي في هذا مع كل من جاء في الكتاب المقدس ، لأنها صورة من الشريعة معدلة جاءت متأخرة عنها.وكانت بعض قرارات الأحبار تتعارض تعارضاً صريحاً مع قوانين أسفار موسى الخمسة، أو تفسرها تفسيراً يبيح مخالفتها.وكان يهود ألمانيا وفرنسا في العصور الوسطى يدرسون التلمود أكثر مما يدرسون الكتاب المقدس نفسه.
ومن المبادئ البديهية في التلمود، كما أن من المبادئ البديهية في الكتاب المقدس وجود إله عاقل قادر على كل شيء. وقد وجد بين اليهود من حين إلى حين عدد من المتشككين أمثال اليشع بن أيوبا العالم الذي اتخذه الكوهن ماير صديقاً له، ولكن يبدو أن أولئك المتشككين كانوا أقلية صغيرة لا تكاد تجهر بآرائها. والله كما يصفه التلمود إله متصف صراحة بصفات البشر ، فهو يحب ويبغض ويغضب ويضحك ويبكي. وسحي بوخز الضمير، ويلبس التمائم ، ويجلس على عرش يحيط به طائفة من الملائكة المختلفي الدرجات يقومون على خدمته، ويدرس التوراة ثلاث مرات في كل يوم. ويعترف رجال الدين بأن هذه الصفات البشرية قائمة على الافتراض إلى حد ما، ويقولون: "إننا نستعير له صفات من خلقه نصفه بها لنيسر بذلك فهمه"(26)؛ وإذا لم يكن في مقدور العامة أن يفكروا إلا على أساس الصور المادية فليس الذنب واقعاً عليهم. وهم يصورون الله أيضاً بأنه روح الكون غير المنظورة، السارية فيه كله، تمده بالحياة، تسمو عليه وتلازمه في وقت واحد، تعلو على العالم ولكنها مع ذلك حالة في كل ركن من أركانه وكل جزء من أجزائه. والحضرة الإلهية الكونية المسماة بالسكينا (السَّكَن) تكون بنوع خاص في الأشخاص المقدسين وفي الأماكن والأشياء المقدسة، وفي ساعات الدرس والصلاة. لكن هذا الإله القادر على كل شيء رغم هذا إله واحد. وليس بين الأفكار كلها فكرة أبغض إلى اليهودية من تعدد الآلهة، واليهود لا يفتئون يجهرون بوحدانية الله في حماسة قوية وينددون بشرك الوثنية وبما يبدو في الثالوث المسيحي من تثليث. وهم يجهرون بهذه الوحدانية في أشهر صلواتهم وأكثرها انتشاراً بينهم صلاة شمع يسرائيل: "اسمعي يا اسرائيل، الله إلهنا، الله واحد" (شمع يسرائيل أدوناي إلوهينا أدوناي أحد). وليس ثمة مكان بجواره في هيكله أو عبادته إلى مسيح، أو نبي، أو قديس. وقد نهى أحبار اليهود الناس عن ذكر اسمه إلا في أحوال جد نادرة يقصدون بذلك أن يحولوا بينهم وبين تدنيسه أو اتخاذه وسيلة للسحر، ولكي يتجنبوا النطق بهذا الاسم الرباعي يهوه كانوا يذكرون بدلاً من لفظ أدوناي أي الرب، بل ويشيرون بأن يستعمل بدلاً منه عبارات مثل: "الواحد المقدس" "الواحد الرحيم" "السماوات" "أبينا الذي في السماء". وفي اعتقادهم أن الله قادر على صنع المعجزات وأنه يصنعها فعلاً، وخاصة على أيدي كبار الأحبار؛ ولكن يجب ألا يظن أن هذه المعجزات خرق لقوانين الطبيعة إذ ليس ثمة قوانين إلا إرادة الله.
وقد خلق كل شيء لغرض إلهي طيب: "فقد خلق الله القوقعة لمداواة الجرب، والزجاجة لمداواة لسعة الزنبور، والبعوضة لمداواة عضة الأفعى، والأفعى لعلاج الاحتقان وبين الله والإنسان صلة لا تنقطع وكل خطوة يخطوها إنما يخطوها أمام ناظريه لا تخفي عنه، وكل عمل يعمله الإنسان أو فكرة تجول بخاطره في خلال يومه يمجد بها الذات الإلهية أو يغضبها. والناس كلهم أبناء آدم، ولكن "الإنسان قد خلق أولاً وله ذنب كذنب الحيوان و"كانت وجوه الناس إلى عهد أخنوخ شبيهة بوجوه القردة. ويتكون الإنسان من جسم وروح، فروحه من عند الله، وجسمه من الأرض، والروح تدفعه إلى الفضيلة، والجسم يدفعه إلى الخطيئة، أو لعل دوافعه الشريرة وقد أتت إليه من الشيطان، ومن ذلك العدد الجم من الأرواح الخبيثة التي تكمن حوله في كل مكان. بيد أن كل شر قد يكون في نهاية الأمر خيراً؛ ولولا شهوات الإنسان الأرضية لما كد الإنسان أو تناسل. وتقول إحدى الفقرات الظريفة "تعال نعز الخير لآبائنا، فإنهم لو لم يأثموا لما جئنا نحن إلى هذه الدنيا". والخطيئة من فطرة الإنسان، ولكن ارتكابها ليس موروثاً، وقد قبل أحبار اليهود عقيدة سقوط الإنسان، ولكنهم لم يقبلوا عقيدة الخطيئة الأولى ولا الكفارة الإلهية. فالإنسان في رأيهم لا يعاقب إلا على ما ارتكبه هو من الذنوب، وإذا ما لقي من العقاب في الحياة الدنيا أكثر مما يبدو له أن يستحقه على ذنوبه، فقد يكون ذلك لأننا لا نعرف مقدار هذه الذنوب كلها، أو قد يكون هذا الإفراط في العقاب نعمة كبرى، تؤهله للخير العميم في الدار الآخرة. ومن أجل هذا يجب على الإنسان كما يقول عقيبا أن يبتهج لكثرة ما يصيبه من سوء(33) أما الموت فقد جاء إلى الدنيا بسبب آثام الإنسان؛ وغير الآثم بحق لا يموت أبداً. فالموت دين على البشرية الآثمة لباعت الحياة جميعها. ويقص علينا مدرسنا قصة مؤثرة عن موت الكائن مإير فيقول: بينما كان الكوهن مإير يلقي موعظته الأسبوعية عصر يوم من أيام السبت إذا مات ولداه المحبوبان فجأة في منزله. فغطتهما أمهما بغطاء، وأبت أن تندبهما في اليوم المقدس. ولما عاد الكوهن مإير بعد صلاة المساء سأل عن ولديه لأنه لم يرهما في الكنيس بين المصلين، فطلبت إليه أن يتلو الهبدلة (وهي دعاء يختتم به السبت) وقدمت له العشاء. ثم قالت له: "لدي سؤال أريد أن أسألك إياه. ائتمنني أحد الأصدقاء في يوم من الأيام على جواهر أحفظها له، ثم أراد الآن أن يستعيدها فهل أردها إليه؟". فأجابها الكوهن مإير "ذلك واجب عليك بلا ريب"؛ فأمسكت زوجته حينئذ بيده، وسارت به إلى الفراش ورفعت عنه الغطاء. فأخذ الكوهن مإير ينتحب ولكن زوجته قالت له: لقد كانا وديعة لدينا إلى حين والآن قد أراد سيدهما أن يسترد وديعته". ولم يقل كتاب العبرانيين المقدس إلا الشيء القليل عن خلود الثواب والعقاب، ولكن هذه الفكرة أصبحت ذات شأن كبير في آراء الأحبار الدينية. فقد صوروا النار على أنها جهنم! Ge Hinnom أو شاول ، وقسموها كما قسموا السموات إلى سبع طبقات تتدرج في درجات العذاب. ولا يدخلها من المختتنين إلا أخبثهم(36)، وحتى الآثمون الذين يدامون على الإثم لا يعذبون فيها إلى أبد الآبدين، بل إن "كل من يلقون في النار يخرجون منها مرة أخرى إلا فئات ثلاثاً: الزاني، ومن يفضح غيره أمام الناس، ومن يسب غيره". أما السماء فقد كانوا يسمونها جنة عدن Gen Edon، وكانوا يصورونها في صورة حديقة تحوي جميع المسرات الجسمية والروحية. فخمرها عصرت من كروم احتفظ بها من الستة أيام التي خلق فيها العالم، والهواء فيها معطر بالروائح الزكية، والله نفسه يجتمع بالناجين من العذاب في وليمة أعظم ما يسر أصحابها أن يروا وجهه. بيد أن بعض أحبار اليهود يعترفون بأن أحداً لا يعرف قط ما وراء القبر.
وإذا ما فكر اليهود في النجاة كان تفكيرهم فيها أنها نجاة الشعب لا نجاة الفرد. وذلك أنهم وقد شتتوا في أنحاء العالم بضروب من القسوة لا يبررها في ظنهم عقل، وأخذوا يقوون أنفسهم باعتقادهم أنهم لا يزالون شعب الله المحبوب المختار، فهو أبوهم، وهو إله عادل، ولا يمكن أن ينكث عهده لإسرائيل. أليسوا هم الذين أنزل عليهم كتابه المقدس الذي يؤمن به المسيحيون والمسلمون ويعظمونه؟ وقد دفعتهم شدة يأسهم إلى درجة من الكبرياء اضطر معه أحبارهم الذين سموا بهم إلى تلك الدرجة أن ينزلوا بهم عنها بضروب اللوم والتأنيب. وكانوا في ذلك الوقت كما هم الآن يتوقون إلى البلد الذي نشأت فيه أمتهم، وكانوا يعزونها ويرون أنها المثل الأعلى لجميع البلدان، ويقولون "إن من يمشي أربع أذرع في فلسطين يعيش بلا ريب إلى أبد الآبدين، ومن يعش في فلسطين يطهر من الذنوب" . وحديث من يسكنون فلسطين في حد ذاته توراة" ، وأهم قسم في الصلوات اليومية وهو الشمونة عسراً (الفقرات الثمان عشرة) تحوي دعاء بمجيء ابن داود، الملك المسيح الذي يجعل اليهود كما كانوا أمة متحدة، حرة، يعبدون الله في هيكلهم بشعائرهم وترانيمهم القديمة.
الشعائر الدينية
لم يكن ما يميز اليهود من غيرهم من الشعوب في عصر الإيمان الذي نتحدث عنه، والذي يحفظ عليهم وحدتهم وهم مشتتون، هو عقيدتهم الدينية بل شعائرهم، لم يكن هو العقيدة التي لم تفعل المسيحية أكثر من التوسع فيها والتي قبل الإسلام الكثير منها بل هو قواعد الطقوس والمراسم المعقدة تعقيداً ثقيلاً. يكن في مقدور شعب غير هذا الشعب المتكبر، السريع التأثر، أن يظهر من الوداعة والصبر ما تتطلبه إطاعته والعمل بها. لقد كانت المسيحية تنشد الوحدة عن طريق توحيد العقيدة، أما اليهودية فكانت تنشدها عن طريق توحيد الشعائر. وفي ذلك يقول أبا أريكا: "إن الشرائع لم توضع إلا لكي تؤدب الناس وترقق طباعهم بالعمل بها". ولقد كانت الشعائر أولاً وقبل كل شيء هي قانون العبادة. ولما أن حلت المعبد اليهودية محل الهيكل استبدلت بالأضاحي الحيوانية القرابين والصلوات، ولكنهم لم يكونوا يجيزون وضع صورة لله أو للآدميين في المعابد كما لم يكونوا يجيزون وضعها في الهيكل. ذلك أنهم كانوا يتجنبون كل ما يشتم منه عبادة الأوثان، وكذلك كانت الموسيقى الآلية المباحة في الهيكل محرمة من المعابد. وفي هذا تختلف المسيحية عن اليهودية وتتفق مع الإسلام، فقد تكشف الدينان الساميان عن تقوى قائمة وتكشفت المسيحية عن فن مقبض قاتم كذلك.
وكانت الصلاة تجربة دينية يمارسها اليهودي المتدين كل يوم، بل يكاد يمارسها في كل ساعة. وكانت صلوات الصباح تتلى من قلقطيرات (علب صغيرة محتوية على فقرات من الكتاب المقدس) مثبتة على الجباه والأذرع ولم يكونوا يطعمون طعاماً دون أن يتلو دعاء قصيراً قبله وصلاة الشكر طويلة في نهايته. على أنهم لم يكونوا يكتفون بهذه الصلوات المنزلية، ذلك أن الناس لا يرتبطون ويتماسكون إلا إذا اشتركوا معاً في القيام بأعمال واحدة، وكان أحبار اليهود يحاجون بما عرف عن الشرقيين من مبالغة أن "الله لا يستجيب لصلاة الإنسان إلا إذا قام بها في الكنيس". وكان أهم ما تشتمل عليه الطقوس الدينية العامة هو "الشمونة عسراً"، "والشمع يسرائيل، وتلاوة من أسفار موسى الخمسة، ومن سفر الأنبياء، ومزامير داود، وعظة تشتمل على تفسير فقرات من الكتاب المقدس، وعلى "قديس Kaddish" (أدعية حمد وبركة للأحياء والأموات) ثم دعاء ختامي. ولا يزال هذا هو الأساس الجوهري للشعائر التي تقام في المعابد إلى يومنا هذا.
وأدق من هذه الشعائر وأكثر منها تفصيلاً القواعد الخاصة بالنظافة البدنية أو طقوس الطهارة. فقد كان أحبار اليهود يرون أن الصحة البدنية تعين على سلامة الروح ولهذا كانوا يحرمون على بني دينهم أن يعيشوا في مدينة ليس بها حمّام، ويعينون للاستحمام قواعد تكاد تبلغ مرتبة الأوامر الطبية كقولهم: "إذا اغتسل الإنسان بماء ساخن ولم يغتسل بعده بماء بارد كان مثله كمثل الحديد الذي يحمي في تنور ثم لا يوضع بعدئذ في ماء بارد" ، فمثل الجسم كمثل الحديد يجب أن يسقى ويُقَسَّى ويجب أن يدهن الجسم بالزيت بعد الاستحمام كذلك يجب غسل اليدين عقب الاستيقاظ مباشرة، وقبل تناول كل وجبة من الوجبات وبعد تناولها، وقبل الصلاة العامة وقبل القيام بكل شعيرة دينية. وكانت جثث الموتى، والاتصال الجنسي، والحيض، والولادة، والحشرات، والخنازير، والجذام (ومختلف الأمراض الجلدية) كانت هذه كلها حسب القواعد الدينية نجسة، ومن مس شيئاً منها أو أصيب به وجب عليه أن يتوجه إلى الكنيس ويؤدى فيه شعائر التطهير. وكانت المرأة تعد نجسة (أي لا يقترب منها زوجها) أربعين يوماً بعد أن تلد ولداً ذكراً، وثمانين يوماً إذا كانت المولودة أنثى. ويجب وفقاً لما ورد في الكتاب المقدس (في الآيات من 9 إلى 14 من الإصحاح السابع عشر من سفر التكوين) أن تجري عملية الختان للمولود الذكر في اليوم الثامن بعد مولده، وكان هذا الختان يعد قرباناً ليهوه وعهداً بينه وبين عباده؛ ولكن انتشار هذه العادة بين المصريين الأقدمين، والأحباش، والفينيقيين، والسوريين، والعرب، يوحى بأنها كانت إجراءاً صحياً يحتمه الجو الذي يساعد على النضوج والاهتياج الجنسي المبكرين، أكثر مما هو وسيلة من وسائل النظافة.
ويؤيد هذا الرأي ما يحتمه أحبار اليهود على بني دينهم ألا يبقوا لديهم عبداً أكثر من اثني عشر شهراً دون ختان.
وقد يخيل إلى الإنسان وهو يقرأ بعض أجزاء من التلمود أنه كتاب مبسط في الطب المنزلي أكثر مما هو كتاب في الشرائع الدينية، والحق أنه كان لا بد أن يجعل بمثابة موسوعة من النصائح للشعب اليهودي. ذلك أن يهود القرن الرابع والقرن الخامس بعد الميلاد كانوا كمعظم شعوب البحر المتوسط ينزلون عائدين إلى الخرافات والحيل الطبية التي تسود بين الشعوب المنعزلة الفقيرة؛ ولقد تسرب كثير من هذا الطب الشعبي والخرافي إلى التلمود. غير أننا مع هذا نجد في الجمارا البابلية وصفاً غاية في الجودة للمريء، والحنجرة، والقصبة الهوائية، والرئتين، والأغشية السحائية، وأعضاء التناسل. وقد وصف فيه خراجات الرئتين وتليف الكبد، والحَرَض الجَبَني وكثير غيرها من الأمراض وصفاً دقيقاً؛ ومما أثبته الأحبار أن الذباب وأكواب الشرب قد تنقل العدوى ، كما أثبتوا أن التدمام (أي الاستهداف للنزف) داء وراثي يجعل ختان أبناء المصابين به أمراً غير مستحب لكن هذه الآراء قد اختلطت بها رقي سحرية لطرد الأرواح الخبيثة التي يحسبونها سبباً في الأمراض. ولقد كان أحبار اليهود، مثلنا نحن جميعاً، خبراء في التغذية الصحية. ونبدأ القواعد الحكيمة للتغذية عندهم بالأسنان. فهذه في رأيهم يجب ألا تخلع، مهما اشتدت آلامها لأن "الإنسان إذا أجاد مضغ الطعام بأسنانه وجدت قدماه القوة". وهم يمتدحون الخضر والفاكهة ما عدا البلح ويوصون بأكملها. أما اللحم فمن مواد الترف التي يجب ألا يتناولها سوى المتطهرين. ويجب أن يذبح الحيوان بحيث تقل آلامه إلى أقصى حد، وبحيث يخرج الدم من اللحم، لأن أكل اللحم بما فيه من الدم رجس. ومن أجل هذا يجب أن يعهد ذبح الحيوان لاتخاذ لحمه طعاماً إلى أشخاص مدربين، عليهم أن يفحصوا عن أحشائه حتى يتأكدوا من أن الحيوان سليم من الأمراض. ويجب ألا يجمع في الوجبة الواحدة بين اللحم واللبن أو بين الأطعمة التي يدخل فيها هذان الصنفان، بل يجب ألا يوضعا قريبين أحدهما من الآخر في المطبخ. ولحم الخنزير محرم ممقوت. ولا يصح أكل البيض، أو البصل، أو الثوم إذا كان قد ترك بالليل منزوع القشر. ويجب الامتناع عن تناول الطعام في غير أوقاته المحددة: "لا تنقر طول النهار كالدجاج". "والذين يموتون من الإفراط في الأكل أكثر ممن يموتون من نقص التغذية". "والأكل إلى سن الأربعين نافع للصحة، أما بعد الأربعين فالشرب نافع لها" ، والاعتدال في الشرب خير من الامتناع عنه بتاتاً، فكثيراً ما يكون الخمر دواء نافعاً ، و "ليس ثمة سرور إلا به"(59). وقد أراد أحبار اليهود أن يسيروا في موضوع التغذية إلى غايته فقالوا إن "من يطل المكث في المرحاض يطل عمره" وأشاروا بأداء صلاة شكر كلما استجاب الإنسان لنداء الطبيعة .
وكانوا يقامون التنسك وينصحون بني دينهم أن يتمتعوا بطيبات الحياة إذا لم يكن فيها ما هو محرم. وقد فرض عليهم الصيام في مواسم معينة وفي بعض الأيام المقدسة، ولكن لعل الدين هنا قد اتخذ وسيلة للحض على العناية بالصحة. واقتضت حكمة الشعب أن يؤمر اليهود بأن يحتفلوا بالأعياد ويقيموا الولائم من آن إلى آن، رغم نغمات الحزن والأسى التي كانت تسمع منهم حتى في أفراحهم. "يجب على الإنسان أن يدخل السرور في العيد على زوجته وآل بيته". ويجب عليه إن استطاع أن يهيئ لهم ثياباً جديدة. ويبدو أن السبت-وهو أعظم ما ابتدعه اليهود-كان عبئاً ثقيلاً عليهم في أيام التلمود، فقد كان ينتظر من اليهودي التقي أن يجعل كلامه أقل ما يستطيع، وألا يوقد النار في منزله، وأن يقضي الساعات عاكفاً على الصلاة في الكنيس. وثمة نبذة طويلة تتحدث بالتفصيل الوافي الممل عما يجوز عمله وما لا يجوز في السبت. ولكن فتاوي الأحبار كانت تهدف إلى التقليل من أهوال التقوى أكثر مما تهدف إلى زيادتها. وكان ما فيها من الدقة يرمي إلى تلمس الأسباب المقنعة لحمل الإنسان على أن يفعل ما يجب عليه أن يفعله في يوم الراحة. يضاف إلى هذا أن اليهودي الصالح كان يجد سعادة خفية في التمسك بشعائر السبت القديمة. فكان يبدؤه بقداس قصير. كان وهو محوط بأفراد أسرته وبأصدقائه (لأن هذا اليوم كان من الأيام التي يحلو فيها دعوة الأصدقاء)، يمسك بيده كأساً مملوءة بالخمر، يتلو عليها بعض الأدعية، ثم يشرب بعضها ويناول الكأس لضيوفه وزوجته وأبنائه. ثم يأخذ بعدئذ الخبز ويباركه، ويحمد الله "الذي يخرج الخبز من الأرض"، ويعطي بعضه لكل من يجلسون معه على المائدة. ولا يجوز الصوم أو الحزن في السبت.
وكانت أيام مقدسة كثيرة تتخلل العام وتتيح لليهود الفرص للاحتفال بالذكريات المقدسة أو الراحة المحببة. فمنها عيد الفصح اليهودي الذي يبدأ في الرابع عشر من شهر نيسان (إبريل) ويستمر ثمانية أيام يحيي فيها ذكرى فرار اليهود من مصر. وكانوا في الأيام الأولى من العهد الذي أوحى فيه بالكتاب المقدس يسمونه عيد الخبز الفطير، لأن اليهود قد فروا ومعهم العجين الذي يصنعون منه خبزهم دون أن يختمر. وكان هذا العيد يسمى في أيام التلمود عيد المرور، لأن يهوه وهو يقضي على البكور من أبناء المصريين قد "مر" بالبيوت التي رش من فيها من اليهود دم الحمل على قوائم أبوابها. وكان اليهود يحتفلون في اليوم الأول من هذا العيد بوجبة عيد الفصح (السّدِر)، فكان كل أب يرأس حفلة الصلاة لأسرته المجتمعة عنده. ويقوم معهم بمراسم تذكرهم بأيام موسى البئيسة، ينقل في خلالها عن طريق الأسئلة والأجوبة القصة القيمة العزيزة إلى الأبناء الصغار وفي عيد العنصرة، وموعده بعد سبعة أسابيع من عيد الفصح يحتفل اليهود في عيد شيوعوت بحصاد القمح وتجلي الله لموسى على الجبل في سيناء. وفي اليوم الأول من تشرين-وهو الشهر السابع من السنة اليهودية الدينية، والشهر الأول من سنة اليهود المدنية-وهو يتفق بوجه عام مع الاعتدال الخريفي يحتفل اليهود بعيد رأس السنة، وبهلال الشهر، وينفخون في القرن الحمل (الشفار أي الصفارة) إحياء لذكرى نزول التوراة، ودعوة الناس إلى التوبة من الذنوب، واستعجالاً لذلك اليوم السعيد حين يدعي جميع اليهود العالم ليعبدوا الله في أورشليم. ومن مساء رأس السنة إلى اليوم العاشر من تشرين أيام توبة وتفكير عن الذنوب، وكان أتقياء اليهود في هذه الأيام جميعها ما عدا اليوم التاسع منها يصومون ويصلون؛ فإذا جاء اليوم العاشر المسمى يوم هاكريم (يوم الغفران) لم يكن يجوز لهم فيه أن يأكلوا أو يشربوا أو يحتذوا نعالاً أو يقوموا بعمل أو يستحموا أو يقربوا النساء من مطلع الشمس إلى مغيبها، بل كانوا يقضون النهار كله في الكنيس يصلون، ويعترفون بذنوبهم، ويستغفرون لها هي وذنوب بني دينهم، يستغفرون لهذه الذنوب بما فيها عبادة العجل الذهبي نفسه. وفي اليوم الخامس عشر من شهر تشرين يحل عيد سوكوت أو عيد المظلات. وكان المفروض أن يقضي اليهود هذا العيد في أخصاص إحياء لذكرى الخيام التي يقال إن آباءهم الأقدمين قد ناموا فيها خلال الأربعين يوماً التي قضوها في البيداء. ولما وجد اليهود المشتتون صعاباً جمة في الاحتفال بعيد الحصاد هذا كما هو مفروض عليهم بالدقة، أظهر أحبارهم ما يتصفون به من تسامح بأن فسروا السكة (الخيمة) بأنها كل ما يصح أن يرمز به للمسكن. وفي اليوم الخامس والعشرين من الشهر التاسع شهر كسلو (ديسمبر) والسبعة أيام التالية لهذا اليوم يقع عيد حَنّكة أو التكريس، الذي يذكرهم بتطهير الهيكل من المكابين (165 ق. م)، بعد أن دنسه أنتيوخوس إبفانيز Anfiochuc Epiphanes، وفي الرابع عشر من آذار (مارس) يحتفل اليهود بعيد بوريم الذي أنجى فيه موردكي وإستر الشعب من مكر الوزير الفارسي هامان. وكانوا في ذلك اليوم يتبادلون الهدايا والدعوات أثناء وليمة مرحة يشربون فيها الخمر. وفي ذلك يقول رب ربا Rab Raba إن على الإنسان أن يشرب في ذلك اليوم حتى لا يستطيع التمييز بين قولهم "ملعون هامان" و "ملعون موردكي".
وليس من حقنا أن نظن أن هؤلاء اليهود التلموديين قوم مفرطون في التشاؤم يحز في نفوسهم احتقار من حولهم من الشعوب لمواهبهم، تتقاذفهم أعاصير العقائد المتباينة، يهيمون في بيداء الآمال بالرجوع إلى بلادهم. ذلك أنهم وهم يعانون مرارة التشتت والظلم، والندم والفقر، كانوا يرفعون رؤوسهم عالية، ويتذوقون لذة العمل والكفاح في سبيل الحياة، ويستمتعون بما يتجلى به نساؤهم المثقلات من جمال قصير الأجل وما في الأرض والسماء من جلال مقيم. وفي ذلك يقول كوهنهم مإير: "يجب أن ينطق الإنسان في كل يوم بمائة دعوة صالحة". ويقول كوهن آخر قولاً ما أجدرنا كلنا أن نعمل به "إذا مشي إنسان أربعة أذرع لا أكثر لم يطأطأ فيها رأسه أغضب الله، ألم يرد في الكتاب المقدس "مجده ملئ كل الأرض".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المبادئ الأخلاقية في التلمود
ليس التلمود موسوعة من التاريخ، والدين، والشعائر، والطب، والأقاصيص الشعبية وحسب، بل هو فوق هذا كله رسالة في الزراعة، وفلاحة البساتين، والصناعة، والمهن، والتجارة(67)، وشئون المال، والضرائب، والملك والرق، والميراث، والسرقة، والمحاكمات القضائية، والقوانين الجنائية. وإذا شئنا أن نوفي هذا الكتاب حقه من البحث، كان علينا أولاً أن نلم بطائفة كبيرة العدد من العلوم المختلفة، وأن نكتسب منها ما تهيؤه لعقولنا من الحكمة وسداد الرأي، ونستخدم تلك الحكمة الجامعة في الإلمام بأحكام هذا الكتاب في الميادين المختلفة السالفة الذكر.
وأول ما نذكره أن التلمود أولاً وقبل كل شيء قانون أخلاقي، وأن هذا القانون الأخلاقي شديد الاختلاف عن القانون الأخلاقي المسيحي وعظيم لشبه بالقانون الإسلامي، حتى لتكفي نظرة خاطئة إليه لدحض الرأي السائد في العصور الوسطى القائل بأنه ليس إلا قصة المسيحية في تلك العصور. إن الأديان الثلاثة الكبرى متفقة في أن المبادئ الأخلاقية الفطرية-غير الدينية-تصلح لأن تكون قواعد عملية للإنسانية؛ وترى أن الكثرة الغالبة من الناس لا يمكن أن تحمل على المسلك الحسن والخلق القويم إلا عن طريق خوف الله. ولهذا أقامت الأديان الثلاثة قانونها الأخلاقي على مبادئ رئيسية واحدة: أن الله عيناً تبصر كل شيء، وأن القانون الأخلاقي منزل من عند الله، وأن الفضيلة تتفق في آخر الأمر مع السعادة بما يناله المحسن بعد الموت من الثواب والمسيء من العقاب. ولم يكن من المستطاع في الدينين الساميين فصل القوانين الثقافية والأخلاقية من الدين. فلم تكن هذه القوانين تجير التفرقة بين الجريمة والخطيئة، أو بين الشر والشريعة الكنسية، بل إن من مبادئها المقررة أن كل فعل ذميم. يعد إساءة إلى الله وانتهاكاً لحرماته ولاسمه جل جلاله.
وتتفق الأديان الثلاثة فضلاً عن هذا في بعض قواعد الأخلاق: تتفق في حرمة الأسرة والمسكن، وفيما يحب للآباء وكبار السن من تكريم وإجلال وفي حب الأبناء ورعايتهم، وفي مل الخير لجميع الناس. وليس ثمة شعب أكثر من اليهود حرصاً على تجميل الحياة العائلية، ولقد كان عدم الزواج عن قصد من الآثام الكبرى في اليهودية كما هو في الإسلام ؛ وكان إنشاء البيت وتكوين الأسرة من الأمور الشرعية التي يحتمها الدين ، وتنص عليه القاعدة الأولى من قواعد الشريعة البالغ عددها 613 قاعدة، وفي ذلك يقول أحد المعلمين اليهود "إن من لا ولد له يعد من الأموات"، ويتفق اليهودي، والمسيحي، والمسلم في أن البشرية تصبح مهددة بالزوال إذا ما فقدت قوتها أوامر الدين التي تقضي بوجوب إنجاب الأبناء. على أن أحبار اليهود أباحوا تحديد عدد أفراد الأسرة في بعض الأحوال؛ ويفضلون أن تكون السبيل إلى هذا هي منع الحمل، وفي ذلك يقول بعضهم: "هناك ثلاث طبقات من النساء يجب عليهن أن يستعملن الأدوية الماصة: القاصر خشية أن يقضي الحمل على حياتها؛ كيلا تكون النتيجة هي الإجهاض، والمرضع حتى لا تحمل فتضطر إلى فطام الرضيع قبل الأوان فيموت الطفل".
وكان اليهود، كما كان معاصروهم، يكرهون أن يلدوا بنات ويسرون إذا أنجبوا الذكور، ذلك أن الذكر لا الأنثى هو الذي يحمل اسم أبيه واسم الأسرة، ويرث أملاكه، ويعني بقبره بعد وفاته، أما البنت فسوف تتزوج في بيت غريب وقد يكون بيتاً بعيداً، ولا تكاد تتم تربيتها حتى يفقدها أبواها. لكن الآباء متى رزقوا الأبناء، ذكوراً كانوا أو إناثاً، أعروهم وأدبوهم تأديباً ممزوجاً بالحب وفي ذلك يقول أحد أحبارهم: "إذا كان لا بد لك أن تضرب طفلك، فاضربه برباط حذاء". ويقول آخر "إذا امتنع الإنسان من عقاب طفل، انتهت به الحال إلى الفساد المطلق"(73) وكان من الواجب على الآباء أن يتحملوا كل تضحية تتطلبها تربية الأبناء أي تثقيف العقل، وتقويم الخلق بدراسة "الشريعة وأسفار الأنبياء". وقد جاء في أحد الأمثال العبرية: "إن العالم ينجو بنفس تلاميذ المدارس"(74) فالسكينة أو الحضرة الإلهية تتجلى في وجوههم؛ وفي نظير هذا يجب على الابن أن يعظم والديه ويحميهما بكل ما في وسعه وفي جميع الأحوال.
والصدقات من الواجبات التي لا مفر من أدائها وإن "من يتصدق لأعظم ممن يقدم كل القرابين"(75). ولقد كان بعض اليهود أشحاء، وبعضهم بخلاء إلى أقصى حدود البخل، ولكنهم بوجه عام يفوقون سائر الشعوب في هباتهم وتبرعاتهم، وقد بلغ من سخائهم في هذه الناحية أن اضطر أحبارهم إلى أن ينوههم عن إعطاء أكثر من خمس أموالهم للصدقات، ومع هذا فقد وجد عند وفاة بعضهم أنهم قد أعطوا نصف ما يملكون رغم هذا التحريم. "لقد كانت تلوح على وجه أبا أو منا على الدوام هالة من الطمأنينة القدسية، ذلك بأنه كان جرّاحاً ولكنه لم يكن يرضى أن يمسك بيديه أجراً على عمله، بل كان له صندوق في ركن حجرة استشارته يستطيع من كان في مقدوره أداء شيء من المال أن يضع فيه ما يرغب في أدائه... وحتى لا يعتري الخجل من يعجز عن أداء شيء منه". وكان رب هونا "إذا جلس لتناول الطعام فتح أبوابه ونادى: من كان في حاجة أن يدخل ويطعم". وكان شاما بن إلعي Chama ben Elai يطعم الخبز كل من يطلبه ويضع يده في كيس نقوده كلما سار في خارج داره حتى لا يحجم أحد عن سؤاله. ولكن التلمود كان يؤنب التظاهر بالبذل ويشير بأن يكون سراً ويقول "إن من يعطي الصدقات سراً أعظم من موسى".
ووجه رجال الدين كل ما أوتوا من علم وبلاغة لامتداح نظام للزواج الذي كان هو والدين الأساس الذي يقوم عليه صرح الحياة اليهودية كلها. ولم ينددوا بالشهوة الجنسية ولكنهم كانوا يخشون قوتها وبذلوا جهدهم في كبح جماحها. فمنهم من كان ينصح بأكل الملح مع الخبز "ليقل المنى" ، ومنهم من كان يحس بأن الوسيلة الوحيدة لكبح جماح الشهوة الجنسية هو العمل المجهد مضافاً إلى دراسة التوراة؛ فإذا لم يجد هذه الوسيلة "فليذهب إلى مكان لا يعرفه فيه أحد، وليلبس سود الثياب، وليفعل ما تبتغيه نفسه، ولكن عليه ألا يدنس اسم الله جهرة". وعلى الإنسان أن يبتعد عن كل المواقف التي تثير شهوته، فلا يكثر من الحديث مع النساء، "ولا يمشي في الطريق خلف امرأة" وتظهر فكاهة أحبار اليهود المبهجة مرة أخرى في قصة رب كهنا Red Kahan.
فقد كان مرة يبيع سلال النساء وإذا هو يتعرض لهواية الشيطان. وأخذ يقاوم طبيعته راجياً أن ينطلق هذه المرة على أن يعود إلى نجا. ولكنه بعد أن تغلب على نفسه لم يعد بل صعد إلى سقف بيت وألقى بنفسه من فوقه، وقبل أن يصل إلى الأرض وصل إليه اليشع وأمسك به ولامه على أن اضطره إلى قطع مسافة أربعمائة ميل لكي يحول بينه وبين إهلاك نفسه.
ويلوح أن أحبار اليهود يرون أن البكورية لا بأس بها، ولكن البكورية الدائمة هي بعينها وقف النماء الطبيعي، ويعتقدون أن كمال المرأة في كمال الأمومة، كما أن اسمى فضائل الرجل فضيلة الأبوة الكاملة. وكان من الواجب على كل أب أن يدخر بائنة لكل بنت من بناته ومهراً يمهر به كل ولد من أولاده عروسه حتى لا يتأخر زواج الولد والبنت تأخراً يضر بصحتهما. وكانوا يشيرون بالزواج المبكر-في الرابعة عشرة للبنت وفي الثامنة عشرة للولد. وكان القانون يبيح زواج البنت إذ بلغت سنها اثنتي عشرة سنة وستة أشهر وزواج الولد في الثالثة عشرة من عمره. وكان يباح للطلاّب المشتغلين بدراسة الشريعة أن يؤخروا زواجهم بعض الوقت. ومن الأحبار من كانوا يقولون إن على الرجل أن يثبت دعائم مركزه الاقتصادي قبل أن يقدم على الزواج: "على الرجل أولاً أن ينشئ البيت، ثم يغرس الكرمة، ثم يتزوج". -ولكن هذا الرأي هو رأي الأقلية ولعله لا يتعارض مع الزواج المبكر إذا ما تكفل الأبوان بتدبير العون المالي المطلوب. وكانوا ينصحون الشباب بألا يختار زوجته لجمالها بل لصفاتها التي سوف تجعلها في المستقبل أماً صالحة ، ويقولون "اهبط درجة في اختيار الزوجة، وأرقى درجة في اختيار الصديق" ، ومن يختر لنفسه زوجة من طبقة فوق طبقته يدع الناس إلى احتقاره.
وأجاز التلمود، كما أجاز العهد القديم والقرآن، تعدد الزوجات، ومن أقوال أحد الأحبار في هذا المعنى: "يستطيع الرجل أن يتزوج أي عدد من النساء يشاء" ولكن فقرة ثانية في مقاله هذا تحدد عدد الزوجات بأربع، وتطلب فقرة ثالثة إلى من يريد أن يتخذ له زوجة ثانية أن يطلق زوجته الأولى إذا أرادت هي الطلاق. ونظام تعدد الأزواج هذا تفترضه كذلك العادة القديمة التي يطالب اليهودي بمقتضاها أن يتزوج من أرملة أخيه بعد وفاته، وأكبر الظن أن منشأ هذه العادة لم يكن هو العطف والشفقة فحسب، بل كانت تقوم فوق ذلك على الرغبة في الإكثار من النسل في مجتمع ترتفع فيه نسبة الوفيات شأنه في ذلك شأن كل المجتمعات التي قامت في العصور القديمة والعصور الوسطى.
وبعد أن يسر الأحبار للرجل إشباع غريزته الجنسية على هذا النحو جعلوا الزنى من الجرائم التي يعاقب مرتكبها بالإعدام، وكان منهم من يقول مع المسيح إن "الإنسان قد يزني بعينيه" ، ومنهم من ذهب إلى أبعد من هذا فقال: "إن من يتطلع إلى خنصر امرأة لا أكثر قد ارتكب إثماً في قلبه" ، ولكن رب أريكا أرقى من هؤلاء وأولئك قلباً إذ يقول: "يجد الإنسان في كتاب سيئاته يوم الحشر كل شيء رآه بعينيه وأبى أن يستمتع به.
وأبيح الطلاق برضا الطرفين، فأما الزوج (الرجل) فلا يمكن أن يطلّق إلا برضاه، وأما الزوجة فيجوز للرجل أن يطلقها بغير رضاها. وطلاق الزوجة الزانية أمر واجب، كذلك يشار بطلاق الزوجة إذا ظلت عقيماً عشر سنين بعد الزواج. ولم تكن مدرسة شماي تبيح طلاق المرأة إلا إذا زنت، أما مدرسة هلل فقد أباحت للرجل أن يطلق زوجته إذا وجد فيها "شيئاً معيباً"، وكانت الغلبة في أيام التلمود لرأي هلل، وقد ذهب فيه عقيبا إلى حد بعيد فقال إن "في وسع الرجل أن يطلّق زوجته، إذا وجد امرأة أخرى أجمل منها". وكان في وسع الرجل أن يطلّق زوجته إذا عصت أوامر الشريعة اليهودية بأن سارت أمام الناس عارية الرأس، أو غزلت الخيط في الطريق العام، أو تحدثت إلى مختلف أصناف الناس أو "إذا كانت عالية الصوت أي إذا كانت تتحدث في بيتها ويستطيع جيرانها سماع ما تقول" ولم يكن عليه في هذه الأحوال أن يرد إليها بائنتها. ولم يكن هجر الرجل زوجته يوجب طلاقها منه ، وأباح بعض رجال الدين للزوجة أن تلجأ إلى المحكمة تطلب الطلاق من زوجها إذا قسا عليها، أو كان عنيناً، أو أبى أن يؤدي الواجبات الزوجية، أو لم ينفق عليها النفقة التي تليق بها ، أو كان مشوهاً أو نتناً. وكان الأحبار يحاولون تقليل الطلاق بأن يضعوا في سبيله إجراءات قانونية معقدة، ويفرضون في جميع الأحوال-إلا القليل النادر منها-استيلاء الزوجة على البائنة والمهر؛ ويقول الحاخام إلعَزَر Eleazar "إن المذبح نفسه ليذرف الدمع على من يطلق زوجة شبابه".
وجملة القول أن قوانين التلمود، بوجه عام، من وضع الرجال وأنها لذلك تحابي الذكور محاباة بلغ من قوتها أن بعثت في نفوس أحبار اليهود الفزع من قوة المرأة، وهم يلومونها، كما يلومها الآباء المسيحيون، لأنها أطفأت "روح العالم" بسبب تشوف حواء المنبعث عن ذكائها. وكانوا يرون أن المرأة "خفيفة العقل" ، وإن كانوا يقرون لها بأنها وهبت حكمة غريزية لا وجود لها في الرجل. وهم يأسفون أشد الأسف لما جبلت عليه المرأة من ثرثرة: "لقد نزلت على العالم عشرة مكاييل من الكلام؛ أخذت المرأة منها تسعة، وأخذ الرجل واحداً". ونددوا بأنهماكها في السحر وما إليه من الفنون الخفية(102)، وفي الأصباغ والكحل. ولم يكونوا يرون بأساً في أن ينفق الرجل بسخاء على ملابس زوجته، ولكنهم كانوا يطلبون إليها أن تجمل نفسها لزوجها لا لغيره من الرجال. وفي القضاء-على حد قول أحد الأحبار-"تعدل شهادة مائة امرأة شهادة رجل واحد" ؛ وكانت حقوق النساء الملكية محددة في التلمود بالقدر الذي كانت محددة به في إنجلترا في القرن الثامن عشر؛ فمكاسبهن وما يؤول إليهن من ملك لهن حق لأزواجهن(106)، ومكان المرأة هو البيت. ويقول أحد الأحبار المتفائلين إن المرأة في "عصر المسيح الثاني ستلد طفلاً في كل يوم" وإن "الرجل الذي له زوجة خبيثة لن يرى وجه جهنم" ؛ ويقول عقيبا من جهة أخرى إنه ليس أغنى من الرجل الذي له امرأة اشتهرت بأعمالها الطيبة: ويقول أحد المعلمين اليهود إن "كل شيء يصدر عن المرأة". وقد جاء في أحد الأمثال العبرية: "إن كل ما في البيت من نعم وبركات قد جاء إليه عن طريق الزوجة، ولهذا فإن من الواجب على زوجها أن يكرمها... وليحذر الرجال من أن يبكوا المرأة، فإن الله يعد دموعها". ولقد جمع ناشر غير معروف في أبهج جزء من أجزاء التلمود، وهو الرسالة الصغيرة المسماة برقي أبوت Pirke Aboh (الأصول السياسية)، حكم كبار الأحبار الذين عاشوا في القرنين السابقين لمولد المسيح والقرنين التاليين له. وكثيراً من هذه الأمثال يمتدح الحكمة وبعضها يعرفها ويحدد معناها!
قال بن زوما: من هو الحكيم؟ هو الذي يتعلم من كل إنسان... من هو القوي؟ هو الذي يخضع ميوله (الخبيثة)... من يسيطر على روما خير ممن يستولي على مدينة. من هو الغني؟ هو الذي يسر بما قسم له... من هو الكريم؟ هو الذي يكرم بني جنسه... لا تحتقر إنساناً ولا تحتقر شيئاً؛ فليس ثمة إنسان ليست له ساعته، وليس ثمة شيء ليس له مكانه... لقد نشأت طول عمري؛ بين الحكماء، ولقد وجدت أن لا شيء أحسن للإنسان من الصمت....
وقد اعتاد الكوهن إلعِزَر أن يقول: مثل من تزيد أفعاله على حكمته، كمثل شجرة كثرت فروعها وقلت جذورها، إذا هبت عليها الريح اقتلعتها وألقتها على وجهها... أما من تزد حكمته على أفعاله فمثله كمثل شجرة قلت أغصانها وكثرت جذورها لو أن رياح العالم كلها هبت عليها لما زحزحتها من مكانها.
الحياة والشريعة
ليس التلمود من التحف الفنية، ذلك بأن جمع أفكار ألف عام كاملة ووضعها في مجموعة مترابطة متناسقة عمل لا يقوى عليه حتى مائة حبر من الأحبار الصابرين. وما من شك في أن كثيراً من المقالات قد وضعت في غير موضعها من الكتاب؛ وأن عدداً من الفصول قد وضع في غير المقالات التي يجب أن يوضع فيها، وأن موضوعات تبدأ، ثم تترك، ثم تبدأ من جديد على غير قاعدة موضوعة. وليس الكتاب ثمرة تفكير بل هو التفكير نفسه، فكل الآراء المختلفة قد دونت فيه وكثيراً ما نترك النقطة المتعارضة دون أن تحل وتفسر. وكأننا قد اجتزنا خمسة عشر قرناً من الزمان لننصف إلى نقاش أشد المدارس إخلاصاً ونستمع إلى عقيبا ومإير ويهودا وهنسيا ورب في أثناء جدلهم العنيف. وإذا ما ذكرنا أننا فضوليون متطفلون، وأن هؤلاء الرجال وغيرهم قد اختطفت ألفاظهم العارضة اختطافاً من أفواههم وقذف بها في نصوص لم تكن معدة لها، ثم أرسلت تجلجل خلال القرون الطوال، إذا ذكرنا هذا استطعنا أن نعفو عما نجده في هذه الأقوال من جدل، وسفسطة، وأقاصيص غير صادقة، وتنجيم وحديث عن الجن والشياطين، وخرافات، ومعجزات، وأسرار الأعداد، وأحلام وحي، ونقاش لا آخر له يتوج نسيجاً مهلهلاً من الخيالات والأوهام، والغرور الذي يغريهم ويأسو جراحهم ويخفف عنهم آلام آمالهم الضائعة.
وإذا ما اشمأزت نفوسنا من قسوة هذه القوانين، ومن دقة هذه النظم وتدخلها فيما لا يصح أن تتدخل فيه، وما يجازي به من يخرقها من شدة وبطش، فإن من واجبنا ألا تحمل هذه المسألة محمل الجد، ذلك أن اليهود لم يدعوا قط أنهم يطيعون هذه الوصايا كلها، وأن أحبارهم كانوا يغضون أبصارهم عما يجدونه في كل صفحتين من كتابهم من ثغرات بين نصائحهم التي تدعو إلى الكمال وبين ما في الطبيعة البشرية من ضعف خفي. وفي ذلك يقول أحد الأحبار الحذرين: "لو أن إسرائيل قد حرصت الحرص الواجب على سبت واحد لجاء ابن داود من فوره". ولم يكن التلمود كتاب قوانين يطلب إلى اليهود إطاعتها جملة وتفصيلاً، بل كان سجلاً لآراء الأحبار، جمعه جامعوه ليهدوا به الناس إلى التقي على مهل، ولم تطع الجماهير غير المثقفة إلا قلة مختارة من الأوامر التي جاءت بها الشريعة.
ويهتم التلمود اهتماماً كبيراً بالشعائر الدينية، ولكن بعض هذا الاهتمام كان رد فعل من اليهود لما بذلته الكنيسة المسيحية والدولة من محاولات لإرغامهم على التخلي عن شريعتهم. ولقد كانت هذه الشعائر سمة تميزهم، ورابطة تجمع شتاتهم وتصل بين مختلف أجيالهم، وشعاراً يتحدون بع عالماً لا يعفو قط عنهم. وإنا لنجد في مواضع متفرقة من مجلدات التلمود العشرين كلمات حقد على المسيحية، ولكنها حقد على مسيحية نسيت رقة المسيح وظرفه، مسيحية اضطهدت المتمسكين بشريعة أمر المسيح أتباعه بالعمل بها، مسيحية يرى أحبار اليهود أنها حادت عن مبدأ التوحيد جوهر الدين القويم وأساسه الذي لا يتبدل. وإنا لنجد بين هذه الشعائر والطقوس المعقدة، وهذا الجدل الشائك الطويل، مئات من النصائح السديدة، والبصيرة النفسانية، تتخللها في بعض الأحيان فقرات تعيد إلى الذاكرة جلال كتاب العهد القديم أو الحنان الصوفي الذي تراه في العهد الجديد. وإن ما يمتاز به اليهودي من فكاهة شاذة غريبة الأطوار لتخفف عنه عبء هذا الدرس الطويل. انظر مثلاً إلى ما يقوله أحد أحبارهم من أن موسى دخل متخفياً إلى الحجرة التي يلقي فيها عقيبا دروسه، وجلس في الصف الأخير، ودهش من كثرة القوانين التي استنبطها المعلم الكبير من الشريعة الموسوية، والتي لم يحلم بها قط كاتبها.
ولقد ظل التلمود أربعة عشر قرناً من الزمان أساس التربية اليهودية وجوهرها. وكان الشاب العبراني ينكب عليه سبع ساعات في كل يوم مدى سبع سنين، يتلوه ويثبته في ذاكرته بلسانه وعينه؛ وكان هو الذي يكوِّن عقولهم ويشكِّل أخلاقهم بما تفرضه دراسته من نظام دقيق، وبما يستقر في عقولهم من معرفة، شأنه في هذا شأن كتابات كنفوشيوس التي كان يستظهرها الصينيون كما يستظهر اليهود التلمود. ولم تكن طريقة تعلمه مقصورة على تلاوته وتكراره، بل كانت تشمل فوق ذلك مناقشته بين المدرس والتلميذ، وبين التلميذ والتلميذ، وتطبيق القوانين القديمة على ما يستجد من الظروف، وقد أفادت هذه الطريقة حدة في الذهن، وتقوية للذاكرة، وتثبيتاً للمعلومات، ميزت اليهودي من غيره في كثير من الميادين التي تتطلب الوضوح، وتركيز الذهن، والمثابرة، والدقة، وإن كانت في الوقت نفسه قد عملت على تضييق أفق العقل اليهودي والحد من حريته. ولقد روض التلمود طبيعة اليهودي الثائرة المهتاجة، وكبح جماح نزعته الفردية، وبث فيه روح العفة والوفاء لأسرته وعشيرته؛ ولربما كان "نير الشريعة" عبئاً ثقيلاً على ذوي العقول السامية الكبيرة، ولكنها كانت السبب في نجاة اليهود بوجه عام.
وليس من المستطاع فهم التلمود إلا إذا درس في ضوء التاريخ على أنه العامل الفعّال الذي أبقى على شعب مطرود، معدم، مظلوم، يتهدده خطر التفكك التام. ولقد فعل أحبار اليهود في تشتتهم الواسع ما فعله أنبياؤهم للاحتفاظ بالروح اليهودية في الأسر البابلي. فقد كان لا بد لهم من أن يعيدوا إليهم عزتهم وكبريائهم، وأن يعملوا على أن يستقر بيتهم النظام، ويثبتوا في قلوبهم الإيمان، ويحافظوا على أخلاقهم القويمة، ويعيدوا إليهم سلامة العقول وصحة الأبدان اللتين حطمتهما المحن الطوال. وبفضل هذا التأديب الشاق، وغرس أصول التقاليد اليهودية في صدر اليهودي بعد اقتلاعها، عاد الاستقرار وعادت الوحدة، عن طريق التجوال في أطراف القارات والأحزان خلال القرون الطوال. ولقد كان التلمود على حد قول هيني Heine وطناً منتقلاً لليهود يحملونه معهم أينما ساروا. فحيثما وجد اليهود، حتى وهم جالية واجفة في أرض الغربة، كان في وسعهم أن يضعوا أنفسهم مرة أخرى في عالمهم، وأن يعيشوا مع أنبيائهم وأحبارهم، وذلك بأن يرووا عقولهم وقلوبهم من فيض الشريعة. فلا غرابة والحالة هذه إذا أحبوا هذا الكتاب الذي نراه نحن أكثر تنوعاً واختلافاً مما كتبه مائة كاتب من أمثال منتاني Montaigne. ولم يكفهم الاحتفاظ بالكتاب كله، بل احتفظوا بأجزاء صغيرة منه بحب يصل إلى درجة الجنون، وكانوا يتبادلون قراءة نتف من هذا المخطوط الضخم، وأنفقوا في القرون المتأخرة أموالاً طائلة لطبعه كاملاً، وبكوا حين كانت الملوك والبابوات، والمجالس النيابية تحرم تلاوته، أو تصادره، أو تحرقه؛ وابتهجوا حين رأوا روشلين Reuchlin وإرزامس Erasmus يدافعان عنه، وعدوه في أيامنا هذه أثمن ما تمتلكه معابدهم وبيوتهم، واتخذوه ملجأ وسلوى، وسجناً للروح اليهودية.
المجتمعات الشرقية
كان لليهود شريعة ولكن لم تكن هناك دولة ، كان لهم كيان، ولم يكن لهم وطن. ذلك أن أورشليم ظلت إلى عام 614 مدينة مسيحية ، وإلى عام 629 فارسية ، وإلى عام 637 مسيحية مرة أخرى، ثم ظلت من ذلك الوقت إلى عام 1099 حاضرة إسلامية. وفي ذلك العام الأخير حاصرها الصليبيون ، وانضم اليهود إلى المسلمين في الدفاع عنها، فلما سقطت في أيدي الصليبيين سيق من بقي فيها حياً من اليهود إلى إحدى بيعهم وأحرقوا عن آخرهم ، ولما استولى صلاح الدين على المدينة عام 1187 أعقب ذلك ازدياد سريع في عدد اليهود، واستقبل السلطان العادل أخو صلاح الدين ثلاثمائة من أحبارهم الذي فروا من إنجلترا و فرنسا في عام 1211 استقبالاً حسناً. لكن ابن نحمان لم يجد فيها بعد خمسين عاماً من ذلك الوقت إلا حفنة صغيرة من اليهود ، ذلك أن سكان بيت المقدس كانوا قد أصبحوا كلهم تقريباً مسلمين.
وظل اليهود كثيري العدد في سوريا و العراق و فارس الإسلامية رغم ما لاقوه في بعض الأحيان من الاضطهاد ورغم اعتناق عدد منهم دين الإسلام. وأضحت لهم في ربوعها حياة اقتصادية وثقافية ناشطة قوية. ولقد ظلوا في شئونهم الداخلية ، كما كانوا في عهد الملوك الساسانيين، يتمتعون بالحكم الذاتي تحت إشراف الإجزيلارك (رئيس اليهود في المهجر) ومديري المجامع الدينية. واعترف الخلفاء المسلمون بالإجزيلارك في كل من بلاد بابل. وأرمينية، والتركستان ، وفارس، و اليمن ، رئيساً لجميع اليهود فيها؛ ويقول بنيامين التطيلي إن جميع رعايا الخليفة كان يفرض عليهم أن "يقوموا واقفين في حضرة أمير الأسر، وأن يحيوه باحترام". وكان منصب الإجزيلارك وراثياً في أسرة واحدة ترجع بنسبها إلى داود، وكان سلطانه سياسياً أكثر منه روحياً، وقد أدى ما بذله من الجهود للسيطرة على رجال الدين إلى اضمحلاله ثم إلى سقوطه، وأصبح مديروا المجامع العلمية بعد عام 762 هم الذين يختارون الإجزيلارك ويسيطرون عليه.
وكانت الكليات الدينية في سورا Snra وبمبديثا Pumdeditha تخرج الزعماء الدينيين والعقليين لليهود في بلاد الإسلام، وتخرج أمثالهم بدرجة أقل لليهود في البلاد المسيحية. وحدث في عام 658 أن أخرج الخليفة مجمع سورا العلمي من اختصاص الإجزيلارك القانوني، فلما حدث هذا اتخذ رئيس المجمع لنفسه لقب جاؤن Gaon (صاحب السعادة) وابتدأ من ذلك الحين نظام الجاؤنية، وعهد الجاؤنيم في الدين والعلم البابليين. ولما ازدادت موارد كلية بميديثا وعظمت منزلتها لقربها من بغداد، اتخذ مديروها أيضاً لأنفسهم لقب جاؤن؛ وكاد اليهود في جميع أنحاء العالم فيما بين القرن السابع إلى القرن الحادي عشر يستفتون الجأنيم في المدينتين فيما يعرض لهم من مسائل التلمود القانونية، ونشأ لليهودية من أجوبتهم على هذه المسائل أدب قانوني جديد.
وحدث في الوقت الذي قامت فيه الجاؤنية انشقاق ديني فرق العالم اليهودي في الشرق وزلزلت له أركانه-أو لعل هذا الانشقاق نفسه هو الذي حتم قيام الجاؤنية في ذلك الوقت. ذلك أنه لما توفي الإجزيلارك سليمان، طالب ابن أخيه عنن بن داود بحقه في أن يخلفه في منصبه، ولكن زعماء سورا وبمبديثا طرحوا مبدأ الوراثة وراءهم ظهرياً ونصبوا حنانياً أخا عنن الأصغر إجزلاركا في مكانه. فما كان من عنن إلا أن طعن في الجاؤنين، وفر إلى فلسطين وأنشأ فيها كنيساً خاصاً به، وطالب اليهود أينما كانوا أن ينبذوا التلمود وألا يطيعوا إلا قوانين أسفار موسى الخمسة. وكان هذا العمل من جانبه عودة إلى الوضع الذي كان عليه الصدوقيون؛ وكان شبيهاً بما ينادي به بعض الشيعة في الإسلام من نبذ "السنة" النبوية واتباع القرآن وحده، وما يطالب به البروتستنت من نبذ التقاليد الكاثوليكية والعودة إلى الأناجيل. على أن عنن لم يكتف بهذا بل أخذ يعيد النظر في أسفار موسى الخمسة ويشرحها شرحاً يعد خطوة جريئة في سبيل الدراسة النقدية لنصوص الكتاب المقدس. واحتج على ما أدخله علماء التلمود من تبديل في الشريعة الموسوية وما يحاولونه في تفسيرهم وشرحهم من توفيق بينها وبين الظروف القائمة في أيامهم، وأصر على اتباع ما جاء في الأسفار الخمسة من أوامر وتنفيذها بنصها، ولهذا سمي أتباعه بالقرائين -أي "المتمسكين بالنصوص" وامتدح عنن عيسى وقال أنه رجل صالح لم يرغب في نبذ شريعة موسى المدونة، بل كل ما كان يطلبه أن ينبذ الناس قوانين الكتبة والفريسيين الشفوية. ويرى عنن أن عيسى لم يكن يرغب في وضع دين جديد، بل كان يرغب في تطهير الدين اليهودي وتدعيمه. وكثر اليهود القراءون في فلسطين، ومصر، وأسبانيا، ثم نقص في القرن لثني عشر، ولم يبق منهم الآن إلا أقلية آخذة في الانقراض في تركيا وجنوبي روسيا؛ وبلاد العرب. ونبذ القراءون في القرن التاسع ما كان ينادي به عنن من تفسير حرفي لنصوص الشريعة، وقالوا إن بعث الأجسام وما جاء في الكتاب المقدس من أوصاف جسمانية لله، يجب أن تؤخذ على سبيل المجاز، ولعلهم في قولهم هذا كانوا متأثرين بآراء المعتزلة المسلمين.
فلما فعلوا هذا عاد اليهود الربانيون إلى القول بأخذ عبارات التلمود بنصها، وقالوا إن ما ورد في الكتاب المقدس من عبارات أمثال "يد الله" وجلوس الله. يجب أن تؤخذ بمعناها الحقيقي، بل إن بعضهم قد تغالى في هذا فقدر بالدقة مقاييس جسم الله، وطول أطرافه، ولحيته. ونشأت فئة قليلة من اليهود حرة التفكير منها صبي البلخي Chivi al-Balchi كانت تنادي بأن أسفار موسى الخمسة نفسها ليست شريعة واجبة الطاعة. في هذه البيئة التي تمتاز بالرخاء الاقتصادي، والحرية الدينية، والجدل العنيف أنجبت اليهودية أول فيلسوف يهودي ذائع الصيت في العصور الوسطى.
ولد سعديا بن يوسف في قرية من قرى الفيوم في عام 892. وشب في مصر وتزوج فيها ثم هاجر إلى فلسطين في عام 915، ثم هاجر بعدئذ إلى بابل. وما من شك في أنه كان طالباً مجداً ومعلماً قديراً، لأنه عين وهو شاب في السادسة والثلاثين من عمره جاؤنا أي مديراً لكلية سوراً. وشاهد ما أدخله القراءون والمتشككة من بدع في الدين اليهودي القديم، فآلى على نفسه أن يفعل لهذا الدين ما فعله المتكلمون في الدين الإسلامي-فيبين أن هذا الدين القديم يتفق كل الاتفاق مع العق والتاريخ. وأخرج سعديا في حياته القصيرة التي لم تتجاوز خمسين عاماً مقداراً ضخماً من المؤلفات-معظمها-لا يماثلها في سجل التفكير اليهودي في العصور الوسطى إلى مؤلفات ابن ميمون. ومن هذه المؤلفات "الأجرون" وهو معجم آرامي للغة العبرية يعد أساساً للفلسفة العبرية؛ ومنها "كتاب اللغة" وهو أقدم ما عرف من كتب في نحو اللغة العبرية. وقد ظلت ترجمته العربية للعهد القديم إلى يومنا هذا الترجمة التي يستخدمها جميع اليهود الذين يتكلمون اللغة العربية، وإن شروحه لأسفار الكتاب المقدس "لتكاد تجعله" أعظم شارح للكتاب المقدس في جميع العصور"؛ ويعد "كتاب الأمانات والاعتقادات" (933) أعظم رد في الدين اليهودي على الخارجين على هذا الدين.
ويؤمن سعديا بالوحي والتواتر معاً أي بالشريعة المكتوبة وغير المكتوبة، ولكنه يؤمن أيضاً بالعقل، ويطالب بأن يثبت استناداً إلى العقل صدق الوحي والتواتر. فإذا ما تعارضت نصوص الكتاب المقدس تعارضاً صريحاً مع حكم العقل، فلنا أن نفترض أن النص المتعارض لا يقصد به أن تأخذه العقول الناضجة بحرفيته. كذلك يجب أن تؤخذ أوصاف الله الجسمانية على أنها مجاز لا حقيقية؛ ذلك أن الله ليس إنساناً يتصف بما يتصف به البشر ويدل نظام العالم وقوانينه على وجود خالق عاقل مدبر. وليس من العقل في شيء أن يظن أن الله العاقل المدبر يعجز عن أن يثيب على الفضيلة، ولكن الفضيلة، كما هو واضح، لا يثاب عليها دائماً في هذه الحياة؛ ومن ثم لا بد أن تكون هناك حياة أخرى تعوض ما يبدو في هذه الحياة الدنيا من ظلم ظاهري؛ ولعل آلام الصالحين في هذه الدنيا ليست إلا عقاباً لبعض ما ارتكبوه من ذنوب حتى يدخلوا الجنة من فورهم بعد موتهم، كما أن ما يظفر به الأشرار من نعم إنما هو مثوبة على أعمالهم الصالحة العارضة، حتى... ولكن الناس كلهم حتى الذين يقومون بأحسن الأعمال الصالحة في هذا العالم وينالون فيه أعظم الخير والسعادة يحسون في أعماق قلوبهم أن ثمة حالاً خيراً من حالهم هذه الواسعة الآمال القليلة الممتعة، وكيف يجوز لله الذي اقتضت حكمته العظيمة خلق هذا العالم العجيب أن يبعث هذه الآمال في النفس إذا لم يشأ أن تتحقق؟(9)، ولقد تأثر سعديا إلى حد ما بفقهاء الإسلام وسار على نهجهم في الشرح والإيضاح، بل إن استعار منهم في بعض الأحيان أساليب الجدل والنقاش. وقد انتشرت آراؤه في جميع أنحاء العالم اليهودية وتأثر بها ابن ميمون، وهل أدل على هذا من قول ابن ميمون: "لولا سعديا لكادت التوراة أن تختفي من الوجود".
وهنا يجب أن نقر بأن سعدياً كان رجلاً فظاً إلى حد ما، وأن نزاعه مع الإجزيلارك داود بن زكاي قد أضر بيهود بابل. وكانت نتيجة هذا النزاع أن أعلن داود في عام 930 حرمان سعديا، وأن أعلن سعديا حرمان داود. ولما مات داود في عام 940 نَصَّب سعديا إجزيلاركاً جديداً، ولكن المسلمين قتلوا هذا الإجزيلارك لأنه طعن في النبي محمد. فما كان من سعديا إلا أن عيّن ابن القتيل خلفاً، وقُتل هذا الشاب أيضاً؛ وحينئذ قرر اليهود بعد أن فت في عضدهم على هذا النحو أن يبقوا هذا المنصب شاغراً، وبذلك انتهى عهد الإجزيلاركية البابلية الذي دام سبعة قرون. وكان تفكك الخلافة العباسية في بغداد وقيام دوق إسلامية مستقلة في مصر، وشمالي أفريقية، وأسبانيا سبباً في ضعف الروابط بين يهود آسية وأفريقية وأوربا وأصيب يهود بابل بما أصيب به الإسلام في الشرق من ضعف اقتصادي بعد القرن العاشر الميلادي، فأغلقت كلية سورا أبوابها في عام 1034 وحذت حذوها بمبديثا بعد أربع سنين، وانتهى عهد الجاؤنية في عام 1040 ؛ وزادت الحروب الصليبية الهوة بين يهود بابل ويهود مصر، وأوربا، ولما خرب المغول بغداد في عام 1228 كادت الجالية اليهودية البابلية أن تختفي من صفحات التاريخ.
وكان كثيرون من يهود الشرق قد هاجروا قبل هذه الكوارث إلى أقاصي آسية الشرقية، وبلاد العرب، ومصر، وشمالي أفريقية وأوربا؛ فكان في سيلان 23.000 عبراني في عام 1165 ، وبقيت في بلاد العرب عدة جاليات يهودية بعد أيام النبي؛ ولما فتح عمرو بن العاص مصر في عام 641 كتب إلى الخليفة يقول إن في الإسكندرية أربعة آلاف من اليهود "أهل الذمة". ولما اتسعت مدينة القاهرة ازداد عدد من فيها من اليهود أصحاب العقيدة القديمة والقرائين. وكان يهود مصر يستمتعون بالحكم الذاتي في شئونهم الداخلية بزعامة النجيد أو أمير اليهود، وازدادت ثروتهم من الأعمال التجارية وارتفعوا إلى المناصب العالية في حكومات الدول الإسلامية. وتقول إحدى الروايات إن أربعة من أحبار اليهود أبحروا على ظهر إحدى السفن من باري Bari في إيطاليا ، ولكن أحد أمراء البحر الأندلسيين المسلمين أسر سفينتهم وباعهم بيع الرقيق، فبيع الحبر موسى وابنه حنوخ في قرطبة، وبيع سحرية في الإسكندرية، وبيع الحبر هو سيل في القيروان. ثم اعتنق كل واحد من هؤلاء الأحبار، كما تقول الرواية، وأنشأ في المدينة التي بيع فيها مجمعاً علمياً. والشائع على الألسنة، وإن لم يكن هذا مؤكداً، أنهم كانوا من علماء سورا؛ وأياً كانت فقد نقلوا العلم من يهود الشرق إلى الغرب؛ وبينما كانت اليهودية في آسية آخذة في الضعف بدأت أيام عزها وسعادتها في مصر و أسبانيا.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الجماعات اليهودية في أوربا
اتخذ اليهود طريقهم إلى روسيا في العصور الوسطى من بابل و فارس مجتازين ما وراء جيحون والقوقاز، وإلى ساحل البحر الأسود من آسية الصغرى مجتازين القسطنطينية. وظل اليهود في تلك العاصمة يستمتعون بالرخاء النكد من القرن الثامن إلى القرن الثاني عشر. وكان في بلاد اليونان جماعات يهودية كبيرة وبخاصة في طيبة حيث كانت لمنسوجاتهم الحريرية شهرة عظيمة. وهاجر اليهود شمالاً إلى بلاد البلقان مجتازين تساليا وتراقية ومقدونية، ثم ساروا بمحاذاة نهر الدانوب إلى بلاد المجر. وجاءت حفنة من التجار العبرانيين من ألمانيا إلى بولندة في القرن العاشر لأن اليهود كانوا في ألمانيا من قبل ميلاد المسيح. فكان في متز Metz، واسبير Speyer، ومينز Mainz، وورمز Worms، واسترسبورج Strassbourg، وفرنكفورت Fraokfort، وكولوني جاليات يهودية كبيرة في القرن التاسع، وإن كانت هذه الجاليات قد شغلتها التجارة وما تستلزمه من كثرة الترحال فلم يكن لها شأن كبير في تاريخ اليهود الثقافي. ومع هذا فقد أنشأ جرشوم بن يهودا (960-1027) مجمعاً علمياً للأحبار في مينز وكتب بالعبرانية شرحاً للتلمود، وبلغ من سلطانه أن كان يهود ألمانيا يستفتونه فيما يعرض لهم من مسائل في شريعة التلمود بدل أن يستفتوا في ذلك جأونيم بابل. وكان في إنجلترا يهود في عام 691 ، وجاء إليهم عدد آخر كبير منهم مع وليم الفاتح Willam the Conquelor، وبسط عليهم النورمان الفاتحون في أول الأمر حمايتهم لما كانوا يمدونهم به من رؤوس الأموال وما كانوا يقومون به من جباية الإيراد. وكانت جماعاتهم المقيمة في لندن، وتورتش Norwch، ويورك، وغيرها من المراكز الإنجليزية خارجة عن اختصاص ولاة الأمور المحليين في شئونها القانونية، فكانت لا تخضع إلا للملوك أنفسهم. ووسعت هذه العزلة القضائية الهوة بين المسيحيين واليهود، وكانت سبباً من أسباب المذابح المدبرة التي حدثت في القرن الثاني عشر.
وكان في غالة تجار يهود من عهد يوليوس قيصر، وقبل أن يحل عام 600 بعد الميلاد وجدت جاليات يهودية في جميع المدن الكبرى في غالة؛ واضطهدهم الملوك المروفنجيون بوحشية، وأمرهم كلبريك Chilperic أن يعتنقوا الدين المسيحي على بكرة أبيهم وإلا فقأ أعينهم (581) ، أما شارلمان فإنه بسط عليهم حمايته لأنه وجد فيهم زراعاً، وصناعاً، وأطباء، ورجال مال نافعين، واختار يهوديا ليكون طبيبه الخاص، وإن كان قد أبقى على القوانين التي تحرم اليهود من بعض الحقوق التي يتمتع بها غيرهم. وتقول إحدى الروايات المشكوك في صحتها أنه استقدم في عام 787 أسرة فلونيموس Kalonymos من لكا Lucea إلى مينز ليشجع الدراسات اليهودية في دول الفرنجة، ثم أرسل في عام 797 يهودياً مترجماً أو مفسراً مع بعثة سياسية إلى هارون الرشيد. وكان لويس التقي Leuis the Pieus يميل إلى اليهود لعملهم في تنشيط التجارة؛ وعين موظفاً خاصاً للدفاع عن حقوقهم، واستمتع اليهود في فرنسا في القرنين التاسع والعاشر بقدر من الرخاء والطمأنينة لم يستمتعوا به بعدئذ قبل أيام الثورة الفرنسية؛ وذلك رغم ما كان يذاع ضدهم من الأقاصيص، وما يفرض عليهم من القيود الرومانية، وما يصيبهم أحياناً من الاضطهاد القليل وكانت في إيطاليا من أقصاها إلى أقصاها جاليات يهودية منتشرة من تراني Trani إلى البندقية وميلان، وكان اليهود كثيرين في بدوا بنوع خاص، ولعلهم كان لهم أثر في نشر فلسفة ابن رشد في جامعتها. وكان في سالرنو Salerno، حيث أنشئت في البلاد المسيحية اللاتينية أولى مدارس الطب في العصور الوسطى، ستمائة يهودي. ومنهم عدد من مشهوري الأطباء، وكان في بلاد فردريك الثاني في فجيا Foggia طائفة من العلماء اليهود، وعين البابا الكسندر الثالث (1159-1181) عدداً من اليهود في المناصب الكبرى في بيته ، ولكن فردريك اشترك مع البابا جريجوري التاسع في اتخاذ إجراءات ظالمة ضد يهود إيطاليا.
وكان يهود أسبانيا يلقبون أنفسهم سفرديم Sephardim، ويرجعون بأصولهم إلى قبيلة يهوذا الملكية ؛ ولما اعتنق الملك ريكارد Recared الدين المسيحي الأصيل، انضمت حكومة القوط الغربيين إلى رجال الدين الأقوياء أتباع الكنيسة الأسبانية في مضايقة اليهود وتنغيص حياتهم عليهم، فحرمت عليهم المناصب العامة، ومنعوا بالزواج من المسيحيات أو اقتناء أرقاء مسيحيين. وأمر الملك سيزبوت Sisebut جميع اليهود أن يعتنقوا المسيحية أو أن يخرجوا من البلاد 613 ، وألغى الملك الذي خلفه على العرش هذا الأمر، ولكن مجلس طليطلة الذي عقد في عام 633 أصدر قراراً ينص على أن اليهود الذين عمدوا ثم عادوا إلى الدين اليهودي يجب أن يفصلوا عن أبنائهم، وأن يباعوا أرقاء. وأعاد الملك شنتيلا Chtntla العمل بمرسوم سيزبوت 635 ؛ وحرم الملك إجيكا Egica على اليهود امتلاك الأراضي كما حرم على عمل مالي وتجاري بين أي مسيحي ويهودي 693. وكانت نتيجة هذا أن ساعد اليهود العرب حين جاءوا أسبانيا فاتحين في كل خطوة من خطوات الفتح.
وأراد الفاتحون أن يعمروا البلاد فدعوا إلى الهجرة إليها، وقدم إليها فيمن قدم خمسون ألف يهودي من آسيا و أفريقيا ، وكاد سكان بعض المدن مثل أليسانة أن يكونوا كلهم من اليهود. ولما أن تحرر اليهود في أسبانيا الإسلامية من القيود المفروضة على نشاطهم الاقتصادي انتشروا في جميع ميادين الزراعة، والصناعة، والمال، والمناصب العامة، ولبسوا ثياب العرب، وتكلموا بلغتهم، واتبعوا عاداتهم، فلبسوا العمامة والأثواب الحريرية الفضفاضة، وركبوا العربات حتى أصبح من العسير تمييزهم من بني عمومتهم الساميين. واستخدم عدد من اليهود أطباء في بلاط الخلفاء والأمراء وعين أحد هؤلاء الأطباء مستشاراً لأعظم خليفة من خلفاء قرطبة.
فقد كان حسداي بن شبروط (915-970) بالنسبة لعبد الرحمن الثالث ما كانه نظام الملك في القرن التالي لملك شاه. وقد ولد حسداي في أسرة ابن عزرا المثرية المثقفة؛ وعلمه أبوه اللغات العبرية، و العربية ، و اللاتينية ، ودرس الطب، وغيره من العلوم في قرطبة، وداوى الخليفة من أمراضه، وأظهر من واسع المعرفة وعظيم الحكمة في الأمور السياسية ما جعل الخليفة يعينه في الهيئة الدبلوماسية للدولة، ولما يتجاوز الخامسة والعشرين من عمره كما يلوح. ثم عهدت إليه تباعاً أعمال أخرى ذات تبعات متزايدة في حياة الدولة المالية والتجارية. على أنه لم يكن له لقب رسمي لأن الخليفة تردد في منحه رسمياً لقب وزير خشية أن يثير عليه النفوس. ولكن حسداي قام بمهام منصبه الكثيرة بكياسة أكسبته محبه العرب، واليهود، والمسيحيين على السواء، وقد شجع العلوم والآداب، ومنح الطلاب الهبات المالية والكتب بلا ثمن، وجمع حوله ندوة من الشعراء، والعلماء، والفلاسفة، فلما مات تنافس المسلمون واليهود في تكريم ذكراه.
وكان ثمة رجال غيره في أنحاء أخرى من أسبانيا الإسلامية وإن لم يبلغوا ما بلغه. ففي أشبيلية دعا المعتمد إلى بلاطه إسحق بن بروك العالم والفلكي، ومنحه لقب أمير، وجعله حاخاماً أكبر لكل المجامع اليهودية فيها؛ وفي غرناطة نافس شمويل هلوي ابن نجدلا Samuel Nalevi idn Naghdela حسداي ابن شبروط في سلطانه وحكمته وفاقه في عمله. وقد ولد شمويل في قرطبة عام 993 ونشأ فيها، وجمع بين دراسة التلمود والأدب العربي، وجمع بين هذين وبين الاتجار في التوابل. ولما أن سقطت قرطبة في أيدي البربر، انتقل إلى مالقة، وفيها زاد دخله القليل بكتابة العروض إلى ملك غرناطة. وأعجب وزير الملك بما كانت عليه هذه العروض من جمال الخط وحسب الأسلوب فزار شمويل، وصحبته إلى غرناطة، وأسكنه في قصر الحمراء، وجعله أمين سره. وما لبث شمويل أن أصبح أيضاً مستشاره، وكان مما قاله الوزير نفسه أنه إذا أشار شمويل بشيء فإن صوت الله يسمع فيما يشير به. وأوصى الوزير وهو على فراش الموت أن يخلفه شمويل، وبذلك أصبح شمويل في عام 1027 اليهودي الوحيد الذي شغل منصب وزير في دولة إسلامية وحظي بهذا اللقب. ومما يسر هذا الأمر في غرناطة أكثر منه في أي بلد آخر أن نصف سكان هذه المدينة في القرن الحادي عشر كانوا يهوداً. وسرعان ما رحب العرب بهذا الاختيار، لأن الدولة الصغيرة ازدهرت في عهد شمويل من النواحي المالية، والسياسية، والثقافية. وكان هو نفسه عالماً، وشاعراً، ونابغة في الفلك، والرياضة، واللغات، يعرف سبعاً منها، وقد ألف عشرين رسالة في النحو (معظمها بالعبرية) وعدة مجلدات في الشعر والفلسفة، ومقدمة للتلمود، ومجموعة من الأدب العبري. وكان يقتسم ماله مع غيره من الشعراء، وأنجد الشاعر والفيلسوف ابن جبيرول، وأمد بالمال طائفة من شباب الطلاّب، وأعان الجماعات اليهودية في قارات ثلاث وكان وهو وزير الملك حاخاماً لليهود يحاضر عن التلمود. ولقبه بنو ملته-اعترافاً منهم بفضله-بالنجيد-الأمير (في إسرائيل). ولما توفي عام 1055 خلفه في الوزارة، والنجادة ابنه يوسف بن نجدلا.
وكانت هذه القرون الثلاثة-العاشر، والحادي عشر، والثاني عشر، هي العصر الذهبي ليهود أسبانيا، وأسعد عصور التاريخ العبري الوسيط، وأعظمها ثمرة. ولما أن افتدى موسى بن شنوك (المتوفي عام 975 وأحد المهاجرين من باري) من الأسر في قرطبة ، أنشأ فيها بمجموعة حسداي مجمعاً علمياً، ما لبث أن أصبحت له الزعامة الفعلية على يهود العالم كله. وافتتحت مجامع مثله في أليسانة، وطليطلة، وبرشلونة، وغرناطة...، وبينما كانت المدارس اليهودية في الشرق تقصر نشاطها على التعليم الديني، كانت هذه المدارس الأسبانية تعلم فيما تعلمه الأدب. والموسيقى، والرياضيات، والهيئة، والطب، والفلسفة(21). وبفضل هذا التعليم نالت الطبقات العليا من يهود أسبانيا في ذلك الوقت سعة وعمقاً في الثقافة والظرف لم ينلهما إلا معاصروهم من المسلمين، والبيزنطيين، والصينيين. وكان مما يسربل الرجل المؤثر أو صاحت المركز السياسي بالعار ألا يلم بالتاريخ، والعلوم الطبيعية، والفلسفة، والشعر(22). ونشأت في ذلك الوقت أرستقراطية يهودية تزدان بما فيها من النساء الحسان، ولعلها قد أفرطت في الاعتداء بتفوقها على غيرها، ولكن كان يقابل هذا الاعتداد ويخفف من وقعه اعتقادها أن شرف المحتد وكثرة الثراء يفرضان على صاحبهما واجبات من السخاء والفضل. ويمكننا أن نؤرخ بداية تدهور يهود أسبانيا من سقوط يوسف بن نجدلا. ذلك أنه كان يخدم الملك بكفاية لا تكاد تقل عن كفاية أبيه، ولكنه لم يكن له كما كان لأبيه من تواضع وكياسة جعلتا سكان البلاد-ونصفهم من المسلمين الأندلسيين-يرتضون أن يتولى أمورهم يهودي. من ذلك أنه جمع السلطة كلها في يده، وتشبه بالملك في لباسه، وسخر من القرآن، وتحدث الناس بأنه لا يؤمن بالله. ولهذا ثار العرب والبربر في عام 1066 وصلبوا يوسف، وذبحوا أربعة آلاف من يهود غرناطة، ونهبوا بيوتهم، وأرغم الباقون من اليهود على بيع أراضيهم ومغادرة البلاد. وجاء المرابطون من أفريقية بعد عشرين عاماً من ذلك الوقت متأججة صدورهم بالحماسة الدينية ومتمسكين بأصول السنة، وانتهى بقدومهم عصر أسبانيا الإسلامية الزاهر الطويل الأمد. ونادى أحد رجال الدين من المسلمين أن اليهود قد وعدوا النبي بأن يعتنقوا الإسلام بعد خمسمائة عام من الهجرة، إذا لم يظهر في ذلك الوقت مسيحهم المنقذ المنتظر، وأن هذه الأعوام الخمسمائة تنتهي بالحساب الهجري في عام 1107، وطلب الأمير يوسف إلى جميع يهود أسبانيا أن يعتنقوا الإسلام ، ولكنه أعفاهم من هذا الأمر حين أدوا لبيت المال مبالغ طائلة. ولما خلف الموحدون المرابطين في حكم مراكش وبلاد لندلس الإسلامية 1148 ، خيروا اليهود والمسيحيين كما خير الملك سيزبوت اليهود قبل خمسمائة وخمسة وثلاثين عاماً من ذلك الوقت بين الارتداد عن دينهم أو الخروج من البلاد. وتظاهر الكثيرون من اليهود باعتناق الإسلام، وهاجر كثيرون منهم مع المسيحيين إلى شمالي أسبانيا.
وهنا وجد اليهود في بادئ الأمر من التسامح العظيم ما لا يقل جلالاً عما ظلموا يلقونه مدى أربعة قرون تحت حكم المسلمين. وأحسن الفنسو السادس والسابع ملكا قشتالة (الأذفونش) معاملة اليهود، وجعلاهم هم والمسيحيين سواء أمام القانون، ولما قامت حركة مناهضة للسامية 1107 في طليطلة، حيث كان 72.000 يهودي، قمعها بصرامة(24). وحدث أرغونة مثل هذا التآلف بين الديانتين، الأم والابنة، وبلغ من هذا التآلف أن دعا الملك جيمس الأول اليهود أن ستوطنوا ميورقة، وقطلونية، وبلنسية، وكثيراً ما كان يمنح المستوطنين اليهود بيوتاً وأرضين من غير ثمن. وكانت لهم في برشلونة السيطرة على التجارة في القرن الثاني عشر، كما كان لهم نصف أراضيها الزراعية. نعم إن يهود أسبانيا قد فرضت عليهم ضرائب باهظة، ولكنهم مع ذلك أثروا، واستمتعوا فيها بالاستقلال في شئونهم الداخلية. وكانت التجارة تتبادل بحرية بين المسيحيين واليهود والمسلمين الأندلسيين، وكان بنو الأديان الثلاثة يتبادلون الهدايا في الأعياد، وكان بعض الملوك من إلى حين يشترك بالمال في بناء المعابد اليهودية ، وكان في وسع الإنسان أن يجد بين عامي 1085 و 1492 يهودا يشغلون المناصب الكبرى في دول أسبانيا المسيحية منهم القائمون على شئون المال ومنهم الدبلوماسيين، ومنهم الوزراء أحياناً. واشترك رجال الدين المسيحيون في القرنين الثاني عشر والثالث عشر في هذه الألفة المسيحية.
وكانت بداية عدم التسامح الديني بين اليهود أنفسهم. ذلك أن يهودا ابن عزرا المتولي شئون قصر الفنسو السابع ملك ليون وقشتالة وجه في عام 1149 قوة حكومة ملكية ضد اليهود القرائين في طليطلة. ولسنا نعرف تفاصيل ما حدث وقتئذ، ولكن اليهود القرائين الأسبان الذي كانوا إلى ذلك الحين طائفة كبيرة لم يعد يسمع لهم خبر. ودخل بعض الصليبيين أسبانيا في عام 1212 ليساعدوا أهلها على طرد المسلمين منها، وكانوا في أغلب الأحوال يحسنون معاملة اليهود؛ ولما أن اعتدت طائفة منهم على يهود طليطلة وقتلت كثيرين منهم، هب أهل المدينة المسيحيون للدفاع عن مواطنيهم، ووضعوا حداً لاضطهادهم ؛ وأدخل الفنسو العاشر ملك قشتالة بعض المواد المجحفة باليهود في قانونه الصادر عام 1265 ، ولكن هذا القانون لم يطبق حتى عام 1348 ، وكان ألفنسو في ذلك الوقت يستخدم طبيباً وخازناً لبيت المال يهودياً، واهدى إلى يهود إشبيلية ثلاثة من مساجد المسلمين ليجعلوها معابد لهم. واستمتع بما خلعه العلماء اليهود والمسلمون على حكمه اللطيف من مجد. ولما احتاجت مغامرات بدرو الثالث Pedro ملك أرغونة إلى فرض الضرائب الفادحة على رعاياه، كان وزير ماليته وعدد آخر من موظفيه يهودا، ولما ثار أعيان البلاد ومدنها على الملكية، اضطر الملك إلى إقصاء أعوانه اليهود عن مناصب الدولة، وتوقيع قرار أصدره مجلس الكورتير Cortes (1283) بألا يعين بعد ذلك الوقت أي يهودي في المناصب الحكومية.
وكانت خاتمة عهد التسامح الديني حين أصدر مجلس زمورا Zmora الديني 1313 قراراً بأن يلبس اليهود شارة تميزهم من غيرهم، وألا يختلط اليهود بالمسيحيين، ويحرم على المسيحيين استخدام أطباء من اليهود وعلى اليهود أن يكون لهم خدم مسيحيون.
الحياة اليهودية في البلاد المسيحية
الحكومة
لم تحتم المدن المسيحية في العصور الوسطى-إذا استثنينا بالرم وقليلاً من المدن الأسبانية-أن يعيش من فيها من اليهود منعزلين عن سائر السكان. لكن اليهود كانوا في العادة يعيشون في عزلة اختيارية عن غيرهم من الأهلين لتيسر لهم هذه العزلة حياتهم الاجتماعية وسلامتهم الجسمية ووحدتهم الدينية. وكان كنيسهم مركز الحي اليهودي الجغرافي، والاجتماعي، والاقتصادي، يجتذب إليه معظم مساكن اليهود، ولهذا ازدحمت المساكن حوله ازدحاماً كبيراً، وأضر ذلك الازدحام بالصحة العامة والخاصة. وكانت الأحياء اليهودية في أسبانيا تحتوي على مساكن جميلة وعمارات كما تحتوي على أكواخ قذرة، أما في غيرها من بلاد أوربا فكادت المساكن أن تكون أحياء قذرة وبيئة مزدحمة بالسكان.
وكانت الجماعات اليهودية طوائف منعزلة شيه ديمقراطية وسط عالم ملكي مطلق، إذا استثنينا من هذا التعميم ما للثراء من أثر في الانتخابات وفي الاختيار للوظائف في جميع أنحاء العالم. وكان دافعوا الضرائب من الجماعات اليهودية يختارون أحبار الكنيس وموظفيه. وكانت فئة قليلة العدد من الكبار المنتخبين تكون بيت الدين أو المحكمة الشعبية، وهذه المحكمة هي التي كانت تجبي الضرائب، وتحدد الأثمان، وتتولى القضاء، وتصدره القرارات الخاصة بالطعام، والرقص، والأخلاق، والملبس، ولم تكن هذه القرارات تطاع على الدوام. وكان من حقها أن تحاكم من يعتدون على القانون اليهودي من اليهود أنفسهم، وكان لها موظفون ينفذون أوامرها، وكانت العقوبات التي توقعها تختلف من الغرامات إلى الحرمان الديني أو التقي، وقلّما كان الحكم بالإعدام من اختصاص بيت الدين أو كان من العقوبات التي توقعها، وكانت المحكمة اليهودية تستعيض عن هذا الإعدام بالحرمان التام؛ يصدر في احتفال فخم مرعب توجه فيه التهم، وتصب فيه اللعنات، وتطفأ فيه الشموع واحدة بعد واحدة رمزاً إلى موت المجرم الروحي. وكان اليهود يسرفون في استخدام الحرمان، كما كان يفرط فيه المسيحيون، ولهذا فقدت هذه العقوبة ما كان لها من رهبة وتأثير. وكان رؤساء اليهود الدينيون-كما كان رؤساء الكنيسة المسيحيون-يضطهدون الملاحدة، ويحرمونهم من حماية القانون، ويحرقون كتبهم في حالات نادرة.
ولم تكن الجماعات اليهودية في الأحوال العادية خاضعة للسلطات المحلية وكان سيدها الوحيد هو الملك، تؤدي إليه الماء بسخاء لتبتاع منه الميثاق الذي يحمي حقوقها الدينية والاقتصادية؛ وكان فيما بعد تؤدي المال إلى الحكومات المحلية المحررة لتؤيد استقلال اليهود الذاتي بشئونهم الداخلية. إلا أن اليهود مع ذلك، كانوا يخضعون لقوانين الدولة، وجعلوا طاعة هذه القوانين مبدأ من مبادئهم الواجبة الطاعة، وقد ورد في التلمود أن "قانون البلد شريعة" ، وتقول إحدى فقراته: "صلوا لسلامة الحكومة، فلولا خوف الناس منها لابتلع بعضهم بعضاً".
وكانت الدولة تجبي من اليهود "الفرضة" أو ضريبة الرءوس، وعوائد الأملاك، وكانت تصل أحياناً إلى 33% من قيمتها، وضرائب على اللحم، والخمور، والحلي، والواردات، والصادرات، فضلاً عن التبرعات "الاختيارية" للمساعدة على تمويل الحروب، أو تتويج الملوك، أو "مقدمهم" أو رحلاتهم. وكان اليهود الإنجليز البالغ عددهم في القرن الثاني عشر 1slash4 % في المائة من السكان يؤدون للدولة 8% من الضرائب العامة. وقد أدوا هم ربع ما جمع من المال لحرب رتشارد الأول الصليبية، وأدوا فيما بينهم 5000 مارك ليفتدوه من أسر الألمان وهو ثلاثة أمثال ما أدته مدينة لندن. كذلك كانت الهيئات اليهودية تفرض ضرائب أخرى على اليهود، كما كان يطلب إليهم من حين إلى حين صدقات وإعانات للتعليم ولمساعد اليهود المضطهدين في فلسطين. وكان الملك في أي وقت من الأوقات يصادر أملاك "يهوده" بعضها أو كلها لسبب أو لغير سبب؛ ونقول يهوده لأنهم كانوا جميعاً بمقتضى قانون الإقطاع "رجال" الملك. وكان الملك إذا مات ينتهي العهد الذي قطعه بحماية اليهود، ولم يكن من يخلفه على العرش يرضى بأن يجدد العهد إلا إذا قدم إليه قدر كبير من المال، قد يبلغ في بعض الأحيان ثلث جميع ما يمتلكه اليهود في الدولة(39). من ذلك ما فعله ألبرخت الثالث Albrecht lll مارجريف برندبرج Margrave of Brander burg في عام 1463 إذ أعلن أن كل ملك ألماني جديد "يجوز له، عملاً بالسنن القديمة، إما أن يحرق جميع اليهود، أو يظهر لهم رحمته، فينقذ حياتهم، ويأخذ ثلث أملاكهم" ولقد لخص براكتن Bracton كبير المشترعين اليهود في القرن الثالث عشر هذه النقطة بعبارة موجزة فقال: "ليس من حق اليهودي أن يكون له ملك خاص، لأن ما يحصل عليه أياً كان نوعه لا يحصل عليه لنفسه بل للمِلك".
الشئون الاقتصادية
وكانت هناك فضلاً عن هذه المتاعب السياسية قيود اقتصادية. نعم إن اليهود لم يكونوا يمنعون بحكم القانون من تملك العقار، ولم يكونوا يمنعون من تملكه بوجه عام، وقد كانوا في أوقات مختلفة في العصور الوسطى يمتلكون أراضي واسعة في بلاد الأندلس الإسلامية وأسبانيا المسيحية، وفي صقلية، وسيليزيا، وبولندة، وإنجلترا، وفرنسا(42)؛ ولكن ظروف الحياة جعلت هذا التملك أمراً غير ميسر من الوجهة العلمية يزداد صعوبة على مر الأيام. ذلك أن اليهودي، وقد حرمت عليه الشريعة المسيحية أن يستأجر أرقاء مسيحيين، وحرمت عليه الشريعة اليهودية أن يستأجر أرقاء من اليهود، لم يكن أمامه إلا أن يفلح أرضه باستئجار عمال أحرار يصعب الحصول عليهم ويتطلب الاحتفاظ بهم نفقات طائلة. يضاف إلى هذا أن الشريعة اليهودية تحرم على اليهودي أن يعمل في يوم السبت، وأن الشريعة المسيحية كانت عادة تمنعه عن العمل في يوم الأحد، وكان هذا التعطل عقبة كبيرة في سبيله؛ وكانت العادات أو القوانين الإقطاعية تجعل من المستحيل على اليهودي أن يكون له منزلة في النظام الاقتصادي لأن هذه المنزلة تتطلب منه أن يقسم يمين الولاء للمسيحية، وأن يقوم بالخدمة العسكرية، مع أن شرائع الدول المسيحية كلها تقريباً تحرم على اليهود حمل السلاح. ولما حكم القوط الغربيون أسبانيا ألغى الملك سيزبوت جميع ما منحه أسلافه من الأرض لليهود، "وأمم" الملك إيجيكا جميع أملاك اليهود التي كانت ملكاً للمسيحيين في أي وقت من الأوقات، وفي تمام 1293 حرم مجلس الكورتيز في بلد الوليد بيع الأراضي لليهود؛ وفوق هذا كله فإن ما كان يتعرض له اليهود في كل وقت من الأوقات من احتمال طردهم من البلاد، أو مهاجمتهم، قد أقنعهم بعد القرن التاسع أن يتجنبوا امتلاك الأرضين أو العيش في الريف. كل هذه الصعاب ثبطت همة اليهود في الاشتغال بالزراعة ومالت بهم إلى حياة الحضر، وإلى العمل في الصناعة والتجارة والشئون المالية.
ونشط اليهود في الشرق الأدنى وجنوبي أوربا في الصناعة، والحق أن اليهود كانوا في معظم الأحوال هم الذين أدخلوا الفن الصناعي الراقي من بلاد الإسلام إلى بيزنطية وإلى البلاد الغربية، ولقد وجد بنيامين التطيلي Beniamin of Tudela مئات من صانعي الزجاج في إنطاكية، وصور؛ واشتهر اليهود في مصر وبلاد اليونان بجمال منسوجاتهم المصبوغة والمطرزة وتفوقها على سائر المنسوجات من نوعها، وكان فردريك الثاني في القرن الثالث عشر لا بعد يستقدم إلى بلاده الصناع اليهود ليشرفوا على صناعة نسيج الحرير التابعة للدولة في صقلية. وكان اليهود في تلك الجزيرة وفي غيرها من البلاد يشتغلون في الصناعات المعدنية وبخاصة في الصباغة وصناعة الحلي، وظلوا يعملون في مناجم القصدير في كورونوول إلى عام 1290. وانتظم الصناع العبرانيون في أوربا الجنوبية في طوائف للحروف قوية، وكانوا ينافسون الصناع المسيحيين منافسة شديدة، أما في أوربا الشمالية فقد احتكرت طوائف أرباب الحرف المسيحية كثيراً من الصناعات؛ وأخذت الدول المختلفة واحدة في إثر واحدة تحرم على اليهود الاشتغال حدادين، ونجارين، وخياطين، وحذائين، وطحانين، وخبازين، وأطباء؛ كما حرمت عليهم بيع الخمور، والدقيق، والزبد، والزيت في الأسواق ، وابتياع مساكن لأنفسهم في أي مكان خارج عن الأحياء اليهودية.
وإزاء هذه القيود الثقيلة لجأ اليهود إلى التجارة وكان رب Rab ، العالم التلمودي البابلي، قد وضع لبني ملته شعاراً يدل على ثاقب فكره: "تاجر بمائة فلورين تحصل على لحم وخمر؛ أما إن استغلت هذا القدر نفسه في الزراعة فأكبر ما تحصل عليه هو الخبز والملح". وكان البائع اليهودي الجائل معروفاً في كل مدينة وبلدة، والتاجر اليهودي معروفاً في كل سوق ومولد؛ وكانت التجارة الدولية عملاً تخصصوا فيه، وكادوا أن يحتكروه قبل القرن الحادي عشر، فكانت أحمالهم، وقوافلهم، وسفائنهم تجتاز الصحراوات، والجبال، والبحار، وكانوا في معظم الحالات يصبحون بضائعهم. وكانوا هم حلقة الاتصال التجاري بين بلاد المسيحية والإسلام، وبين أوربا وآسية، وبين الصقالبة والدول الغربية؛ وكانوا هم القائمين بمعظم تجارة الرقيق ؛ وكان يعينهم على النجاح في التجارة مهارتهم في تعلم اللغات، وقدرة الجماعات اليهودية البعيدة بعضها عن بعض على فهم اللغة العربية، وتشابه عادات اليهود وقوانينهم، واستضافة الحي اليهودي في كل مدينة لأي يهودي غريب. ولهذا استطاع بنيامين التطيلي أن يجتاز نصف العالم وأن يجد له أينما حل موطناً. ويحدثنا ابن خرداذبة صاحب البريد في الدولة العباسية عام 870 في كتابه المسالك والممالك عن التجار اليهود الذين يتكلمون اللغات الفارسية، واليونانية، والعربية، والفرنجية، والإسبانية، والصقلية، ويصف المسالك البرية والبحرية التي ينتقلون بها من أسبانيا وإيطاليا إلى مصر ، و الهند ، و الصين. وكان هؤلاء التجار يحملون الخصيان، والعبيد، والحرير المطرز، والفراء، والسيوف إلى بلاد الشرق الأقصى، ويعودون منها بالمسك، والند، والكافور، والتوابل، والمنسوجات الحريرية. ثم كان استيلاء الصليبيين على بيت المقدس، واستيلاء أساطيل البندقية وجنوى على بلاد البحر المتوسط، فأصبحت للتجار الإيطاليين ميزة على اليهود، وقضى في القرن الحادي عشر على زعامة اليهودي التجارية. وكانت مدينة البندقية قد حرمت حتى قبل الحروب الصليبية نقل التجار اليهود على سفنها، ولم يمض بعد ذلك إلا قليل من الوقت حتى أغلقت عصبة المدن الهلسية The Hansatic League موانيها الواقعة على بحر الشمال والبحر البلطي في وجه التجارة اليهودية ، وقبل أن يحل القرن الثاني عشر أضحى الجزء الأكبر من التجارة اليهودية تجارة محلية، وكانت هذه التجارة حتى في هذا المجال الضيق تحددها القوانين التي تحرم على اليهود أن يبيعوا عدة أنواع من السلع(51). فلم يكن لهم بد من العودة إلى شئون المال. ذلك أنهم وجدوا أنفسهم في بيئة معادية لهم معرضين لأن يتلف عنف الجماهير أملاكهم الثابتة، أو أن يصادرها الملوك الجشعون، فأرغمتهم هذه الظروف على أن يجعلوا مدخراتهم من النوع السائل السهل التحرك؛ فعمدوا أولاً غلى ذلك العمل السهل وهو مبادلة النقد، ثم انتقلوا منه إلى تلقي المال لاستثماره في التجارة؛ ثم إلى إقراض المال بالربا.
وكانت أسفار موسى و التلمود قد حرمت التعامل بالربا بين اليهود أنفسهم ولكنها لم تحرمه بين اليهودي وغير اليهودي. ولما أضحت الحياة الاقتصادية أشد تعقيداً مما كانت قبل، وصارت الحاجة إلى تمويل المشروعات أشد إلحاحاً نظراً لاتساع نطاق التجارة والصناعة، أخذ اليهود يقرض بعضهم بعضاً المال عن طريق وسيط مسيحي أو عن طريق جعل صاحب المال شريكاً موصياً في المشروع وأرباحه-وهي وسيلة أجازها أحبار اليهود، وعدد كبير من رجال الدين المسيحيين. وإذ كان القرآن وكانت الكنيسة المسيحية يحرمان الربا، وكان المقرضون المسيحيون لهذا السبب نادري الوجود قبل القرن الثالث عشر، فإن المقترضين المسلمين والمسيحيين-ومنهم رجال الدين المسيحيون، والكنائس والأديرة-كان هؤلاء المقترضون يلجئون إلى اليهود ليقرضوهم ما يحتاجونه من المال. وحسبنا دليلاً على هذا أن هارون اللنكلني Aaron of Lincoln هو الذي قدم ما يلزم من المال لبناء تسعة أديرة سترسيه Cistercian، وبناء دير سانت أولبنز St. Albans العظيم. ثم غزا رجال المصارف المسيحيون هذا الميدان في القرن الثالث عشر، واستعانوا بالوسائل التي أوجدها وسار عليها اليهود، وما لبثوا أن تفوقوا عليهم في الثراء واتساع نطاق الأعمال. "ولم يكن المرابي المسيحي أقل صرامة" من زميله اليهودي "وإن لم يكن أولهما في حاجة إلى حماية نفسه بالقدر الذي يحتاجه الثاني من خطر القتل والسلب والنهب"(58) فكان كلاهما يشدد النكير عن المدين بما عرف عن الدائنين الرومان من القسوة، وكان الملاك يستغلونهم جميعاً لمصلحتهم الخاصة.
فكان المرابون جميعاً تفرض عليهم ضرائب باهظة، وكان اليهود منهم يتعرضان من حين إلى حين إلى مصادرة أموالهم بأجمعها. وقد سار الملوك على سنة السماح للمرابين بأن يتقاضوا رباً فاحشاً، ثم يلجئون من حين إلى حين إلى اعتصار هذه المكاسب من أصحاب المال. وكان المرابون يتحملون نفقات كبيرة في سبيل الحصول على أموالهم، وكثيراً ما كان الدائن يضطر إلى أداء الرشا للموظفين لكي يسمحوا له بالحصول على ما ماله(59). وحدث في عام 1198 حين كانت أوربا تستعد للحرب الصليبية الرابعة أن أمر البابا إنوسنت الثالث Innocent III جميع الأمراء المسيحيين بإلغاء جميع فوائد القروض التي يطالب بها اليهود مدينيهم المسيحيين(60). وأعنى لويس التاسع، ملك فرنسا القديس، جميع رعاياه من ثلث ما كانوا مدينين به لليهود لكي "يستنزل الرحمة على روحه وروح أسلافه". وكان ملوك الإنجليز في بعض الظروف يصدرون خطابات إعفاء-يلغون بمقتضاها فائدة الدين أو رأس المال أو كليهما لرعاياهم-المدينين لليهود. ولم يكن من النادر أن يبيع الملوك هذه الخطابات، وأن يدونوا في سجلاتهم المبالغ التي حصلوا عليها نظير وساطتهم في هذا البر بالإنسانية. وكانت الحكومة البريطانية تطلب أن ترسل إليها صورة من كل تعاقد على قرض، وأنشأت ديواناً خاصاً باليهود يجمع هذه العقود، ويراقبها، ويستمع غلى القضايا الخاصة بها؛ فإذا ما عجز صاحب مصرف يهودي عن أداء الضرائب أو المطالب المفروضة عليه، رجعت الحكومة إلى ما لديها من سجلات عن قروضه، وصادرتها كلها أو بعضها، وأنذرت مدينيه بأن يؤدوا إليها هي لا إليه ما عليهم من الديون. ولما أن فرض هنري الثاني على سكان إنجلترا ضريبة خاصة في عام 1187، أرغم اليهود على أداء ربع أملاكهم، والمسيحيون على عشرها، وبذلك أدى اليهود وحدهم ما يقرب من نصف الضريبة كلها. وكان اليهود في بعض الأحيان "هم الذين يمولون المملكة". وأمر الملك يوحنا في عام 1210 أن يزج في السجون يهود إنجلترا على بكرة أبيهم-رجالاً كانوا أو نساءً أو أطفالاً-ثم جمعت منهم ضريبة للملك بلغت 66.000 مارك ، وعذّب الذين ظنوا أنهم لم يبوحوا بكل ما كان لديهم من أموال مكنوزة بأن اقتلعت سن من أسنانهم كل يوم حتى يقرروا بحقيقة مدخراتهم. وفي عام 1230 اتهم هنري الثالث اليهود بقطع جزء من عملة الدولة (ويبدو أن بعضهم قد فعل ذلك حقاً)، فصادر ثلث ما يمتلكه يهود إنجلترا من ثروة منقولة، ولما تبين أن هذه الوسيلة مربحة، أعيدت في عام 1231؛ وبعد عامين من ذلك التاريخ انتزع اليهود 20.000 مارك فضي، ثم انتزع منهم في عام 1244 ستون ألف مارك - وهو مبلغ يوازي مجموع إيرادات التاج البريطاني السنوية. ولما استدان هنري الثالث 5000 مارك من دوق كورنوول رهن له جميع يهود إنجلترا ضماناً لدينه. وتوالت على اليهود فيما بين عامي 1252 و 1255 سلسلة من القروض المالية دفعتهم إلى حال من اليأس لم يروا معها بداً من أن يطلبوا أن يؤذن لهم بمغادرة إنجلترا جملة، ولكن طلبهم هذا لم يلق قبولاً. وحرم إدوارد الأول في عام 1275 التعامل بالربا تحريماً باتاً، ولكن الانقطاع لم ينقطع رغم هذا التحريم. وإذا كان خطر ضياع المال قد أزاد بسببه، فقد ارتفع سعر الفائدة، ولذلك أمر إدورد بالقبض على جميع اليهود ومصادرة جميع أملاكهم؛ وقبض كذلك على كثيرين من المرابين المسيحيين وشنق ثلاثة منهم. أما اليهود فإن مائتين وثمانين منهم قد شنقوا، وطيف بجثثهم في شوارع لندن ثم مزقت، وقتل عدد آخر منهم في المقاطعات الإنجليزية. وصودرت أملاك مئات منهم لصالح الدولة.
وأثرى أصحاب المصارف اليهود في الفترات القلقة التي تخللت أوقات المصادرة، وظهرت علائم الثراء المفرط على بعضهم أكثر مما يجب أن تظهر؛ فلم يقتصروا على تقديم المال اللازم لبناء القصور، والكنائس الكبرى، والأديرة، بل شادوا لأنفسهم فوق ذلك بيوتاً فخمة، فكانت تلك البيوت في إنجلترا من أول ما بني من البيوت بالحجارة. وكان بين اليهود أغنياء وفقراء على الرغم من قول إلعزر: "الناس كلهم أكفاء عند الله-النساء والعبيد، والأغنياء والفقراء". وحاول رجال الدين أن يخففوا الفقر، وأن يمنعوا الاستغلال الجشع للمال بوضع عدة نظم اقتصادية مختلفة، فأخذوا يؤكدون ما على الجماعة من تبعات لجميع أفرادها، وخففوا آلام الشدائد بالصدقات المنظمة؛ نعم إنهم لم ينددوا بالغنى، ولكنهم أفلحوا في رفع مكانة العلم حتى سلوت مكانة الثراء؛ ووسموا الاحتكار والائتمار على التحكم في الأسعار بميسم الخطايا(72). وحرموا على بائع الأشتات أن يكسب أكثر من سدس ثمن الجملة ؛ وكانوا يراقبون الموازين والمقاييس، ويحددون أقصى الأثمان وأقل الأجور؛ لكن كثيراً من هذه النظم. قد عجزت عن تحقيق الغرض المقصود منها، لأن رجال الدين لم يستطيعوا فصل حياة اليهود الاقتصادية عن حياة جيرانهم في البلاد الإسلامية أو المسيحية، ووجد قانون العرض والطلب في السلع والخدمات له طريقاً ينفذ منها حول جميع التشريعات.
الأخلاق
وحاول الأغنياء أن يكفروا عن ثرائهم بالصدقات الكثيرة، فكانوا يقرن يما على الثراء من واجبات اجتماعية، ولعلهم أيضاً خافوا ثورة الفقراء أو لعنهم فلم يعرف قط أن يهودياً مات من الجوع وهو يعيش في بيئة يهودية. ومن بداية القرن الثاني المسيحي كان مشرفون رسميون يفرضون في فترات محددة على كل فرد من أفراد العشيرة اليهودية مهما يكن فقيراً أن يكتتب بشيء من ماله "لصندوق العشيرة" الذي يعني بالشيوخ، والفقراء، والمرضى، وبتعليم اليتامى وزواجهم. وكانت واجبات الضيافة تقدم بالمجان وبخاصة للعلماء الجائلين. وفي بعض الجماعات كان المسافرون اليهود إذا قدموا على بلد آواهم موظفون من الجماعات اليهودية في بيوت الأفراد اليهود. وزاد عدد الجمعيات الخيرية اليهودية زيادة كبيرة كلما تقدمت العصور الوسطى، فلم تكن هناك فقط كثير من المستشفيات، وملاجئ للأيتام وبيوت للفقراء والطاعنين في السن، بل كانت هناك أيضاً منظمات تؤدي أموال الفداء للمسجونين، وبائنات للعرائس الفقيرات، وأجور الأطباء للمرضى، وتعني بالأرامل المعدمات، وتدفن الموتى من غير أجر. وكان المسيحيون يشكون من شره اليهود ويحاولون أن يثيروا حماسة المسيحيين للصدقة بأن يضربوا لهم أمثلة من اليهود.
وكانت الفروق بين الطبقات عند اليهود تظهر في ثيابهم، وطعامهم، حديثهم وفي مائة أخرى من أساليب حياتهم. فكان اليهودي البسيط يلبس قفطاناً طويل الكمين فوقه حزام، وكان أسود اللون في العادة، كأنه رمز للحزن على هيكله المهدم وعلى بلاده، لكن أثرياء اليهود في أسبانيا كانوا يظهرون ثرائهم بلبس الثياب الحريرية، وطالما حذرهم الفقراء دون جدوى من أثر هذا التظاهر في إثارة البغضاء والأحقاد. ولما أن حرم ملك قشتالة هذا التجمل في الملبس أطاع الرجال اليهود أمره ولكنهم ظلوا يلبسون أزواجهم أفخر الثياب؛ ولما أن سألهم الملك في ذلك أكدوا له أن الشهامة الملكية لم تكن تقصد قط أن يطبق هذا القيد على النساء ، وظل اليهود طوال العصور الوسطى يجملون نساءهم بفاخر الثياب ولكنهم حرموا عليهن أن يظهرن أمام الجماهير عاريات الرأس، وأنذروهن بأن مخالفة هذا الأمر تصبح سبباً للطلاق، وأمر اليهودي أن لا يصلي في حضرة امرأة يرى الناس شعرها.
وكانت نواحي التلمود المنصلة بالقوانين الصحية مما خفف من آثار الازدحام في أحياء المدن؛ فعملية الختان، والاستحمام كل أسبوع، وتحريم الخمر وأكل اللحم الفاسد، كلها وسائل وقت اليهود شراً الأمراض المنتشرة في البيئات المسيحية المجاورة لهم أكثر من غيرهم من السكان. مثال ذلك أن الجذام كان منتشراً بين فقراء المسيحيين الذين يأكلون اللحم أو السمك المملح، ولكنه كان نادر الحدوث بين اليهود؛ ولعل هذه الأسباب نفسها هي التي جعلت إصابة اليهود بالكوليرا وما شابهها من الأوبئة أقل من إصابة المسيحيين(82). لكن اليهود والمسيحيين على السواء كانوا يعانون الأمرين من الملاريا في أحياء روما القذرة الموبوءة بالبعوض من منافع كمبانيا Campagna.
وكانت حياة اليهودي تنعكس عليها من الناحية الأخلاقية تراثه الشرقي والقيود التي يفرضها عليه الأوربيون؛ ففي كل مناحي الحياة حقوق له مهضومة، وأمواله معرضة للنهب وحياته للخطر والإذلال، يتهم بجرائم ليست له يد فيها، ولهذا كله لجأ كما يلجأ الضعيف الجسم في كل مكان إلى الدهاء يتقي به الأذى. نعم إن أحبار اليهود كانوا ينادون في كل حين أن خداع "غير اليهودي شر من خداع اليهودي نفسه(83)"؛ ولكن بعض اليهود كانوا يخالفون هذه النصيحة ؛ ولعل المسيحيين أيضاً كانوا يخادعون بكل ما يعرفونه من خداع. فرجال المصارف اليهود منهم والمسيحيون لم يكونوا يرحمون مدينيهم بل كانوا يتقاضون منهم كل ما عليهم من ديون، وإن كنا لا ننكر أنه كان في العصور الوسطى، كما كان في القرن الثامن عشر، دائنون لا يقلوا أمانةً وإخلاصاً عن مإير أنسلم من آل روتشليد. وكان بعض اليهود والمسيحيين ينحتون النقود، أو يقبلون البضائع المسروقة. ولكن كثرة استخدام اليهود في المناصب المالية الكبرى توحي بأن من يستخدمونهم من المسيحيين كانوا يثقون بأمانتهم واستقامتهم، وقلّما كان اليهود يرتكبون جرائم العنف-كالقتل، والسطو، والسلب-، وكان السكر أقل انتشاراً بينهم في البلاد المسيحية في البلاد الإسلامية. وكانت حياتهم الجنسية عفيفة إلى حد عجيب على الرغم من أخذهم بمبدأ تعدد الزوجات، وكانوا أقل ميلاً للواط من غيرهم من الشعوب الشرقية الأصل . وكانت نساؤهم عذارى ذوات خفر وحياء، وأزواجاً عاملات مجدات، وأمهات مخصبات ذوات ضمائر حية، وكان من أثر التبكير بالزواج أن قلت الدعارة بينهن إلى أقل حد يستطاع الوصول إليه عند بني الإنسان. وكان العزاب نادري الوجود بين رجالهم، وكان من القواعد التي وضعها الحاخام آشير بن يحيال أن من حق المحاكم أن ترغم الأعزب على الزواج إذا بلغ العشرين من العمر، ولم يكن منهمكاً في دراسة الشريعة. وكان الآباء هم الذين ينظمون أمور الزواج، وتقول إحدى الوثائق اليهودية الباقية من القرن الحادي عشر إنه كان يندر وجود فتيات "يبلغن من قلة الذوق أو من الوقاحة ما يجرأن معه على أن يبدين هواهن أو خيارهن" في هذه الناحية. ولكن الزواج لا يكون قانونياً إلا برضاء الزوجين. وكان من حق الوالد أن يزوج ابنته لمن يشاء وهي صغيرة السن حتى وإن كانت في السادسة من عمرها؛ ولكن زواج الأطفال على هذا النحو لم يكن يتم إلا إذا بلغ الزوجان سن الرشد، وكان من حق الفتاة أن تلغي هذا الزواج إذا شاءت. وكانت الخطبة إجراءً رسمياً تجعل الفتاة زوجة للرجل من الوجهة القانونية، ولا يمكن التفرقة بعدها بعد الزوجين إلا بوثيقة طلاق قضائية. وكان عقد يوقع عند الزواج (كتوبة) يحدد فيه بائنة الزوجة ومهر الزوج. وكان هذا المهر مبلغاً من المال يُتَجنَّب من مال الزوج ويؤدي للزوجة إذا طلقها أو مات عنها. وبغير هذا المهر الذي لم يكن يقل عن مائتي زوزا Zuza (وهو قدر يكفي لشراء بيت تسكنه أسرة واحدة) لا يصبح الزواج بعذراء صحيحاً من الوجهة القانونية.
وكان تعدد الزوجات سنّة جرى عليها أغنياء اليهود في البلاد الإسلامية ولكنها كانت نادرة بينهم في البلاد المسيحية. وتشير الآداب الدينية التي وصلت إلينا من عهد ما بعد التلمود ألف إشارة وإشارة إلى "زوج" الرجل، ولا تشير قط إلى "أزواجه". وأصدر جرشم بن يهوذا حاخام مينز في عام 100 م أمراً بحرمان كل يهودي يتزوج أكثر من واحدة، وما لبث تعدد الزوجات بعد هذا القرار أن انقرض أو كاد بين اليهود في جميع أنحاء أوربا ما عدا أسبانيا. على أن حالات من هذا التعدد ظلت تحدث من حين إلى حين إذا ظلت الزوجة عقيماً بعد عشر سنين من زواجها وسمحت هي للرجل أن يتخذ له حظية أو زوجة ثانية ، ذلك أن الأبوة كانت مسألة حيوية عند اليهود. وقد ألغى هذا القرار نفسه-قرار جرشم-ما كان للزوج قديماً من حق طلاق زوجته بغير رضاها ومن غير جريمة ارتكبتها؛ وأكبر الظن أن الطلاق بين اليهود في العصور الوسطى كان أقل منه في أمريكا في هذه الأيام.
وكانت الأسرة أكبر أسباب نجاة الحياة اليهودية وإن لم تكن رابطة الزواج قوية محكمة من الوجهة القانونية. ذلك أن الخطر المحدق باليهود من خارجهم قد قوى وحدتهم الداخلية، ويشهد أعداؤهم أنفسهم بما كانت تمتاز به الأسرة اليهودية، وما تمتاز به الآن، من "حرارة، وكرامة... وتفكير، وتدبر، وحب أبوي وأخوي". فقد كان الزوج الشاب يشترك مع زوجته في العمل، وفي السرَّاء والضراء، وكان شديد الحب لها لأنه يراها جزءاً من نفسه الكبرى، وإذا أصبح أباً وكبر أطفاله من حوله أثاروا فيه قواه المدخرة وبعثوا فيه أعمق الوفاء. وأكبر الظن أنه لم يكن قبل الزواج قد مس جسم امرأة غير زوجته دون الشعار، ولم تكن تتاح له في تلك البيئة الصغيرة الوثيقة الصلات إلا أقل الفرص للخيانة الزوجية بعد الزواج. ويكاد منذ ولادة أطفاله يبدأ بائنات لبناته ومهور لأولاده، وكان من البدائة عنده أن من واجبه أن يساعد البنين والبنات بماله في السنين الأولى من حياتهم وحياتهن الزوجية. وكان ذلك يبدو له أكثر حكمة من ترك الشاب يستعد لقيود الزواج المفرد بفترة من الاختلاط الجنسي الطليق. وكثيراً ما كان العريس يعيش مع عروسه في بيت أبيها-وقلّما كان ذلك سبباً في ازدياد سعادة الأسرة. وكان سلطان الأب الأكبر في البيت سلطاناً مطلقاً لا يكاد يقل في ذلك عن سلطانه في روما الجمهورية. فكان من حقه أن يحرم أبناءه دينياً، وأن يضرب زوجته ضرباً غير مفرط، فإذا ما أصابها بأذى جسيم فرضت عليه العشيرة غرامة تتناسب مع موارده، وكان في العادة يمارس سلطانه بصرامة لا تطغى قط على عاطفة الحب القوية.
وكان مركز المرأة منحطاً من الوجهة القانونية، عالياً من الناحية الأخلاقية. ولكن الرجل اليهودي يحمد الله، كما يحمد أفلاطون ، لأنه لم يولد أنثى، وكانت المرأة تجيب عن ذلك بتواضع جم: "وأنا أحمد الله الذي خلقني كما أراد". وكان للنساء في المعبد موضع منعزل في الرواق أو خلف الرجال وتلك تحية سمجة لمفاتنهن التي تلهي العابدين عن العبادة، ولم يكن يحسبن في العدد الواجب اكتماله لأداء الصلاة. وكانت الأغاني التي يمتدح بها جمال المرأة تعد عملاً غير لائق وإن كان التلمود قد أباحها. أما التغازل-إذا وجد-فلم يكن إلا عن طريق المراسلة، ولقد نهى الأحبار عن التخاطب بين الرجال والنساء-حتى بين الزوجين-أمام الناس ، وقد أبيح الرقص ولكنه كان مقصوراً على رقص المرأة مع المرأة والرجل مع الرجل.
وكان القانون يجعل الزوج هو الوارث الوحيد لزوجته، أما الأرملة فلم يكن من حقها أن ترث زوجها، فإذا مات حصلت على قيمة بائنتها، ومهر الزواج، أما فيما عدا هذا فقد كانت تعتمد على أبنائها الذكور، ورثة أبيهم الطبيعيين، في أن ييسروا لها سبل الحياة الطيبة. ولم تكن البنات يرثن آبائهن إلا إذا لم يكن له أبناء ذكور، فإذا كان له اعتمدن على حبهم الأخوي، وقلّما كان يخيب فيهم رجاؤهن(99). ولم تكن البنات يرسلن إلى المدارس؛ فقد كان العلم مهما قل يعد بالنسبة إليهن أمراً شديد الخطورة. على أنهن رغم هذا كن يسمح لهن بأن يدرسن في بيوهن؛ فنحن نسمع عن عدد من النساء يلقين محاضرات عامة في الشريعة-وإن كانت صاحبة المحاضرة تستتر أحياناً عن المستمعين. ولكن المرأة اليهودية الجديرة بالتكريم والإخلاص، كانت تلقي بعد زواجها كل ما هي خليقة به منهما رغم ما كان يحيط بها من إجحاف مادي وقانوني، وقد نقل يهوذا بن موسى بن تيبون Tibbon عن حكيم مسلم قوله: "لا يكرم النساء إلا الكريم، ولا يحقرهن إلا الحقير". وكانت صلات الأب بأبنائه أقرب إلى الكمال من الصلات الزوجية. فقد كان اليهودي بما عرف عن الرجل الساذج العمادي من كبرياء، يفخر بأبنائه وبقدرته على إنجاب الأبناء. وكان يقسم أغلظ إيمانه بأن يضع يده على خصيتي من يتلقى منه اليمين، ومن هنا اشتقت كلمة testimony الأوربية ، ومعناها الشهادة أو البيّنة أو الشاهد نفسه. وكان كل رجل يؤمر بأن يكون له طفلان على الأقل، وكان له في العادة أكثر من اثنين. وكان الطفل يلقى الإجلال الذي يليق بزائر قدم من السماء، ومن مَلَك تجسد، وكان الأب يلقى من التبجيل ما كان يجعله رسولاً من عند الله، فكان الولد يقف في حضرة أبيه حتى يأمره بالجلوس، ويطيعه طاعة جزعة قلقة تتناسب مع كبرياء الشباب. وكان الولد أثناء الاحتفال بالختان يكرس إلى يهوه بمقتضى عهد أبراهام، وكانت كل أسرة تشعر بأن تعد واحداً من أبنائها على الأقل ليتولى المناصب الدينية. وكان الولد، إذا بلغ الثالثة عشرة من عمره، يدخل ميدان الرجولة، ويفرض عليه كل ما تفرضه الشريعة على الرجال، ويحدث ذلك في حفل رهيب يثبت فيه هذا ويؤكد وكان الدين يخلع رهبته وقداسته على كل مرحلة من مراحل نموه، ويخفف بذلك من واجبات الآباء.
الدين
كذلك كان الدين رقابة روحية في كل ناحية من نواحي القانون الأخلاقي. لا ريب إنه كانت في الشريعة ثغرات، وأن الحيل القانونية كانت تتلمس لكي تعاد إلى الشعب حرية التطبيق التي لا غنى عنها لكل شعب مغامر. ولكن يلوح أن الرجل اليهودي في العصور الوسطى كان يقبل الشريعة بوجه عام ويتخذها درعاً لا يقيه اللعنة الأبدية فحسب، بل يقيه فوق ذلك وبصفة أظهر للعيان تفكك جماعاته وانحلالها. نعم إنها كانت تضيق عليه في جميع مناحي الحياة، ولكنه كان يعظمها لأنها موطن نشأته ومدرسة تربيته والوسيلة التي لا بد منها لحياته. وكان كل بيت في بلاد اليهود كنيساً، وكل مدرسة معبداً، وكل أب كوهناً. فصلوات الكنيس وطقوسه كان لها مثيلات موجزة في البيت. وكان الصوم والأعياد الدينية يحتفل بها فيه احتفالات تعليمية تربط الماضي بالحاضر والأحياء بالأموات وبمن لم يولدوا بعد. وكان من عادة الأب في مساء يوم الجمعة أي ليلة السبت من كل أسبوع أن يجمع حوله زوجته، وأولاده، وخدمه، ويباركهم فرداً فرداً، ويؤمهم في الصلاة، وفي القراءة من الكتب الدينية، والأغاني المقدسة. وكانت تعلق على باب كل حجرة كبيرة من حجرات البيت أنبوبة (مزوزا) محتوية على ملف من الرق كتبت عليه فقرتان من سفر تثنيه الاشتراع (الآيات 4-9 من الإصحاح السادس، 13-21 من الإصحاح الحادي عشر) تذكر اليهودي أن إلهه "واحد يجب عليه أن يحبه من كل قلبه وروحه وبكل قوته". وكان يجاء بالوالد على الكنيس من سن الرابعة وما بعدها، حيث ينطبع الدين في نفسه في أكثر السنين تأثيراً في تكوينه.
ولم يكن الكنيس معبداً دينياً فحسبن بل كان فوق ذلك المركز الاجتماعي للعشيرة اليهودية؛ والمعنى الحرفي للفظ سناجوج، وإكليزيا، وسينود، وكلية هو مجتمع؛ ولقد كان الكنيس قبل المسيحية مدرسة ولا يزال يسمى شوله Schule عند اليهود الإشكنازيين، ثم أخذ على عاتقه في عهد التشتت عدداً كبيراً من الواجبات العجيبة المختلفة، فكان من عادة بعضها أن ينشر في كل سبت ما يصدره بيت الدين من قرارات خلال الأسبوع المنصرم، وأن يجبي الضرائب، وأن يعلن عن الأمتعة المفقودة، وأن ينظر في شكاوي بعض الأفراد من البعض الآخر، وأن يذيع أخبار الأملاك قبل موعده حتى يستطيع من له حقوق في هذه الأملاك أن يعترض عليه. وكان الكنيس يوزع الصدقات العامة، وكان في بلاد آسية مسكناً لأبناء السبيل. وكان مبناه على الدوام أجمل المباني في الحي اليهودي، وكان في بعض الأحيان وبخاصة في أسبانيا وإيطاليا آية من آيات العمارة، مزداناً أعظم زينة وأجملها؛ وكثيراً ما كان ولاة الأمور المسيحيون يحرمون على اليهود إقامة معابد تطاول أعلى كنيسة مسيحية في المدينة، وأمر البابا هونوريوس الثالث في عام 1221 بهدم معبد بهذا الوصف في بورج Bourges(102). وكان في أشبيلية في القرن الرابع عشر ثلاثة وعشرون كنيساً، وفي طليطلة وقرطبة ما لا يكاد يقل عن هذا العدد، منها واحد شيد في قرطبة عام 1315 تحتفظ به الحكومة الأسبانية على أنه أثر قومي.
وكان بكل كنيس مدرسة (بيت الدرس Beth ha Midrash) بالإضافة إلى المدارس الخاصة والمعلمين الخصوصيين، وأكبر الظن أن نسبة من كانوا يعرفون القراءة والكتابة بين يهود العصور الوسطى كانت أكبر منها بين المسيحيين وإن كانت أقل منها بين المسلمين. وكانت أجور المدرسين تؤديها الجماعات اليهودية عامة أو يؤديها الآباء، ولكنهم كلهم كانوا خاضعين لرقابة الجماعة المشتركة. وكان الأولاد يخرجون غلى المدارس مبكرين-قبل مطلع الفجر في الشتاء؛ ثم يعودون غلى بيوتهم بعد بضع ساعات لتناول الفطور، ثم يرجعون إلى المدرسة حيث يبقون حتى الساعة الحادية عشرة، ثم يأتون إلى المنزل للغذاء، ويعودون إلى المدرسة ظهراً، ثم يستريحون بين الساعة الثانية والثالثة، ثم يذهبون مرة أخرى غلى المدرسة ويبقون فيها إلى المساء، ثم يطلق سراحهم أخيراً ليعودوا إلى بيوتهم ليتعشوا، ويصلوا، ويناموا، وكذلك كانت حياة الغلام اليهودي حياة جدية شاقة. وأول ما كان يدرسه الغلام اليهودي هو اللغة العبرية وأسفار موسى الخمسة؛ فإذا بلغ العاشرة من عمره بدأ يدرس المشنا، وفي الثالثة عشرة يأخذ في دراسة الأجزاء الرئيسية من التلمود، ومن شاء منهم أن يكون من العلماء واصل دراسة المشنا والجمارا من الثالثة عشرة غلى العشرين من عمره أو ما بعدها. وكان الطالب يتعلم عن طريق دراسته لموضوعات التلمود المختلفة مقداراً قليلاً من العلوم المختلفة تبلغ عشرة أو تزيد، ولكنه لا يكاد يدرس شيئاً من تاريخ اليهود. وكان أكثر ما يتعلمه عن طريق التكرار، وكانت التلاوة الجماعية قوية عالية غلى حد جعل بعض البيئات تمنع وجود المدارس فيها. أما التعليم العالي فكان مكانه اليشيبة أو المجمع العلمي، وكان خريج هذا المجمع يسمى تلميذ حاخام أي عالماً بالشريعة؛ وكان يعفى عادة من الضرائب المفروضة على سائر أفراد العشيرة، وكان ينتظر من غير العلماء أن يهبوا واقفين إذا أقبل أو أدبر وإن لم يكن حتماً من الأحبار الرسميين .
أما الحبر الرسمي فكان معلماً وقاضياً، وكاهناً. وكان يطلب إليه أن يتزوج، ولك يكن يتقاضى نظير القيام بواجباته الدينية إلا القليل من الأجر إذا تقاضى شيئاً منه على الإطلاق؛ وكان في العادة يكسب عيشه بعمل من الأعمال التي لا تمت بصلة إلى الدين؛ وقلّما كان يعظ، لأن الوعظ كان متروكاً لوعاظ متنقلين (مجديم) يدربون على فنون البلاغة المرهبة ذات الأصوات المنغمة الطنانة الرنانة. وكان في مقدور كل فرد من المصلين أن يؤوم الجماعة، ويقرأ فقرات من الكتاب المقدس، ويعظ؛ ولكن هذا الشرف كان يختص به في العادة أحد اليهود البارزين أو الذين لهم يد طولي في الصدقات والأعمال الخيرية. وكانت الصلاة عند اليهود المتمسكين بالدين عملاً شديد التعقيد، لا تؤدي على الوجه لصحيح إلا إذا غطى المصلي رأسه دليلاً على الخشوع، وربط على ذراعيه وجبته علباً صغيرة، تحتوي فقرات من سفر الخروج (الآيات 1-16 من الإصحاح الثالث عشر) وتثنية الاشتراع (الآيات 4-9 من الإصحاح السادس، و13-21 من الإصحاح الحادي عشر)، وثبت في أطراف ثيابه أهداباً نقشت عليها أهم وصايا الرب. وكان رجال الدين يفسرون هذه الإجراءات الشكلية بأنها أمور لا بد منها لتذكر اليهود بوحدانية الله، ووجوده، وشرائعه. أما السذج من اليهود فقد أصبحوا يحسبونها تمائم سحرية ذات قوى معجزة خارقة للطبيعة. وكانت الصلاة تختم بقراءة من ملف الشريعة الموضوع في تابوت صغير فوق المذبح. وكان اليهود في المنفى لا يوافقون على إدخال الموسيقى في الشعائر الدينية، ويرون أنها قلّما تتفق مع حزنهم على وطنهم الضائع، ولكن الواقع أن بين الموسيقى والدين من الصلات القوية مثل ما بين الشعر والحب. ذلك أن التعبير المتحضر عن أقوى العواطف وأكثرها عمقاً يتطلب أشد الفنون إثارة للانفعالات النفسية؛ ولقد عادت الموسيقى إلى الكنيس عن طريق الشعر؛ ذلك أن البيتانيم Paitanim أو "الشعراء الجدد" العبرانيين شرعوا يكتبون أشعاراً دينية مثقلة بالزخرف الصناعي كالأبيات المتجانسة أول حروفها أو التي إذا جمعت الحروف الأولى منها كونت اسماً خاصاً أو جملة بعينها، ولكنها يرفع من قدرها رنين اللغة العبرية وفخامة نغماتها وامتلاؤها بالحماسة الدينية التي أضحت عند اليهودي وطنية وديناً معاً. ولا تزال ترانيم إلعزر بن قلير (من القرن الثامن) الفجة القوية تجد لها مكاناً في طقوس بعض المعابد اليهودية. ولقد أظهرت أشعار مثلها عند يهود أسبانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وألمانيا، منها واحدة يترنم بها كثيرون من اليهود يوم عيد الكفارة.
إذا أقبلت ملكوتك تشققت التلال عن أناشيد.
وضحكت الجزائر متهللة لأنها تنتسب إلى الله.
وتغنى كل من فيها من المصلين بأعلى أصواتهم يثنون عليك.
حتى إذا سمعتها أبعد الشعوب نادت بك ملكاً متوجاً عليها.
ولما أن أدخلت هذه القصائد المقدسة (البيوطيم) في الصلوات التي تقام في المعابد، كان ينشدها مرتل القداس، وبذلك عادت الموسيقى إلى الشعائر الدينية. يضاف إلى هذا أن تلاوة الكتاب المقدس والأدعية كان ينشدها في كثير من المعابد رئيس فرقة المرتلين أو ينشدها النرتلون إنشاداً ترتجل معظم نغماته ارتجالاً، ولكنها تتبع في بعض الأحيان نماذج النغمات البسيطة الموضوعة للترانيم المسيحية. من ذلك أن النغمات المعقدة للأغنية العبرانية الذائعة الصيت المعروفة باسم كل نيدري Kol Nidre (جميع الإيمان)(111)، قد أخذت من مدرسة ديرسنت جول St. Gail الغنائية بسويسرا في وقت ما قبل بداية القرن الثاني عشر. على أن الكنيس اليهودي لم يحل في قلب اليهودي محل الهيكل بكل معاني الحلول، بل ظل أمله في أن يقدم القربان ليهوه في يوم من الأيام أمام قدس الأقداس على تل صهيون، يلهب خياله، ويتركه عرضة لخداع "المسيح الكذاب" في مختلف الأوقات. من ذلك ما حدث في عام 20 حين أعلن شيريم Sereme وهو رجل سوري، أنه هو المنقذ المنتظر، وسير حملة لانتزاع فلسطين من المسلمين. وغادر اليهود مواطنهم في بابل وأسبانيا ليشتركوا في هذه المغامرة، ولكن القائم بها أسر، وعرضه الخليفة يزيد الثاني على الجماهير على أنه مهرج دجال، ثم أمر به فقتل. وبعد بضع سنين من ذلك الوقت تزعم عبوديا بن عيسى بن إسحق الأصفهاني ثورة أخرى مثلها امتشق فيها عشرة آلاف يهودي الحسام، واستبسلوا في الحرب بقيادته، ولكنهم هزموا، وقتل ابن عيسى في المعركة وعوقب جميع يهود أصفهان بلا تمييز بينهم لانضمامهم إليه. ولما أثارت الحملة الصليبية الأولى ثائرة أوربا حسبت الجماعات اليهودية أن انتصار المسيحيين سيعيد فلسطين إلى اليهود ، ولكنهم أفاقوا من أحلامهم على سلسلة من المذابح المدبرة. وفي عام 1160 أثار دافيد الرؤى يهود العراق إذ نادى فيهم أنه هو المسيح المنتظر وأنه سيعود بهم إلى أورشليم ويرد إليهم حريتهم؛ لكن حماه خشي أن يحيق الهلاك باليهود بسبب هذه الأفكار فما كان منه إلا أن ذبحه وهو نائم. ثم ظهر مسيح آخر في جنوبي جزيرة العرب عام 1225 وأثار اليهود إثارة حمقاء. وكتب ابن ميمون "رسالة إلى الجنوب" ذائعة الصيت فند فيها مزاعم هذا الداعي، وذكر يهود العرب بما أعقب هذه المحاولات الطائشة في ماضي الأيام من هلاك ودمار(113)، ولكنه رغم هذا ارتضى الأمل في المسيح المنتظر، على أنه دعامة لا بد منها للروح اليهودية في تشتتهم، وجعل هذا الأمل إحدى العقائد الثلاث عشرة الأساسية في الديانة اليهودية.
كراهية اليهود
ترى ما هو منشأ العداء القائم بين غير اليهود واليهود؟ لقد كانت الأسباب الرئيسية الباعثة على هذا العداء أسباباً اقتصادية، ولكن الخلافات الدينية كانت على الدوام سبباً في زيادة المنافسات الاقتصادية وستاراً لها، فالمسلمون المؤمنون برسالة محمد يغضبهم من اليهود عدم إيمانهم بهذه الرسالة، والمسيحيون الذين يؤمنون بألوهية المسيح يؤلمهم أن يجدوا شعبه نفسه لا يؤمن بهذه الألوهية. ولم يكن كثيرون من المسيحيين الصالحين يرون أن مما يخالف تعاليم دينهم أو يخالف التعاليم الإنسانية بوجه عام أن يلقوا على شعب بأسره، خلال القرون الطوال، تبعة أعمال فئة قليلة العدد من يهود أورشليم في آخر أيام المسيح، ويحدثنا إنجيل لوقا أن جماعات من اليهود رحبت بدخول المسيح أورشليم (الآية 37 من الإصحاح 29) وكيف حمل صليبه بيلاطس: "تبعه جمهور كبير من الشعب والنساء اللائي كن يلطمن وينحن عليه" (الآية 27 من الإصحاح 23)، وكيف أن كل الجموع الذين "كانوا مجتمعين لهذا المنظر لما أبصروا ما كان رجعوا وهم يقرعون صدورهم" (الآية 48 من الإصحاح 23)، ولكن هذه الشواهد القاطعة بعطف اليهود على عيسى كانت تنمحي ذكراها حين تتلى على المسيحيين قصة الآلام المريرة كل أسبوع مقدس من فوق ألف منبر ومنبر، فكانت نيران الحقد تضطرم في قلوب المسيحيين، وكان بنو إسرائيل في تلك الأيام يحبسون أنفسهم في أحيائهم وبيوتهم خشية أن تثور عواطف السذج من الناس فتؤدي إلى المذابح.
ونشأت حول هذا السبب الرئيسي من أسباب سوء التفاهم عشرات المئات من أسباب الريبة والعداء. وتحمل رجال المصارف اليهود أكبر آثار العداء الناشئ من أسعار فائدة القروض، وهي أسعار ترتفع كلما قلت ضماناتها. ولما أن نمت الشئون الاقتصادية المسيحية، وغزا التجار ورجال المصارف من غير اليهود ميادين كان اليهود هم المسيطرين عليها من قبل، أثارت المنافسة الاقتصادية الأحقاد في الصدور، وأخذ بعض المرابين المسيحيين يبذرون بذور الحقد على السامية. وكان اليهود الذين يشغلون مناصب رسمية وبخاصة في المصالح المالية للحكومات المسيحية هدفاً طبيعياً لمن يكرهون الضرائب واليهود كليهما. وتأصلت هذه الأحقاد الاقتصادية والدينية في الصدور فأصبح كل ما هو يهودي بغيضاً لبعض المسيحيين، وكل ما هو مسيحي بغيضاً لبعض اليهود، فأخذ المسيحيون يعيبون على المسيح عزلتهم، ولم يغفروا لهم هذه العزلة التي كانت رد فعل لتمييز غيرهم عليهم. وما كان يوجه إليهم من اعتداء في بعض الأحيان، وبدت ملامح اليهود، ولغتهم، وآدابهم، وأطعمتهم، وشعائرهم، بدت هذه كلها في أعين المسيحيين غريبة كريهة. ثم إن اليهود كانوا يطعمون حين يصوم المسيحيون، ويصوم أولئك حين يفطر هؤلاء، وظل يوم راحتهم وصلواتهم يوم السبت كما كان في قديم الأيام، على حين أن يوم الراحة والصلوات عند المسيحيين قد تبدل فأصبح يوم الأحد، وكان اليهود يحتفلون بنجاتهم السعيدة من مصر في عيد فصح قريب قرباً يراه المسيحيون غير لائق من يوم الجمعة الذي يحزنون فيه لموت المسيح. ولم تكن الشريعة اليهودية تبيح لليهود أن يأكلوا طعاماً مسته يد غير يهودية، أو يشربوا خمراً عصرته، أو يستعملوا آنية لمستها ، أو أن يتزوجوا إلا من يهوديات. وكان المسيحي يفسر هذه القواعد القديمة-التي وضعت قبل نشأة المسيحية بزمن طويل-بأن اليهود يرون أن كل شيء مسيحي نجس، ويرد على هذا بأن الإسرائيلي نفسه لم يكن في أغلب الأحيان يمتاز بنظافة جسمه أو أناقة ثيابه. ونشأت من عزلة هؤلاء وأولئك بعضهم أقاصيص سخيفة محزنة انتشرت بين كلا الطرفين. وكان قبل الرومان قبل ذلك الوقت يتهمون المسيحيين بأنهم يذبحون أطفال الوثنيين ليقدموا دماءهم في السر قرباناً لإله المسيحيين، ثم أخذ المسيحيون في القرن الثاني عشر يتهمون اليهود باختطاف أطفال المسيحيين ليقدموهم قرباناً إلى يهوه، أو ليتخذوا دماءهم دواء، أو يستعملوه في صنع الخبز الفطير لعيد الفصح. واتهم اليهود بأنهم يسممون الآبار التي يشرب منها المسيحيون ويسرقون الرقاق المقدس ليثقبوه ويخرجوا منه دم المسيح. ولما أن تباهى عدد قليل من تجار اليهود بثرائهم وأظهروا هذا الثراء بارتداء الملابس الغالية الثمن اتهم الشعب اليهودي على بكرة أبيه بأنه يستنزف أموال المسيحيين جملة ويضعها في أيدي اليهود. واتهمت اليهوديات بأنهم ساحرات، وقبل إن كثيرين من اليهود من حزب الشيطان. ورد اليهود على هذه الأقاصيص بأخرى مثلها عن المسيحيين، وبقصص مهينة عن مولد المسيح وشبابه. وكان التلمود ينصح بأن تشمل الصدقات اليهودية غير اليهود ، وكان بحيا Bahya يثني على الرهبنة المسيحية، وكتب ابن ميمون يقول إن تعاليم المسيح والنبي محمد تنزع بالإنسانية إلى الكمال ، ولكن اليهودي العادي لم يكن يستطيع فهم هذه المجاملات الفلسفية، وبادل أعداءه حقداً بحقد.
وكانت هناك فترات صفاء بين أوقات الجنون السالفة الذكر، فكثيراً ما كان اليهود يختلطون بالمسيحيين اختلاط الأصدقاء متجاهلين قوانين الدولة والكنيسة التي تحرم هذا الاختلاط، وكانوا أحياناً يتزاوجون وبخاصة في أسبانيا وجنوبي أوربا. وكان العلماء المسيحيون واليهود يتعاونون فيما بينهم، ميكائيل اسكت Michael Scot مع أناتولي Anatoh، ودانتي مع عمونيل ، وكان المسيحيون يقدمون الهبات للمعابد اليهودية، وفي مدينة وورمز Worms كانت هناك حديقة يهودية كبرى ينفق عليها من هبة وهبتها امرأة مسيحية. وبُدّل يوم السوق في ليون من السبت إلى الأحد تيسيراً لليهود، ووجدت الحكومات غير الدينية أن اليهود عنصر نافع في الأعمال التجارية والمالية فأولتهم حمايتها في بعض الأوقات؛ وإذا كانت دولة من الدول قد قيدت حركات اليهود أو أخرجتهم من بلادها فقد كان سبب ذلك في بعض الأحيان أنها لم يعد في مقدورها أن تحميهم من التعصب والعدوان.
وكان موقف الكنيسة من هذه الأحداث يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. ففي إيطاليا كانت تحمي اليهود بوصفهم "حراس الشريعة" الواردة في العهد القديم وبوصفهم شهدوا أحياء على صحة الكتاب المقدس من الوجهة التاريخية وعلى "غضب الله". لكن مجالس الكنيسة كانت من حين إلى حين تعمل على زيادة متاعب الحياة اليهودية، وكثيراً ما كان يصدر عنها ذلك بحسن نية، وقلّما كانت تعتمد في عملها هذا على ما لها من سلطان عام. من ذلك أن قانون ثيودوسيوس ، ومجلس كليرمنت ، ومجلس طليطلة 589 كلها حرمت تعيين اليهود في المناصب التي من حق شاغلها أن يوقع عقوبة على المسيحيين. وأمر مجلس أورليان Orleans 538 جميع اليهود ألا يخرجوا من بيوتهم طوال الأسبوع المقدس، ولعل ذلك الأمر كان يقصد به حمايتهم، وحرم استخدامهم في المناصب العامة. وحرم مجلس لاتران Lateran الثالث 1179 على القابلات أو المرضعات المسيحيات أن يخدمن اليهود، وندد مجلس بزيير Beziers 1246 باستخدام المسيحيين أطباء من اليهود؛ ورد مجلس أفنيون Avignon (1209) على قوانين الطهارة اليهودية بتحذير "اليهود والعاهرات" من لمس الخبز أو الفاكهة المعروضة للبيع؛ وأعاد القوانين الكنسية الصادرة بتحريم استئجار اليهود الخدم المسيحيين، وحذر المؤمنين من تبادل الخدمات مع اليهود، وأمر بتجنبهم لنجاستهم(125). وأعلنت بعض المجالس إلغاء كل زواج بين المسيحيين واليهود، وأحرق شماس في عام 1222 على القائمة الخشبية لأنه اعتنق الدين اليهودي وتزوج بيهودية(126). وحرمت أرملة يهودية في عام 1234 من بائنتها بحجة أن زوجها اعتنق الدين المسيحي قبل وفاته وأن هذا يلغي زواجهما(127). وأصدر مجلس لاتران الرابع في عام 1215 قراراً يحتم "على اليهود والمسلمين-ذكوراً كانوا أو إناثاً-في كل ولاية مسيحية وفي جميع الأوقات أن يميزوا أنفسهم عن غيرهم في أعين الجمهور بلبس أثواب خاصة لأن المسيحيين يخطئون أحياناً فيتصلون بنساء اليهود والمسلمين، ويتصل اليهود والمسلمون بالنساء المسيحيات". ولهذا يجب على اليهود والمسلمين متى جاوزوا الثانية عشرة من العمر أن يميزوا ملابسهم بيوم خاص-ويكون ذلك بالنسبة للرجال في غطاء الرأس أو الجبة، وبالنسبة للنساء في أقنعتهن. وكان من أسباب صدور هذه الأوامر أنها رد على قوانين قديمة مماثلة لها أصدرها المسلمون ضد اليهود أو المسيحيين. وكان نوع الشارة المميزة تعينه محلياً حكومات الولايات أو المجالس الإقليمية للكنيسة المسيحية. وكانت في العادة تتخذ صورة عجلة أو دائرة من النسيج الأصفر، طول قطرها نحو ثلاث بوصات تخاط في مكان ظاهر فوق الملابس. ونفذ هذا للقرار في إنجلترا عام 1279؛ أما في أسبانيا وإيطاليا وألمانيا فلم ينفذ إلا في أوقات متباعدة قبل القرن الخامس عشر حين أخذ نيقولا القوزاوي Nickolas of Cusa وسان جيوفاني داكبسترانو San Giovanni Capistrano يدعوان إلى التشدد في تنفيذه بأكمله. وكان من أثر تلك الدعوة أن هدد يهود قشتالة في عام 1219 بمغادرة البلاد جملة إذا نفذ هذا القانون؛ ووافق ولاة الأمور الدينيون على إلغائه، وكثيراً ما كان الأطباء والعلماء، ورجال المال، والرحالة اليهود يعفون منه، ثم أخذ العمل به يضعف قبل القرن السادس عشر وامتنع نهائياً حين قامت الثورة الفرنسية.
ويمكن القول بوجه عام إن البابوات كانوا أكثر رجال الدين تسامحاً في العالم المسيحي. مثال ذلك أن جريجوري الأول، نهى عن إرغام اليهود على اعتناق الدين المسيحي رغم تحمسه الشديد لنشر هذا الدين، وحافظ على مالهم من حق المواطنية الرومانية في البلاد الخاضعة لحكمه ؛ ولما أن استولى الأساقفة في طرشونة Terracina وبالرم على معابد اليهود لكي ينتفع بها المسيحيون أرغمهم جريجوري على أن يردوها إليهم كاملة ، وكتب إلى أسقف نابلي يقول: "لا تسمح بأن يضيق على اليهود في أداء صلواتهم، ودع لهم الحرية الكاملة في مراعاة أعيادهم وأيامهم المقدسة والاحتفال بها، كما كانوا هم وآباؤهم يفعلون من زمن بعيد"(130). وحث جريجوري السابع الحكام المسيحيين على إطاعة قرارات مجلس الكنيسة التي تحرم استخدام اليهود في المناصب؛ ولما قدم إنجنيوس الثالث إلى باريس عام 1145، وسار في موكب حافل إلى الكنيسة الكبرى التي كانت وقتئذ في الحي اليهودي، بعث اليهود إليه بوفد ليهدي إليه التوراة أو ملف الشريعة، فباركهم وعادوا إلى بيوتهم مغتبطين، وطعم البابا حمل عيد الفصح مع الملك. وكان البابا اسكندر الثالث على وئام مع اليهود واستخدم واحداً منهم في إدارة شئونه المالية ؛ وتزعم إنوسنت Innocent الثالث مجلس لاتران الرابع فيما طلبه من أن يكون لليهود شارة خاصة، ووضع هو المبدأ القائل بأن اليهود على بكرة أبيهم قد فرضت عليهم العبودية الأبدية لأنهم صلبوا عيسى، ثم كرر في ساعة كان فيها أرق مزاجاً الأوامر البابوية التي تحرم إرغام اليهود على ترك دينهم وقال: "لا يحق لمسيحي أن يؤذي اليهود في أجسامهم... أو يسلبهم أملاكهم... أو يتسبب في إقلاقهم أثناء الاحتفال بأعيادهم... أو يبتز منهم المال بتهديدهم بإحراق موتاهم. وأعفى جريجوري التاسع منشئ محكمة التفتيش اليهود من إجراءاتها أو اختصاصها إلا إذا حاولوا تهديد المسيحيين، أو ارتدوا إلى الدين اليهودي بعد أن تنصروا ، ونبذ إنوسنت الرابع 1247 القصة القائلة بأن من شعائر اليهود ذبح أطفال المسيحيين وقال:
لقد ابتدع بعض القساوسة، والأمراء، والنبلاء، وكبار الأشراف... أساليب تتنافى مع الدين ضد اليهود خداعاً منهم وتضليلاً، فحرموهم بلا حق من أملاكهم قوة واقتداراً، واستولوا عليها لأنفسهم، واتهموهم زوراً وبهتاناً بأنهم يقتسمون فيما بينهم في يوم عيد الفصح اليهودي، قلب غلام مذبوح... والحق أنهم في حقدهم يعزون إلى اليهود كل حادث قتل أياً كان المكان الذي يقع فيه. وبسبب هذه التهم المختلفة وأمثالها تمتلئ قلوبهم غلاً على اليهود، فينهبون أموالهم... ويضطهدونهم بتجويعهم وسجنهم، وتعذيبهم، وإيذائهم بغير تلك الوسائل، ويقضون عليهم أحياناً بالإعدام، وبذلك أصبحت حال اليهود أسوأ مما كان عليه آباؤهم تحت حكم الفراعنة، وإن كانوا يعيشون الآن تحت حكم أمراء مسيحيين. وهم لهذا يضطرون إلى مغادرة البلاد التي عاش فيها آباؤهم من أقدم العهود التي يذكرها الإنسان. وإذ كان يسرنا ألا يلحقهم أذى، فإنا نأمركم أن تعاملوهم معاملة ودية رقيقة؛ فإذا وصل إلى علمكم نبأ اعتداء ظالم وقع عليهم، فردوا عنهم ما لحقهم من أذى، ولا تسمحوا بأن يصيبهم مثل هذا الظلم في المستقبل(137). غير أن هذه الدعوة النبيلة لم تلق إلا أذناً صماء، واضطر جريجوري العاشر في عام 1272 أن يكرر ما جاء فيها من تنديد بقصة قتل أطفال المسيحيين استجابة لبعض الشعائر الدينية اليهودية، وأراد أن يزيد أقواله قوة وتأثيراً فقرر ألا تقبل شهادة مسيحي على يهودي إلا إذا عززها يهودي. وإن ما أصدره البابوات بعد هذا العهد حتى عام 1763 من أوامر مماثلة لهذا الأمر ليشهد بما كانت تمتلئ به قلوب البابوات من شفقة وإنسانية كما تشهد بأن هذا الشر لم تجتث جذوره. ومما يدل على أن البابوات كانوا مخلصين في دعوتهم ما كان يستمتع به اليهود في الدويلات البابوية من طمأنينة إذا قيست حالهم بحال بني دينهم في غير هذه الدويلات، ونجاتهم النسبية من الاضطهاد. ذلك أنهم لم يطردوا قط من روما أو من أفنيون البابوية مثل ما طردوا في أوقات مختلفة من كثير من البلاد؛ وفي ذلك يقول مؤرخ يهودي عالم: "لولا الكنيسة الكاثوليكية لما بقي لليهود وجود في أوربا بعد العصور الوسطى".
وكان اضطهاد اليهود بقوة في أوربا أثناء العصور الوسطى متقطعاً؛ فقد جرى الأباطرة البيزنطيون مائتي عام على خطة العسف التي جرى عليها جستنيان ضد اليهود، وطردهم هرقل من أورشليم عقاباً لهم على ما قدموا للفرس من معونة، وبذل كل ما في وسعه لإبادتهم، وحاول ليو الإسوري Leo the Isaurian أن يفند الإشاعة القائلة بأن اليهودي بقرار أصدره عام 723 يخير فيه اليهود البيزنطيين بين اعتناق الدين المسيحي أو النفي، فمن اليهود من خضع لهذا القرار ومنهم من أحرقوا أنفسهم في معابدهم مفضلين هذا على الخضوع له. وواصل باسيل الأول Basil (867-886) الحملة القاضية بإرغام اليهود على التعميد، وطالب قسطنطين السابع (912-959) اليهود بأن يقسموا أمام المحاكم المسيحية ويميناً مذلة ظلت باقية في أوربا حتى القرن التاسع عشر.
ولما دعا البابا إربان Urban الثاني إلى الحرب الصليبية الأولى في عام 1095 ظن بعض المسيحيين أنه يحسن بهم أن يقتلوا يهود أوربا قبل أن يخرجوا لقتال الأتراك في أورشليم، فلما قبل جدفري البويلوني Gosfrey of Bouillon قيادة الحملة أعلن أنه سيثأر لدماء المسيح من اليهود ولن يترك واحداً منهم حياً، وجهر رفاقه بعزمهم على أن يقتلوا كل من لا يعتنق المسيحية من اليهود. وقام أحد الرهبان يثير حماسة المسيحيين أكثر من هذا فأعلن أن نقشاً على الضريح المقدس في أورشليم يجعل تنصير جميع اليهود فريضة أخلاقية على جميع المسيحيين(142). وكانت خطة الصليبيين أن يزحفوا جنوباً بمحاذاة نهر الرين حيث توجد أغنى مواطن اليهود في أوربا الشمالية. وكان يهود ألمانيا قد اضطلعوا بدور رئيسي في إنماء تجارة نهر الرين وانتهجوا خطة حميدة من الصلاح وضبط النفس أكسبتهم احترام المسيحيين عامتهم ورجال دينهم على السواء. وكان الأسقف رودجر الأسبيري R(diger of Speyer ذات صلة وثيقة بيهود أبرشيته، وقطع لهم عهداً يضمن لهم استقلالهم وسلامتهم، وأصدر الإمبراطور هنري الرابع في عام 1095 عهداً مماثلاً لهذا العهد لجميع اليهود المقيمين في مملكته ، لذلك وقعت أنباء الحرب الصليبية، والطريق الذي قررت إتباعه، وتهديدات زعائمها، وقع الصاعقة على تلك الجماعات اليهودية الآمنة المسالمة، فتملكهم الرعب حتى شل تفكيرهم، ودعا أحبارهم إلى الصوم والصلاة عدة أيام.
ولما وصل الصليبيون إلى أسبير جروا أحد عشر يهودياً إلى إحدى الكنائس وأمروهم أن يقبلوا التعميد، فلما أبوا قتلوهم عن آخرها (3 مايو سنة 1096)، ولجأ غيرهم من يهود المدينة إلى الأسقف جوهنسن Johannsen، فلم يكتف هذا الأسقف بحمايتهم، بل أمر بقتل عدد من الصليبيين الذي اشتركوا في مقتله الكنيسة. ولما اقترب بعض الصليبيين من تريير Trier استغاث من فيها من اليهود بالأسقف إجلبرت Egilbert، فعرض عليهم أن يحميهم على شريطة أن يعمدوا، ورضى معظم اليهود بهذا الشرط، ولكن بعض النساء قتلن أطفالهن وألقين بأنفسهن في نهر الموزل Moselle (أول يونية سنة 1096). وفي مينز خبأ روتارد Ruthard كبير الأساقفة 1300 يهودي في سراديبه، ولكن الصليبيين اقتحموها عليهم وقتلوا منهم 1014، واستطاع الأسقف أن ينقذ عدداً قليلاً منهم بإخفائهم في الكنيسة الكبرى (27 مايو سنة 1096)، وقبل التعميد أربعة من يهود مينز، خبأ المسيحيون اليهود في منازلهم، وأحرق الغوغاء الحي اليهودي، وقتلوا من وقع في أيديهم من اليهود القلائل، فما كان من الأسقف هرمان Hermann إلا أن نقل اليهود سراً من مخابئهم عند المسيحيين إلى منازل المسيحيين في الريف وعرض بذلك حياته هو لأشد الأخطار. وكشف الحجاج الصليبيون هذه الحيلة، وصادوا فريستهم في القرى وقتلوا كل من عثروا عليه من اليهود (يونية سنة 1096) وكان عدد من قتلوا في إحدى القرى مائتي يهودي؛ وحاصر الغوغاء اليهود في أربع قرى أخرى، فقتل اليهود بعضهم بعضاً، مفضلين هذا على التعميد، وذبحت الأمهات من ولدن من الأطفال في أثناء هذه الاعتداءات وقت مولدهم. وفي وورمز أخذ الأسقف ألبرانشز Alebranches من استطاع أن يأخذهم من اليهود إلى قصره وأنقذ حياتهم، أما من لم يستطع أخذهم فقد هاجمهم الصليبيون هجوماً خالياً من كل رحمة. فقتلوا الكثيرين منهم، ثم نهبوا بيوت اليهود وأحرقوها، وفيها انتحر كثيرون من اليهود مفضلين الموت على ترك دينهم. ثم حاصرت جماعة من الغوغاء مسكن الأسقف بعد سبعة أيام، وأبلغ الأسقف اليهود أنه لم يعد في وسعه أن يصد أولئك الغوغاء، وأشار عليهم بقبول التعميد، وطلب إليه اليهود أن يتركوا وشأنهم لحظة قصيرة، فلما عاد السقف وجدهم جميعاً إلا قليلاً منهم قد قتل بعضهم بعضاً، ثم اقتحم المحاصرون الدار وقتلوا الباقين أحياء، وبلغ مجموع من قتل في مذبحة وورمز (20 أغسطس سنة 1096) نحو ثمانمائة من اليهود. وحدثت مذابح مثلها في متز Metz ورنجزبرج Regensburg وبراهة Prague(144).
وأنذرت الحرب الصليبية الثانية بأنها ستفوق الحرب الأولى من هذه الناحية، فق أشار بطرس المبجل Peter The Venerabie، القديس رئيس دير كلوني Cluny على لويس السابع ملك فرنسا أن يبدأ بمهاجمة اليهود الفرنسيين، وقال له: "لست أطالبك بأن تقتل أولئك الخلائق الملاعين... لأن الله لا يريد محوهم من الوجود، ولكنهم يجب أن يقاسوا أشد ألوان العذاب كما قاساه قائين قاتل أخيه، ثم يبقوا ليلاقوا هواناً أقسى من العذاب، وعيشاً أمر من الموت".
واحتج سوجر Suger رئيس دير سانت دنيس St. Denis على هذا الفهم الخاطئ للمسيحية، واكتفى لويس التاسع، بفرض ضرائب باهظة على أغنياء اليهود؛ غير أن اليهود الألمان لم يخرجوا من هذه المحن بالمصادرة وحدها، فقد خرج راهب فرنسي يدعى رودلف من ديره بغير إذن، وأخذ يدعو إلى ذبح اليهود في ألمانيا. وفي كولوني قُتل شمعون "التقي" وبترت أطرافه، وفي أسبير عذبت امرأة على العذراء لكي يقنعوها باعتناق المسيحية. وبذل الرؤساء الدينيون مرة أخرى كل ما في وسعهم لحماية اليهود، فأعطاهم الأسقف آرناند أسقف كولوني قصراً حصيناً يجتمعون فيه وأجاز لهم أن يتسلحوا؛ وامتنع الصليبيون عن مهاجمة الحصن، ولكنهم قتلوا كل من في أيديهم من اليهود الذين لم يعتنقوا المسيحية. وأدخل هنري كبير أساقفة مينز في بيته يهودا كان الغوغاء يطاردونهم، ولكن الغوغاء اقتحموا البيت وقتلوهم أمام عينيه. واستغاث كبير الأساقفة بالقديس برنارد St. Bernard أعظم المسيحيين سلطاناً في أيامه، وأجاب برنارد بأن ندد برودلف تنديداً شديداً وطلب أن يوضع حد لأعمال العنف الموجهة إلى اليهود. ولما واصل رودلف حملته عليهم جاء برنارد بنفسه إلى ألمانيا وأرغم الراهب على العودة إلى الدير. ولما أن جدت جثة أحد المسيحيين بعد ذلك بقليل مشوهة في ورزبرج Wurzburg؛ اتهم المسيحيون اليهود بأنهم هم الفاعلون، وهاجموهم رغم احتجاج الأسقف أمبيكو Embicho وقتلوا عشرين منهم، وعني المسيحيون بكثيرين غيرهم أصابتهم جروح في هذا العدوان منهم (1147)، ودفن الأسقف القتلى في حديقته. وعادت إلى فرنسا فكرة بدء الحرب الصليبية في بلاد المسيحيين قبل انتقالها إلى الشرق، وذبح اليهود في كارنتان Carentan، ورامرو Rameru، وسلي Sully. وفي بوهيميا ذبح الصليبيون 150 يهودياً، ولما أن انتهت موجة الذعر بذل رجال الدين المسيحيون المحليون كل ما في وسعهم لمساعدة من يقوا أحياء من اليهود، وأجيز لمن قبلوا التعميد مرغمين أن يعودوا إلى الدين اليهودي، دون أن توقع عليها عقوبات الردة القاسية(147).
وكانت هذه المذابح إيذاناً بسلسلة من الهجمات الطويلة العنيفة لا تزال باقية إلى هذه الأيام. من ذلك أن حادثة قتل وقعت في بادن Baden عام 1235 ولم يعرف مرتكبها اتهم بها اليهود، فأدى ذلك إلى مذبحة منهم؛ وفي عام 1243 حرق جميع اليهود سكان بلتز Beltz القريبة من برلين وأهم أحياء بحجة أن بعضهم قد دنسوا خبزاً للتقدمة مقدساً. وفي عام 1283 أثيرت في مينز فكرة ذبح أطفال المسيحيين في بعض الشعائر اليهودية، وقتل عشرة من اليهود ونهبت البيوت اليهودية على الرغم مما بذله ورنر كبير الأساقفة من جهود. وفي عام 1285 أهاجت مثل هذه الشائعة أهل ميونخ Munich، ولجأ 180 يهودياً إلى كنيس لهم، فأشعل فيه الغوغاء النار، واحترق المائة والثمانون بأجمعهم. وبعد عام من ذلك الوقت قتل أربعون يهودياً في أبرويزل Oberwesel بحجة أنهم امتصوا دماء مسيحي، وفي عام 1298 حرق كل يهودي في روتنجن Rottingen حتى قضى نحبه بحجة أن بعضهم قد دنس الخبز المقدس. ونظم رندفلشخ Rindfleisch وهو بارون متمسك بدينه جماعة من المسيحيين الذين أقسموا أن يقتلوا جميع اليهود وأمدهم بالسلاح، وأبادوا جميع الجالية اليهودية في ورزبرج، وذبحوا 698 يهودياً في نورمبرج Nuremerg، ثم انتشرت موجة الاضطهاد فلم يمض إلا نصف عام حتى محي 140 كنيساً يهودياً. وملأ اليأس بعد هذه الاعتداءات المتكررة يهود قلوب ألمانيا، وكانوا قد أعادوا تنظيم جماعاتهم مراراً وتكراراً، فغادرت أسر يهودية كثيرة مينز، وورمز، وأسبير، وغيرها من المدن الألمانية وهاجرت إلى فلسطين لتعيش في بلاد المسلمين. وإذا كانت بولندة ولتوانيا تطلبان الهجرة إليها، ولم تكن قد حدثت فيهما مذابح حتى ذلك الوقت، فقد بدأت هجرة بطيئة من يهود بلاد الرين إلى بلاد القالبة في شرقي أوربا.
وأضحى اليهود في إنجلترا تجاراً ورجال مال بعد أن حرم عليهم تملك الأرض والانضمام إلى نقابات الصناع. ومنهم من أثروا من الربا وأصبحوا على بكرة أبيهم موضع الكراهية لأكله. وقد استعان الأشراف ملاك الأرض وأتباعهم على التسلح للحروب الصليبية بالمال المقترض من اليهود، ورهنوا لهم في نظير هذا المال ريع أرضيهم، واستشاط الزارع المسيحي غيظاً لرؤيته المرابين يثرون من كدحه. وحدث في عام 1144 أن وجد الشاب وليم من أهل نروخ Norwich قتيلاً، واتهم اليهود بمقتله لاستعمال دمه، وهوجم الحي اليهودي في المدينة ونهب وأحرق(150). وحمى الملك هنري الثاني اليهود، وحذا حذوه هنري الثالث، ولكنه جمع منهم 422.000 جنيه ضرائب وقروضاً أخرى على رؤوس أموالهم في سبع سنين. وحدثت في الاحتفال بتتويج رتشرد الأول في إنجلترا (1190) مشاحنة تافهة شجعها الأشراف الذين يريدون أن يتخلصوا مما عليهم من ديون لليهود(151)، فتطورت إلى مذبحة امتدت إلى لنكولن Lincoin، واستامفورد Stamford، ولن Linn. وقتل الغوغاء 350 منهم في مدينة يورك في العام نفسه وكان يقودهم رتشرد دي ملابستيا Richard de Malabestia، وكان مستغرقاً في الدين لليهود. ثم قام مائة وخمسون من يهود يورك يتزعمهم الحبر توم طوب Tom Tob بقتل أنفسهم(153). وفي عام 1211 غادر ثلاثمائة من أحبار اليهود إنجلترا وفرنسا ليبدءوا حياة جديدة في فلسطين، وبعد سبع سنين من ذلك العام هاجر كثيرون من اليهود حين نفذ هنري الثالث أمر الشارة اليهودية. وفي عام 1255 راجت شائعة في أنحاء لنكولن تقول إن غلاماً يدعى هيو Hugh قد أغرى بدخول الحي اليهودي، ثم جلد، وصلب، وطعن بحربة، بحضور جمع من اليهود المبتهجين. وعلى أثر هذه الشائعة هاجمت عصابات مسلحة مقر اليهود، وقبضت على الكوهن الذي قيل إنه كان على رأس الاحتفال، وشدوه إلى ذيل جواد، وجروه في الشوارع، ثم شنقوه. ثم قبض على واحد وتسعين يهودياً وشنق منهم ثمانية عشر، ونجا كثير من المسجونين بفضل تدخل جماعة من الرهبان الدمنيكيين البواسل . وأفلتت الجماهير من أيدي ولاة الأمور في أثناء الحرب الأهلية التي نشرت الاضطراب في إنجلترا بين عامي 1257، 1267، وكادت المذابح أن تمحو من الوجود يهود لندن، وكنتربري Canterbury، ونورثمبتن Northampton، وونشستر Winchtester، وورسستر Woecester، ولنكولن، وكيمبردج، فنهبت بيوتهم ودمرت، وأحرقت العقود، والسفاتج، وأصبح من بقوا أحياء من اليهود لا يملكون شروى نقير. وكان ملوك الإنجليز وقتئذ يقرضون المال من أصحاب المصارف المسيحيين في فلورنس وكاهورس Cahors، وأصبحوا في غير حاجة إلى اليهود، ومن ثم وجدوا أن من الصعب عليهم حمايتهم. ولهذا أمر إدوارد الأول من كان باقياً في إنجلترا من اليهود وكانوا حوالي 16000 يهودي أن يغادروا البلاد قبل أول نوفمبر من ذلك العام، وأن يتركوا وراءهم جميع أملاكهم الثابتة وما يمكن استرداده من الديون. وعرق الكثيرون منهم في القناة الإنجليزية التي أرادوا أن يعبروها في قوارب صغيرة، وسرق ملاحو السفن متاعهم وأموالهم، فلما وصل بعضهم إلى فرنسا أبلغتهم الحكومة الفرنسية أن عليهم أن يغادروا البلاد قبل بداية الصوم الكبير من عام 1291.
وفي فرنسا أيضاً تبدلت الحالة النفسية بالنسبة لليهود حين قامت الحروب الدينية على الأتراك في آسية، والملاحدة الألبجنسين Albigensian في النجويدك Languedoc. فقام الأساقفة يلقون الخطب الدينية المثيرة للنفوس، وكان من الشعائر المعتادة في بزيير أيام أسبوع الآلام أن يهاجم الغوغاء الحي اليهودي، وأخيراً دعا أحد رجال الدين المسيحيين في عام 1160 بالكف عن هذه المواعظ الدينية، ولكنه طلب إلى الجالية اليهودية أن تؤدي ضريبة خاصة في أحد السعف من كل عام. وفي طلوشة (طولوز) أرغم اليهود على أن يبعثوا بممثل لهم إلى الكنيسة في يوم الجمعة الحزينة من كل عام ليتلقى صفعة على أذنه لتكون بمثابة تذكرة لهم خفيفة بخطيئتهم الأبدية. وفي عام 1171 أحرق عدد من اليهود في بلوا Blois بحجة استخدامهم دماً مسيحياً في شعائر عيد الفصح اليهودي(159). ورأى الملك فيليب أغسطس الفرصة سانحة ليبتز منهم المال محتجاً بالدين، فأمر بأن يسجن جميع من في مملكته من اليهود لأنهم يسممون آبار المسيحيين(160)، ثم أمر بالإطلاق سراحهم بعد أن افتدوا أنفسهم بمال كثير 1180 ، غير أنه طردهم من البلاد بعد عام واحد، وصادر جميع أملاكهم الثابتة، وأهدى معابدهم للمسيحيين. وفي عام 1190 أمر بقتل ثمانين يهودياً في أورنج Orange لأن ولاة الأمور في المدينة شنقوا أحد عماله لقتله أحد اليهود ، ثم استدعى اليهود إلى فرنسا في عام 1198 ونظم أعمالهم المصرفية تنظيماً يضمن به لنفسه أرباحاً طائلة. وفي عام 1236 دخل الصليبيون المسيحيون الأحياء اليهودية في أنجو Anjou وبواتو Poitou-وبخاصة ما كان منها في بوردو Bordeaux وأنجوليم Angoul(me-وأمروا بأن يعمد اليهود جميعاً، فلما أبوا داسوا بحوافر خيولهم ثلاثة آلاف منهم حتى قضوا نحبهم. وندد البابا جريجوري التاسع بهذه المذبحة، ولكنه لم ينج اليهود من الموت. وأشار القديس لويس على رعاياه بألا يجادلوا اليهود في أمور الدين، وقال لجوانفيل Joinville إن من واجب كل شخص من غير رجال الدين: "إذا سمع إنساناً يذكر الدين المسيحي بما لا يليق أن يدافع عنه بالسيف لا باللفظ، ينفذه في بطن الآخر إلى أبعد مدى ينفذ فيه. وفي عام 1254 نفى اليهود من فرنسا، وصادر أملاكهم ومعابدهم، ثم عاد فسمح بدخولهم إياها، ورد إليهم معابدهم، وبينما كانوا يعيدون بناء جماعاتهم إذ أمر فيليب الجميل Philip the Fair (1306) بسجنهم، وصادر ما كان لهم من ديون، وجميع ما كان لهم من متاع لم يستثن إلا ما كان عليهم من الثياب، ثم طردهم جميعاً من فرنسا وكانوا يبلغون مائة ألف، ولم يسمح لهم بأكثر مما يكفيهم من الطعام يوماً واحداً. وقد بلغ ربح الملك من عمله هذا قدراً أغراه بأن يهدي معبداً يهودياً إلى سائق عربته.
وهكذا تجمعت طائفة متقاربة من الحوادث الدموية دامت نحو مائتي عام تكونت منها صورة ذات وجه واحد. ولم يقع على اليهود في برفانس Provence، وإيطاليا، وصقلية، والإمبراطورية البيزنطية بعد القرن التاسع إلا حوادث اضطهاد صغرى، واستطاعوا وقاية أنفسهم مها بالالتجاء إلى أسبانيا المسيحية، وكانت فترات الطمأنينة حتى في إنجلترا، وألمانيا، وفرنسا طويلة، وكان اليهود يكثرون مرة أخرى ويثري بعضهم بعد كل مأساة تنزل بهم. غير أن قصصهم كانت تنقل إليها ما كان لهذه الفترات المحزنة من ذكريات مُرة، وكانت أيام السلام مليئة بخوفهم من خطر المذابح الذي لا ينفك يهددهم، وكان على كل يهودي أن يحفظ عن ظهر قلب الدعاء الواجب عليه أن يتلوه في ساعة الاستشهاد.
أنظر أيضا
وصلات خارجية
- Biblical History The Jewish History Resource Center - Project of the Dinur Center for Research in Jewish History, The Hebrew University of Jerusalem
- Catholic Encyclopedia: Jerusalem (Before A.D. 71)
- Holy land Maps