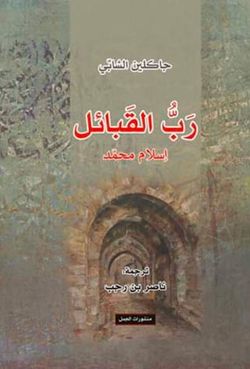رب القبائل، إسلام محمد
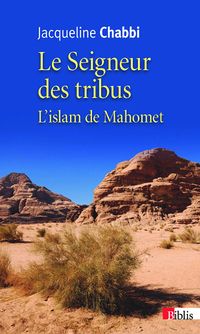 | |
| المؤلف | جاكلين شابي |
|---|---|
| المترجم | ناصر بن رجب |
| البلد | |
| اللغة | الفرنسية |
| الصنف الأدبي | تاريخ الإسلام، النبي محمد |
| الناشر | نويزيس |
| ناشر الترجمة العربية | منشورات الجمل |
| الإصدار | 1997 |
| تاريخ الترجمة | 2020 |
| عدد الصفحات | 725 |
| ISBN | 2911606132 |
كتاب رب القبائل، إسلام محمد (فرنسية: Le Seigneur Des Tribus. L'islam De Mahomet)، هو كتاب للمؤرخة الفرنسية وأستاذة الدراسات العربية في جامعة پاريس 8 جاكلين شابي، نشر عن دار نويزس للنشر عام 1997. يتحدث الكتاب حول تاريخ الإسلام ويتناول سيرة النبي محمد، وتركز المؤلفة على السياق الأنثروپولوجي والتاريخي للإسلام.[1] صدرت الترجمة العربية للكتاب عن دار الجمل في يوليو 2020.
تعيد شابي دراسة بدايات تشكل الحدث القرآني، و"إسلام محمد" - وهو العنوان الفرعي الذي حذفه الناشر العربي من غلاف الكتاب - ضمن الملابسات التاريخية والسياسية والجغرافية والقبائلية لذلك العصر. ومما جاء في الغلاف الخلفي للكتاب : "تحاول جاكلين شابي الإجابة عن هذه الأسئلة: كيف كانت بداية الإسلام؟ كيف ظهر القرآن؟ في أي عالم؟ وإلى من توَجّه في البداية؟".
عن الكتاب
الكتاب مكون من ثلاثة متون مستقلة عن بعض، يمتد المتن الأول، الأساسي، على مساحة أربع مائة صفحة، ويمتد الثاني على طول ثلاثة مائة صفحة، مكونة في معظمها من الهوامش (حوالي سبعة مائة إحالة، أي بمعدل إحالة في كل صفحة) وإضافة إلى صغر حجم حروف طباعة الهوامش، مثلها في ذلك مثل المتن الأخير الذي سنتكلم عنه بعد قليل، تجب الإشارة إلى أن الهامش الواحد قد يمتد على طول صفحتين أو أكثر (أنظر، على سبيل المثال، الهامش رقم 673). أما المثن الثالث والأخير فهو عبارة على مجموعة من الإضافات مبثوثة في ثنايا المتن الأول وتخترقه، وقد يصل طول من هذه الإضافات إلى أربعة أو خمسة صفحات. يمكن أن يستغنى عن قراءتها دون أن تؤثر على فهمنا للمتن الأساسي. منا يمكن أن نقرأها على حدة دون أن نعدم اكتساب الفائدة المقصودة.[2]
ولربما حكى تصدع الكتابة هذا تصدع موضوعات النص القرآني الذي تجتهد المؤلفة في تتبع كيفية انشغاله. والأكيد أنها علامة مميزة لأكاديمية الكتاب الذي كان قد قدم أصلا، سنة 1992، كأطروحة لنيل شهادة دكتوراة الدولة من جامعة پاريس 4، قسم الدراسات الإسلامية. ومن ثمة فميزة عمل هذا القبيل لا تلبث أن تلاحظ. زيادة على أن المؤلفة تبثنا، في الصفحة 278 وفي الصفحة 618 وكذا في الهامش رقم 645، خبرا مفاده أن الكتاب جزء أول من مجموعة أعمال مقبلة تتخذ لها اسماً واحداً هو العنوان الأساسي للكتاب قيد الدرس: "رب القبائل".
وعلى ذكر هذا الخبر، ونظراً لأهمية العنوان، وجب الوقوف عنده في هذه التوطئة، لا يمكن فهم دلالة الكتاب إلا إذا بلغنا الصفحة 373، وعندها نكون على مشارف خلاصة الكتاب (16 صفحة بالضبط هي ما يفصلنا عنها) وتوقفنا عند الإحالة رقم 645 عندها فقط نفاجأ بأن "رب القبائل" هي أكثر من تسمية. إنها الترجمة التي تقترحها المؤلفة لترجمة "رب العالمين"، وحجتها في ذلك أن الترجمة الشائعة: "لايمكنها أن تعني شيئا في مجتمع قبائلي يفتقد كل وسيلة في تمثل "عوالم" مخالفة لعالمه".
باستطاعتنا المجازفة بالقول أن تسمية الكتاب، نقصد ترجمته، تعتبر خلاصة مركزة للمنهجية التي اتبعتها الشابي، ولربما تكون إستراتيجية إرجاء شرح مصدر التسمية هي ما يشفع للخطأ المنهجي والبيداغوجي الموجب بالبدإ برفع الالتباس، كما تقتضي ذلك أدبيات البحث الأكاديمي. لا علينا "العالم" القبائلي في اعتقاد المؤلفة يحيل على القبيلة وليس في وسعه أن يعدو هذا الأفق. في هذا الأفق، وحده اللاحق في الزمن، باعتباره إعلان عن انتهاء السابق وموته الفعلي، هو المؤهل لرسم تقاطيع الزمن: "وحده المستقبل، تقول المؤلفة، هو الذي يصنع أحداث الماضي" (ص 264).
هناك "قاعدة عامة" (ص 271) تحكم هذا التصور: الكل محكوم بشرطه الاجتماعي، ولا أحد "يتعالى" (ص 390) عليه، ومن ثمة، فاللغة، كما الأفراد، تعكس بيئتها، والتفكير على هذا المنوال يمد المؤلفة بالقوة على الاعتقاد في قدرية (أي جبرية) "تعاقبية الزمن" (256). تعاقبية هي من الإحكام بحيث لا أحد يخرج على روح عصره، تماما كما ليس في وسع أحد أن يقفز فوق ظله. بهذا يكون الكتاب قد قدم كل مقومات منهجه، أي كل الأدوات التي يتوسلها لتحقيق مشروعه. إلا أننا قبل مساءلة هذه العناصر، سنعرج لعرض المشروع كما رسمته الشابي.
في التنبيه الذي يفتتح به الكتاب، تعرف الشابي بغايتها على أنها "محاولة لوع الإسلام الأصلي في السياق التاريخي داخل المجتمع الذي عاش فيه محمد "(22). كما تعود للتذكير بهذا الهدف في آخر الكتاب قائلة: "كان موضوع هذا الكتاب هو محاولة اقتراح نظرة للأشياء أكثر احتمالا من وجهتي النظر الاجتماعية والتاريخية" (392). لماذا "الإسلام الأصلي"، الإسلام الأول؟ وكيف تم وضعه في سياقه التاريخي والإجتماعي؟ ولماذا التاريخ وعلم الاجتماع؟ بهذه الأسئلة نفتتح مناقشتنا لأطروحة المؤلفة.
تندرج مساءلة إسلام البدايات في إطار تحديد العلاقة التي تطرحها المجتمعات والأفراد. وبهذا يدخل سؤال الهوية هذا تحت السؤال العام: "كيف يتم الإهتداء الى ماض معين" ؟ (94، 117). إلا أن هناك علة ثانية في طرح سؤال الإسلام الأول. يعتبر الإسلام أكثر الديانات السماوية أهلية (انظر ص 93) للإجابة على تساؤلات المؤرخين المتعلقة بكيفية ولوج المقدس التاريخ وعلاقات الديانات به. وذلك لحداثة عهده من جهة، ولوفرة الشواهد المؤرخة له من جهة ثانية. وفي كلا الحالتين ينضوي الإسلام داخل اهتمامات المؤرخ، تماما مثلما دخلت روما لنفس الاعتبارات في اهتمام فيكو، مؤسس المدرسة التاريخية في العصور الحديثة، في دراسته لتاريخ الحضارات ما قبل الحديثة.
التاريخ، بهذا المعنى، هو اسم للمؤسسة القيمة على التحقيق في علاقة الناس، في حاضر معين، بماضيهم: الإسلام والمسلمين في الحالة قيد الدرس. والعلم المشار إليه هو "علم من أجل العلم" (91) وليس تخصصا داخل الفروع العلمية الجامعية. وبهذا فهو علم غير مسبوق، إنه بدعة ومنتوج العالم المعاصر. "والقاعدة الاولى، ومن دون شك، القاعدة الأساسية " لهذا العلم النمودجي في "الصرامة التي تفرها علوم الإنسان" (2). تكمن في "الامتناع عن معالجة وقائع الحكي كما لو أنها وقائع فعلية قبل تحديد إمكان وجودها في سياق معين" (2). هكذا تتحدد مهمة المؤرخ، سواء كان خريج قسم الإسلاميات، كما هو الشأن بالنسبة للشابي، أو اللسانيات، أو غيرها، على أنها رصد الممكن اجتماعيا وتاريخيا. لا غرابة في ذلك ما دام التاريخ في هذا التصور، كما بدا لنا منذ إثارة مشكل الترجمة في مقدم حديثنا، متطور، صاعد، ينتج اللاحق فيه عن السابق، معلنا بلوغه منتهاه أي استنفاده لإمكانياته. عندها يسهل فصل ما ينتمي لعهد أو جيل عن ما ينتمي لعهد أو جيل آخر.
الفصل بين الفعلي وبين الممكن من الوقائع هو إحداث شرخ في جسم الواقع وإصدار حكم قبلي يلزم التثبت منه إذا التزمنا قاعدة "الحذر (181) التي تلح علها المؤلفة داخل هذه القسمة "لا يعود في وسع ما يقوله القرآن أن يمدنا بأكثر من وقائع محكية" مع العلم، أن الحكي ليس سوى الأثر الباقي لوقائع معيشة فعلا" (233). لنلاحظ أن هذا الحكم هو تهميش للقول على الفعل وتفضيل للثاني على الأول. لا لشيئ إلا لمصادرة يعد المكتوب بمقتضاه دون المعاين (325) في هذا السياق يجب فهم أهمية الوثيقة، الشاهدة كما يسميها الأستاذ عبد الله العروي، باعتبارها تقوم مقام الشاهد المعاين للحدث ولا تغني عنه، هكذا يصير المكتوب، وعماده اللغة، وسيلة نقل بين السابق / الشاهد واللاحق / الغائب. و بالتالي فمنزلتها منزلة الوسيط. إلا أن ما يهمنا إبرازه في هذا التمييز بين النص والفعل في ما يتعلق بالقرآن. ليس هو فقط تحييده للجانب الاعتقادي الذي لا يدخل ضمن نطاق عمل المؤرخ، بل المهم المصادرة المخلة بحق النص / المكتوب المحال من طرف المؤلفة على الدوران في فلك وهم فعل خالص أي غير مشوب بفعل الزمن: اللغة.
إذا، وعلى خلاف ما هي عليه بالنسبة لرجل الدين، الذي تعترف المؤلفة أن "ليس عندها شيئ تقوله له" (22)، فالأحداث القرآنية، بالنسبة للمؤرخ، ليست موضع اعتقاد وتسليم. النص القرآني، في هذا المنظور، لا يعدو أن يكون وثيقة تاريخية" يلزم إخضاع معطياتها "لمعايير جديدة" (47)، معايير مستقاة من الأنتربولوجيا التاريخية المعاصرة" (20) لننبه إلى أن تصنيف القرآن على أنه وثيقة تاريخية" لا يمكن فهمه إلا داخل القسمة المؤسسة لعمل المؤرخ والمميزة لمنزلة الوثيقة / العيان / الحضور. و إلا سنرمي المؤلفة بالتناقض عندما نقرأ قولها : "لا يشكل القرآن بأي معنى كتاب تاريخ". (181).
يتم تبرير اختيار دراسة فترة إسلام محمد على الشكل التالي: "لقد تم اختيار هذه الفترة بالذات "لفهم عمق الفارق وأهمية القطيعة بين العهد القبائلي "لإسلام محمد" والمجتمعات التي أسلمت فيما بعد " (21-22) الدعوى بالغة الأهمية وتستلزم الكثير من التؤدة. لذا نعيد صياغة السؤال حتى نتبين مسعى الأستاذة الشابي: عن أي فارق تتكلم؟ وعلى أي مستوى ترصد هذه القطيعة؟ يبدو جليا تقول المؤلفة، أن هناك بين القرآن – الموحى به للعهد النبوي وبين القرآن – في صيغته الرائجة لأزمنة المسلمين التالية، ما يمكن تسميته بالقطيعة على مستوى التمثل، قطيعة لا تسمح أن يكون هناك بين الإسلام الأول والإسلام اللاحق استمرارية تاريخية. ومع ذلك، فهذا الانفصال يعاش من طرف المسلمين كفترة زمنية لا تشي بوجود أية هوة بين حاضرهم وماضيهم. لا يخفى أن موقفا جماعيا بهذا الشكل هو من قبيل الإديولوجيا" (77).
على أي أساس تبني دعوى الانقطاع في الذاكرة الإسلامية؟ ما الذي سمح لها أن تخلص إلى هذا الذي خلصت إليه؟ إن الاستمرارية التامة، تقول الشابي التي ينطلق منها التقليد الإسلامي الوسيط في مسعاه لجعل حاضره مطابقا لماضيه من جهة، ولجعل هذا الماضي واضحا كل الوضوح من جهة أخرى، لهي استمرارية مبالغ في تجميلها بحيث تصعب مطابقتها للواقع التاريخي. وهذا لا يمكن أن يلتبس على النظر النقدي للمؤرخ" (19).
نعترف أن الإجابة جد مربكة لأنها تبقى في حدود الدعوى التي تخول المؤرخ مشروعية غير مؤسسة، مشروعية مبنية على دعوى امتلاك حدس "روح الزمن" (340) في كل فترة من الفترات، يمتلك معيارا ميتافيزيقيا بين ما هو "طبيعي" أي الممكن تاريخيا، وبين ما لايمكن، باعتباره "أبلغ من أن تسمح به طبيعة" (337) مرحلة ما. وكلها مسبقات لا تجد ما يشفع لها سوى اعتبارها من كلاميات التاريخ.
إن دعوى الانحراف، وهو ما يقتضيه المستوى الإديولوجي الذي ترد إليه الشابي علاقة المسلمين بالإسلام الأول، عن الحقيقة، التي تنطلق منها المؤلفة ما دامت تعتقد في "واقع تاريخي فعلي" (3-1)، تلتقي مباشرة وتصب في اتجاه الدعوة السلفية التي تعتقد جازمة في إمكان تخليص النص القرآني وحفظه من كل ما يمكن أن يشوبه، أي من فعل الزمن فيه، الزمن الفاصل بين الحاضر – الماضي لعهد النبوة (=السلف الصالح) والحاضر – المستقبل المرج تحقيق إعادة تجربة التأسيس فيه. وكما لا يخطر ببال السلفي أن يخرج عن أدبيات علم الكلام ويتساءل عن حظوظ نجاح إمكان القفز على التاريخ، فالمؤرخ، سجين خطية التاريخ وبيولوجية تطوره، لا يقوى على اكتناه الماهية الجدلية للفعل التاريخي.
لنترك كلاميات الكلام هذه ولنسائل الدراسة قيد البحث: ماذا يبقى من هذه الذاكرة إذا ترك جانبا هذا التقليد الإسلامي الممتد على أكثر من 15 قرنا، والذي تعتبره الشابي "عائقا تجب معرفته" من أجل "مجاوزته" (394)؟ الذي يمكن مطيته للوصول إلى الفترات الأكثر قدما" لهذه الذاكرة (394)؟.
هذا نقف على حلقة ضائعة في تحليل الشابي: إذا كانت المؤلفة توجب مجاوزة التاريخ الإسلامي، باعتباره تاريخا مقدسا لمبتدئه، بنصوصه التي تحول دون (90-91) إفضاء النص القرآني بحقيقته (= تاريخيته)، فإنها تعترف في نفس الآن بأن النص القرآني "كتاب صعب القراءة دون واسطة علم أو تقليد" (63). ومن ثمن فاستبدال علم بعلم، علم الآوائل (= التقليد) بعلم المحدثين (=العلم) هي في آخر المطاف "إحالة على ذواتنا" (181) عندها يصير التاريخ الإسلامي حقل تجارب لأنواع نظرية أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها تؤرخ لذاتها أكثر ما تؤرخ لموضوعاتها. كيف يتم الخروج من هذا العراء الذي يجد المؤرخ فيه نفسه؟ إذا كان ديكارت، في حالة مشابهة في لا تاريخيتها لعمل الشابي، قد التجأ، بعد عملية مسح الطاولة الشهيرة، إلى "أنا" مفرغ من تاريخيته، وكان هوسرل قد اعتصم بعد الكارثة المفترض أن تكون قد أتت على كل ما يربطه بالعالم الخارجي، ب "ذات" غير ذات سمك تاريخي، فإن الشابي تجد نفسها في معية اللغة، في معية الكلمات. إلا أننا وقفنا في مقدم هذه المقالة على تهميش المؤلفة للغة والكتابة لنمني النفس مع ذلك بحصول مفاجأة ما.
تذكر المؤلفة بأن عاملين اثنين يعترضان الباحث في قضايا القرآن ووسطه: هناك من جهة التفاسير والسير وكل ما كتب حول حياة محمد (91)، وهي سهلة الإزاحة، باعتبار أنها تقريبا" (122) "قابلة للتحديد والتعريف" وهناك عائق ثاني، عائق يتعلق بالأفكار والحديث عنه يستلزم "ضرورة"، "العود أولا لقيمة الكلمات" وذلك "بقياس التحولات التي طالتها في طريقها من المجتمع القبلي الى مجتمعات خلفاء المسلمين". لا غرابة في أن يتحول المؤرخ في هذا المستوى الى فيلولوجي، خصوصا إذا علمنا أن القرن التاسع عشر الذي ازدهرت فيه الفيلولوجيا هو الذي تعقدت فيه المدرسة التاريخية. يصير المؤرخ إذا متعقبا "لكلمات اللغة القديمة" (124) وتتحول الكلمات إلى عيون (جواسيس) تشي بما زال (بمعنيي الكلمة: المحو والإبقاء) في النص القرآني من العهود السالفة، بالتأكيد، وعلى خلاف الفقيه اللغوي، فالمؤرخ يرصد الكلمات في علاقتها "بأساسها الذهني والمجتمعي" (125).
هنا يجب التنبيه إلى أن هذا التماهي، وفي هذا المستوى بين المؤرخ والفيلولوجي، وبعد إحداث انفصام جذري" (93) بين عهد الإسلام الأول وعهد ورثته، تتأسس القطيعة على استمرارية عميقة يندرج القرآن بموجبها في عالم نجمله بأنه عالم اللغة القديمة، عالم الإنجيل (139 وأيضا 313) المسألة واضحة من جهة نظر المؤرخ ولا تحتاج إلى كبير جهد لفهمها. إذا كان النص القرآني قد جاء مخاطبا أهله في لغة هم محددوها، فإن "مساءلة مصير كلمات زمان" (103) كاف لإثبات الانفصام والقطيعة في الذاكرة الإسلامية، من جهة وإثبات الاستمرارية في التاريخ من جهة أخرى.
وحتى نفهم كيف أن اختيار البحث هو أكثر من مجموعة تداعيات حول أصول هذه الكلمة أو تلك، تنبه المؤلفة إلى "أن الحياة هي المعنية في كل تحويل دلالي" (393) يتم رصده. وتختصر الشابي عمل التنقيب هذا قائلة: "يتم التنقيب في مسألة معينة انطلاقا من كلمة بسيطة، كلمة لا تعطي الإنطباع بأنها مشتركة الاستعمال إلا لتشي بوجود اختلاف تام في معاني الأشياء" المحال عليها (284).
بقي أن نشير أخيرا إلى أن هذه التحولات التي تطال المعاني، والتي تشكل أمل المؤلفة في فصل ما وصله المسلمون من شأن ذاكرتهم، هي تحولات قصرية و لا أحد يستطيع الانفلات منها. فالقرآن لا يجرم لتغيره للمعاني التي ورثها، والمسلمون لم يجرموا في قراءتهم المخالفة والمقدسة، على حد قول المؤلفة، لما لم يكنه القرآن في تصور المؤرخ (394). وأي موقف غير هذا الذي وقفه الإسلام تجاه سالف الزمن قبله أو الذي وقفه المسلمون تجاه الماضي الذي أصبح يشكله الإسلام الأول بالنسبة إليهم، أي موقف غير هذا كان يقتضي الانفصال عن الذات والابتعاد عنها "وهو ما كان مستحيلا كل الاستحالة" (394). إلا ان اللغة هي السيدة في هذا المنظور. وهو ما يتنافى مع منزلتها الهامشية التي حددتها لها المؤلفة كما رأينا سلفا. إن هذا التنافر بين ما تتغياه الشابي، التأريخ التاريخي للإسلام، وما يلفت منها من حدوسات لهي أحد علامات غنى الكتاب قيد البحث.
ونعتقد أن تصدع منهجية الكتاب هذه قد تسللت عبر بعض القناعات، الشابي تتحدث عن "يقينيات"، التي لم تهز بما فيه الكفاية. ونعتقد أن تصور المؤلفة لحقيقة العمل التاريخي تأتي على رأس القائمة. "لأن هذه البديهيات المزعومة، يقول إرنست تريلتش صاحب العمل الشهير حول "المدرسة التاريخية ومشاكلها" 1922، تخفي المشاكل الفعلية الأساسية التي تستلزم من افكر التاريخي إعادة مناقشتها باستمرار" (انظر تمهيده لدراسته عن الدعوة البروتستانية والمعاصرة 1911) لننظر مثلا إلى كيفية تفضيل الشابي للتاريخ باعتباره لا يتغيي أية منفعة: "في إعادة تشييده لعالم الناس الأخرين (...) لا يترقب المؤرخ أية مردودية شخصية. وهو بذلك موقى ضد غواية الأسطورة" (21-22). الأسطورة هنا اسم جامع لجنس أنواع القداسة الممكن إضفاؤها على النص المدروس. والمؤرخ يستمد علمه غير الأسطوري هذا من تصور خالص للعلم !علم من أجل العلم! وهنا، تحديدا تتضح دعوى حدود استيعاب درس علوم الإنسان المؤسسة، منذ ماركس ونتشه على الأقل، على الترابط الماهوي بين إرادة المعرفة وإرادة القوة.
وبالإضافة إلى أن الشابي لن تطرح البثة تعريفا إيجابيا للتاريخ، فإن العيب الأساسي في دراستها لإسلام البدايات، لاتكمن، كما قد يبدو لبادئ الرأي، حتى وإن كان عضوا في أكاديمية المملكة المغربية، كما وقع أثناء تقديمنا لهذا الكتاب في معهد العالم العربي بباريس، في غمزها في مقدس ما، بقدر ما يكمن في عدم تسلحها بما يكفي من الحذر والأنة لمقاربة المعطى الديني، لتضرب مثلا على ذلك. تقول الشابي: "إن التاريخ لا يعرف عن الله سوى ما يقوله عنه الناس" (389). وكأني بالشابي تعتقد، في نفيها وبنفيها، في وجود ممكن لاينوء به كلام الناس فقط، بل ولا يسع احتماله أيضا، تماما كما لو أن الحديث عن الأموات يبقي لهؤلاء إمكانية كلام غير إمكانية الأحياء / الأموات التي كانوها قبل فاصل القبر أو عبر الأموات/ الإحياء الذين يشكلون امتدادا لهم في الزمن. والأكثر من ذلك أن الشابي تتوهم لأنها بتعريفها هذا تفلت من ربقة اللاهوت! لنذكرها بما يقوله رجال الدين على لسان بولتمان منذ عشرينات هذا القرن: "(...) واضح إذا أردنا أن نتحدث عن الله لزم ضرورة أن نتحدث عن أنفسنا" معشر بني الإنسان (أنظر دراسته: ماذا يعني أن نتحدث عن الله، كما يمكن الإستئناس بدراسة غدامير، 1975 عن معنى مساءلة الموت).
هكذا ينضاف إلى القصور النظري ضيق في المقاربة التاريخية كما تمارسها الشابي والتي تبدأ بنفي "إمكان الحوار إلا مع ذاتها". وعندها تنقلب المقاربة التاريخية إلى مونولوج تجعله الأستاذة عمق العمل العلمي ككل: "التاريخ، مثله مثل كل تخصص علمي اليوم، لا يحاور إلا نفسه" (22)، إن تصور المؤلفة للتاريخ كعلم، وللعلم على أنه العلم الديكارتي المشترط لإقامة تقابل ميتافيزيقي بين الدارس وموضوع دراسته، والذي جردت باسمه جاك بيرك من فهم المقاربة التاريخية (378)، تصور لم يستفد من صرامة العلوم الإنسانية. رغم أن بيرك وهو يعطي "الإنطباع السيء بأنه لا يكلم إلا نفسه" (378)، مفروض أنه بذلك يجيب على شرط العلم كما يفترضه تصور الشابي.
نعتقد أن الشابي قد أخطأت موضوعها ووقعت في ما يمكن تسميته بالإنزلاق الفينومينولوجي، عندما بدأت بجعل ما يتعلق بالدين حكرا على رجل الدين الذي لن يقبل، بحكم الهيمنة الطبيعية لسلطته، بالقسمة والتي لن يفتأ يعتقد بأنها قسمة ضيزي. رغم أن درسا من دروس الفكر المعاصر (اسبينوزا في قراءته لرسالة القديس بولس، حوار دافوس بين هايدغر وكاسرر...) كان حريا أن يلزمه بمسؤولية منطقية بمجرد ما يخرج عن صمته. عندها يقارب المعطى الديني على أنه "ظاهرة"، بالمعنى الفينومينولوجي، لا تمتنع عن الإفضاء بحقيقتها، أي بقائها عصية عن التسمية، بقدر ما هي تتوارى عند تسليط الأضواء عليها، متخذة بذلك، على شاكلة الفوتون في الفيزياء الكوانطية، التواري على أنه شكل حضورها.
نختم بالقول بأن الشابي وهذا ما أغوانا بمحاورتها في هذه المقالة، قد اقتربت من هذه الحقيقة سواء عندما رصدت معنى الغيب على أنه حضور فاقع (124)، أو عندما وضعت أصبعها على كون حياة المعتقدات تتجلى في "تحولات معناها" (271)، إلا أن كل هذا قد أقبر في تصور فج لحقيقة العلم من جهة، والتاريخ الذي لم يساءل من جهة أخرى، من هنا ضرورة إعادة النظر في تقابل الغياب / الحضور واجتراح مفاهيم تسمح بإعطاء أزمنة التأسيس فرص المقاربة.
المصادر
- ^ "قريبًا.. النسخة العربية لـ«رب القبائل» عن منشورات الجمل". جريدة الدستور. 2018-03-06. Retrieved 2020-07-15.
- ^ "التاريخ حضوره وغيابه: قراءة في "رب القبائل: إسلام محمد"". ترجمان الفلاسفة. 2016-11-27. Retrieved 2020-07-15.