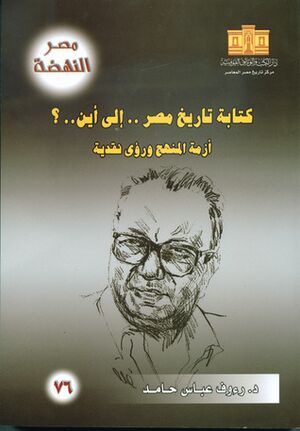تاريخ مصر إلى أين ..؟ أزمة المنهج ورؤى نقدية
كتاب كتابة تاريخ مصر إلى أين ..؟ أزمة المنهج ورؤى نقدية
كتاب عبارةعن مجموعة من المقالات، والأوراق البحثية، ومقدمات لكتب ترجمها د. رءوف جمعها بعد وفاته طالبه د. ناصر أحمد إبراهيم عام 2009
إقتباسات
--أن مصر مجتمع بناه المصريون فى عملية تاريخية استغرقت ما يزيد على ستين قرنا من الزمان، مجتمع جاء نتاجا لتفاعل الإنسان مع البيئة الطبيعية وتطويعه لها.وعبر تلك القرون البعيدة، كانت الز ا رعة نشاطه الإقتصادى الرئيسى، ومن خلال العلاقة الجدلية بين الإنسان والأرضرسمت خطوط المجتمع المصرى وتشابكت وتحدد نظامه السياسى وفكره: ثقافة وتقاليد
--وظيفة التاريخ، فهو يتتبع عملية التطور فى المجتمع، فيرصدالتغيرات الكمية فى البنية الإقتصادية وما يترتب عليها من تغيرات كيفية يكون لها تأثيرها على البنية الإجتماعية، وما يفرزه هذا التغير من آثار على البنية السياسية وعلى الأفكار.
--ستطيع المؤرخ بما له من خبرة بتطور المجتمع، ورؤية لآليات ذلك التطور من منظور تاريخى، أن يتعرف على القسمات المشتركة بين الماضى والحاضر، وأن يشخص أمراض الحاضر على ضوء ما عاناه المجتمع فى خبرته التاريخية، وبذلك يساهم بصورة فعالة فى المساعدة على حل المشكلات الراهنة
-- لا نعجب عندما نجد المسلمين وقد تقوقعوا حول أنفسهم، يجترون ذكريات عصور الإزدهار الحضارى الإسلامى لعجزهم عن محاكاتها. وعندما يفقد الناس الحافز على التقدم، وينظرون إلى الخلف
لا إلى الأمام، يفتح الباب على مص ا رعيه أمام النع ا رت الطائفية والعصبية والص ا رعات المذهبية، مما يضعف من تماسك المجتمع ويحوله إلى خلايا مبعثرة تقوم على أسس عصبية أو مذهبية أو حتى عرقية، وهى ظاهرة لها ما يبررها فى ضوء تفشى النظام الإقطاعى فى الدولة العثمانية
-- إن تأخر النضج القومى العربى وضعف الحركة العربية عائق كبير فى التوصل إلى مشروع نهضوى عربى، لا يستطيع العرب أن يجتازوا أزمة التخلف الحضارى بدونه
تأثر الكتابات المحدودة فى تاريخ العصر العثمانى بما شاع فى كتابات المدرسة الإستشراقية
تأثرت الكتابات المحدودة فى تاريخ العصر العثمانى بما شاع فى كتابات المدرسة الإستشراقية من نعوت لصقت بالمجتمع العربى عامة والمصرى خاصة فى العصر العثمانى هى: الجمود، والركود، والإضمحلال، والتخلف. وهى تعميمات ضربت صفحا عن التباين الواضح بين المجتمعات التى خضعت
للحكم العثمانى وبعضها البعض من حيث الظروف الموضوعية بنية وتكوينا وتجربة، وتعاملت معها فىسياق واحد، ولم تميز إلا قليلا بين ظروف الأناضول والولايات العربية، ولم تهتم بإب ا رز التمايز بين الولايات العربية وبعضها البعض. كما أن تلك الد ا رسات إستقت معلوماتها من مصادر ثانوية مخطوطةوتقارير الرحالة والقناصل الأجانب، وكلها مصادر تهتم بالسطح ولا تغوص إلى اللباب، وأغفلوا المصادر الأولية الوثائقية إغفالا يكاد يكون تاما. أضف إلى ذلك أن معظم المعلومات التى إستند إليها المستشرقون ترجع إلى القرن الثامن عشر فتغاضوا بذلك عن إختلاف الأحوال من قرن إلى آخر، وسحبوا إستنتاجاتهم الخاصة بالقرن الثامن عشر على العصر العثمانى كله بعد ما إفترضوا بداية أن المجتمع العربى راكدا جامدا مضمحلا. ولكن المؤرخين المصريين ظلوا يعانون القلق من هذه النظرة العامة، المشكوك فى موضوعيتها، إلى العصر العثمانى. وبدأ بعض الأساتذة الرواد يوجهون أنظار تلاميذهم إلى أهمية د ا رسة العصر العثمانى،
فعل ذلك محمد شفيق غربال على نطاق محدود، فقد جرفه وتلاميذه تيار “الحداثة”، ولكن تلميذه أحمدعزت عبد الكريم كان أكثر إهتماما بضرورة إعادة النظر فى العصر العثمانى من خلال د ا رسات تاريخية جادة تعتمد على المصادر الوثائقية: سجلات المحاكم الشرعية، وحجج الأوقاف، وسجلات الروزنامه، وغيرها. فوجه بعض تلاميذه منذ الستينات لإعداد بحوثهم للماجستير والدكتوراه عن موضوعات تتصل بتاريخ مصر فى العصر العثمانى، فكانت درتسات عبد الرحيم عبد الرحمن، وليلى عبد اللطيف، وغيرهما
من الباحثين التى كشفت عن أبعاد جديدة للعصر العثمانى جعلت جيلا آخر من الباحثين يشق طريقهفى هذا المجال إما بتوجيه من أساتذتهم أو بدوافع ذاتية. وقد ألقت د ا رساتهم التى لم ينشر معظمها حتى -
الآن أضواء جديدة على العصر العثمانى، جعلتنا نشعر بالحاجة إلى إعادة إكتشافه، بل واعادة النظر -فى فكرة “الحداثة”، وأقنعتنا بالحاجة إلى البحث عن العوامل الذاتية الكامنة فى المجتمع والتى تدفع حركته التاريخية.
تأثر الكاتب بكتب د نللي حنا
وتعد الزميلة د. نللى حنا من أقطاب المتخصصين فى تاريخ مصر فى العصر العثمانى، وتحظى بشهرةبين الأوساط الأكاديمية الدولية لأن معظم بحوثها نشرت بالإنجليزية والفرنسية، وجاءت الطبعة العربية من كتابها "بيوت القاهرة فى القرنين السابع عشر والثامن عشر، دراسة إجتماعية معمارية" )العربى للنشر والتوزيع 1993 إضافة هامة لد ا رسة تاريخ مصر فى العصر العثمانى، إحتفت بها الأوساط الثقافية، وحظيت بتقدير المتخصصين، ورغم ثقافتها الغربية، تتمتع نللى حنا برؤية ناقدة ثاقبة للمفاهيم التى تروج فى كتابات المدرسة الإستش ا رقية حول الثقافة الإسلامية، والمجتمعات العربية عامة، فتحرص على دحض تلك المفاهيم إستنادا إلى ما تتوصل إليه من نتائج من خلال د ا رسة المصادر الوثائقية التى خبرت العملعليها سنين طوال، فإذا أضفنا إلى تلك الخبرة والرؤية المنهجية ما تمتاز به نللى حنا من حس وطنى وغيرة على الثقافة الوطنية، أدركنا أهمية ما تطرحه من آ ا رء وما تتركه من صدى فى الأوساط الأكاديمية
الدولية. ومن هنا جاء إهتمامى بكتابها “إسماعيل أبو طاقية شاهبندر التجار” الذى يسعدنى تقديمه إلى جمهور
المثقفين والمهتمين بد ا رسة تاريخ مصر الحديث، وقد كتبته نللى حنا بالإنجليزية لينشر من خلال قسم
النشر بجامعة سي ا ركيوز بالولايات المتحدة الأمريكية. وأطلعتنى المؤلفة على أصول الكتاب عام 1995
أنفقت المؤلفة فى دراسته عشر سنوات كاملة، قامت خلالها بتمشيط الوثائق التاريخية لتعيد تكوين صورة المجتمع المصرىعند أواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر، من خلال سيرة إسماعيل أبو طاقية شاهبندرالتجار، لا يجب أن يظل بعيدا عن متناول ق ا رء العربية
مؤكدة أن المجتمعات يمكن أن تتطور وفق سياق تاريخى مختلف عن النهج الغربى، كاشفة عن فساد الإستنتاجات التى توصل إليها المستشرقون فى د ا رساتهم حول العصر العثمانى عامة وتطورمصر فى ذلك العصر خاصة، مؤكدة أن الثقافة الوطنية العربية الإسلامية توفرت لديها فى هذا العصر مقومات التطور، وأن قدوم الغرب لم يكن بعثا للحياة فى مجتمعاتها، وانما كان من معوقات تطورها.
ويدحض الكتاب الآ ا رء التى ذهبت إلى أن مصر وبلاد الدولة العثمانية عانت من الركود الإقتصادى والجمود الحضارى والإضمحلال الثقافى من خلال تقديم صورة حية للواقع الإقتصادى فى أواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر، أعادت المؤلفة تكوينها من شتات المعلومات التى جمعتها من سجلات المحكمة الشرعية، بينت فيها عدم صحة المقولات التى أشاعها المستشرقون حول أثر تحول التجارة إلى طريق أ رس الرجاء الصالح على الركود الإقتصادى وكساد أسواق الشرق الأوسط، وما شاع عن دور الدولة فى الإقتصاد، والعلاقة بين السلطة والناس، ودور أ رس المال التجارى فى تطور الإقتصاد والتنمية الإجتماعية والعم ا رنية، وبينت الدور الذى لعبه أ رس المال التجارى فى الإنتاج الزراعى والصناعى فى تلك الفترة، وهو دور لا يقل وزنا أو أث ا ر عن الدور الذى لعبه أ رس المال التجارى فى اوروبا فى ذلك العصر، والقراءة الدقيقة لهذا الكتاب تجعل القارئ يتساءل مع المؤلفة عن العوامل التى حالت دون حدوث تحول راسمالى فى العالم العثمانى عامة والعربى خاصة خلال ذلك العصر، وهو تساؤل لا يمكن التوصل إلى إجابة شافية له إلا بعد د ا رسة بقية الفترة الزمنية بنفس العمق والدقة اللذين نجدهما فى هذا الكتاب، وهو عمل يحتاج إلى تضافر جهود مجموعة من الباحثين فى إطار مشروع
بحثى كبير يغطى المجتمع المصرى فى القرنين السابع عشر والثامن عشر إستنادا إلى المصادرالوثائقية، ترعاه إحدى الهيئات العلمية الوطنية، أو بعض أقسام التاريخ فى الجامعات المصرية
ولاشك أن التحولات التى تمت على يد محمد على باشا لم تنشأ من فراغ، وخاصة أنه لم يعتمد على راس المال الأجنبى فى إقامة البنية الأساسية لإقتصاد السوق الخاضع لإدارة الدولة، وانما إعتمد على موارد مصر وحدها طوال حكمه، وحقق الت ا ركم الأولى اللازم لإقامة تلك البنية من خلال إعادة تنظيم الإقتصاد المصرى وتوجيه بعض قطاعاته وجهات جديدة، فمن أين إستطاع الإقتصاد المصرى فى مطلع القرن التاسع عشر أن يوفر كل تلك الموارد إذا كان إقتصادا تقليديا ا ركدا؟ وكيف إستطاع المجتمع المصرى أن يتجاوب مع إصلاحات محمد على إذا كان مجتمعا يعانى من الإضمحلال والتخلف؟ بل كيف إستطاع العامل المصرى أن يستوعب الأساليب الفنية الحديثة فى مصانع محمد على إذا كان عطلا من الخبرة،
مفتقرا إلى الإستعداد؟ وأخيرا، كيف إستطاع الفتية المصريون الذين تعلموا فى ظل نظام التعليم التقليدى فى العصر العثمانى أن يتجاوبوا مع التعليم الحديث، بل ويتابعوا الد ا رسة فى المعاهد الفرنسية، إذا كان النظام التعليمى الأساسى الذى أخرجهم متخلفا عاجزا؟ وكيف إستطاع الفلاح المصرى أن يستوعب فنونالقتال الحديثة، ويشكل قوام جيش فرض سيطرة مُ حمد عل ى على الشرق الأوسط، إذا كان ذلك الفلاح لا يملك الإستعداد والقدرات اللازمة لذلك؟
كلها تساؤلات تحتاج إلى إجابات شافية تدعمها الدراسة الدقيقة للواقع المصرى عند ظه ور محمد على، فما فعله محمد على كان بمثابة إعادة ترتيب ما توفر لديه من أوراق، أى إعادة تنظيم البنية الأساسية فى مصر بالإستفادة من مكوناتها الأصلية. حقا، لجأ محمد على إلى الخبرة الأجنبية فإستعان بالفرنسيين وغيرهم فى شتى المجالات، ولكن ذلك كان على نطاق محدود، وظلت اليد العليا فى حركة الإصلاح التى أدخلها محمد على لعناصر عثمانية )تركية( أو مصرية، وجاء نسق الإصلاح مختلفا عن النمط الغربى، ملبيا للظروف الموضوعية للمجتمع المصرى التى تضرب بجذورها فى أعماق تاريخ مصر عبر العصر العثمانى. ولو كان المجتمع المصرى تقليديا ا ركدا مضمحلا
لما كان بمقدور محمد على أن يصنع المعجزات، فيحدث التقليدى، ويحرك ال ا ركد، ويستنهض المضمحل، وخاصة أنه كان شرقيا عثمانيا ينتمى إلى نفس الثقافة بما لها وما عليها. وما تحقق على يد محمد على لم ينشأ من ف ا رغ، وانما إعتمد على الأساس ال ا رسخ للتجربة التاريخية المصرية. ويعنى ذلك أن واقع مصر فى العصر العثمانى كان له شأن آخر غير ذلك الذى شاع فى كتابات مدرسة “الحداثة’”، اوستطاعت نللى حنا فى هذه الد ا رسة أن تثير الشكوك حول مصداقيته. ولا ريب أن دراسة المجتمع المصرى فى العصر العثمانى، أو إعادة إكتشاف الواقع المصرى فى ذلك العصر، كفيلة بإلقاء المزيد من الضوء على تطور مصر الحديثة، فقد آن الأوان لإعادة تقييم تجربة القرن التاسع عشر على ضوء ما قد تتوصل إليه دراسة العصر العثمانى من نتائج، من أجل فهم تاريخنا القومى فهما يستند إلى حركة ذلك التاريخ